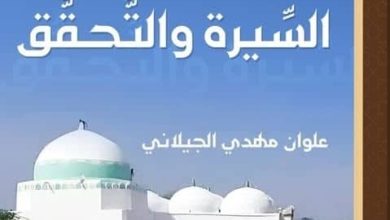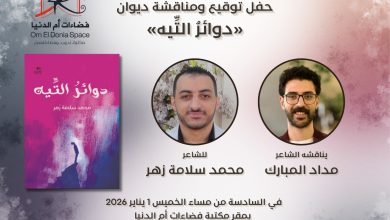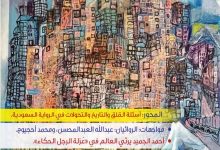السيمياء والهيرمينوطيقا: بين أنساق العلامة وأفق التأويل في الشعر والأدب:
بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.

يظلّ الأدب في جوهره فعلاً مزدوجاً: فعل كتابة وفعل قراءة. فالكتابة تنتج نصاً مشبعاً بالعلامات والرموز، بينما القراءة تسعى إلى كشف هذه العلامات عبر عملية تأويلية لا تنتهي. وهنا تتداخل مقاربتان أساسيتان لفهم النص: السيمياء التي تدرس أنساق العلامات والرموز وكيفية اشتغالها، والهيرمينوطيقا التي تعنى بفعل التأويل وفهم المعنى الكامن وراء الظاهر اللغوي. إنّ الجمع بين هذين المنهجين لا يكشف فقط عن عمق الشعر والأدب، بل يمنحنا مفاتيح لفهم الوجود الإنساني من خلال النصوص.
–أولاً: السيمياء والشعر – العلامة كجسد للمعنى:
يرى فرديناند دو سوسير أنّ اللغة نظام من العلامات يقوم على علاقة اعتباطية بين الدال والمدلول. ومن هنا نشأت السيميائيات بوصفها علماً يدرس كيفية إنتاج المعنى عبر العلامات. في الشعر، تتخذ العلامة بُعداً مضاعفاً، فهي لا تقتصر على دلالتها المباشرة، بل تنفتح على فضاء رمزي متشعب. إنّ صورة “النخلة” عند بدر شاكر السياب في أنشودة المطر، مثلاً، لا تُقرأ بوصفها نباتاً، بل كرمز للخصب والانبعاث والحياة، فيما تتحوّل “الأرض الخراب” عند ت. س. إليوت إلى رمز كوني لانهيار الحضارة.
_السيمياء في الشعر إذن ليست مجرد أداة لوصف الرموز، بل وسيلة للكشف عن البنية العميقة للنصوص. وهنا يبرز دور رولان بارت الذي رأى أن النص الشعري فضاء تتصارع فيه العلامات وتتولّد باستمرار معانٍ جديدة عبر التعددية الدلالية. لقد فتح بارت الطريق أمام القراءة التي تنظر إلى النص بوصفه “نسيجاً من العلامات” لا ينضب.
–ثانياً: السيمياء والأدب – العلامة كفضاء ثقافي:
لا يقتصر دور السيمياء على الشعر، بل يمتد إلى الأدب بأشكاله كافة. فالرواية، مثلاً، شبكة من العلامات الثقافية والاجتماعية التي تعكس ذهنية عصرها. وقد نبّه ميخائيل باختين إلى أنّ الرواية حوارية بطبيعتها، فهي تضمّ أصواتاً متعددة تتجسد عبر العلامات اللغوية والثقافية. وفي الأدب العربي نجد مثالاً في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، حيث تتحول العلامات (الأسماء، الأمكنة، الأزياء) إلى شفرات دلالية تترجم الصراع بين الشرق والغرب، وبين الهوية والاغتراب.
السيمياء هنا تكشف أنّ النص الأدبي ليس مجرد كلام، بل “نسق ثقافي” كما أشار كلود ليفي شتراوس في تحليله للأساطير، حيث تصبح العلامة أداة لفهم البنى العميقة للثقافة.
–ثالثاً: الهيرمينوطيقا والشعر – أفق التأويل:
لكن العلامة لا تكتمل بدون التأويل. وهنا يأتي دور الهيرمينوطيقا التي تطورت من تفسير النصوص المقدسة عند شلايرماخر، إلى فلسفة الفهم عند دلتاي، وصولاً إلى مشروع غادامر في كتابه “الحقيقة والمنهج”، حيث اعتبر الفهم حواراً بين النص والقارئ، بين الماضي والحاضر.
في الشعر تحديداً، يحتاج النص إلى تأويل مستمر لأنه لا يقدّم معناه دفعة واحدة. فقصيدة “جدارية” لمحمود درويش مثلاً ليست مجرد بوح ذاتي أمام الموت، بل فضاء للتأمل في الوجود والحياة والذاكرة، وهو ما يفتحها على تعددية قراءات هيرمينوطيقية: تأويل فلسفي وجودي، وتأويل سياسي ووطني، وتأويل جمالي صرف.
الهيرمينوطيقا هنا تمنح الشعر بعده اللامحدود: فالمعنى ليس ثابتاً، بل يتشكل في كل قراءة، كما أكّد بول ريكور في حديثه عن “الذات المؤولة” التي لا تفهم النص إلا وهي تفهم نفسها معه.
_ رابعاً: الهيرمينوطيقا والأدب – النص كفضاء للفهم الإنساني:
الأدب عامةً هو سجل لتجارب إنسانية معقدة لا تُختزل في معاني جاهزة. من هنا تأتي أهمية الهيرمينوطيقا في جعله نصاً مفتوحاً على التأويل المستمر. لقد رأى غادامر أنّ النصوص العظيمة لا تُستنفد لأنها تدخل في “أفق اندماج” مع كل قارئ جديد. وهذا ما نجده مثلاً في “ألف ليلة وليلة”، التي ظلّت تُقرأ على مستويات مختلفة: حكاية للتسلية، ومخزن رمزي للثقافة الشرقية، وموضوعاً لدراسات ما بعد كولونيالية.
الهيرمينوطيقا تعلّمنا أنّ النص ليس شيئاً مغلقاً، بل حدثٌ حيّ يُعاد إنتاجه في كل قراءة. وبذلك يصبح الأدب أكثر من مجرد متعة جمالية: إنه وسيلة لفهم الذات والعالم.
— خامساً: تكامل السيمياء والهيرمينوطيقا – العلامة والتأويل:
_ بين السيمياء والهيرمينوطيقا جدلية لا يمكن الفصل بينها: الأولى تكشف عن أنساق العلامات وكيفية عملها، والثانية تفتح أفقاً لتأويل هذه العلامات وربطها بالوجود الإنساني. إنّ قصيدة رمزية مثل قصائد أدونيس لا يمكن فهمها إلا عبر قراءة مزدوجة: سيميائية تحدد أنساق الصور والرموز (الصحراء، الطوفان، النور)، وهيرمينوطيقية تؤول هذه العلامات بوصفها استعارات لرحلة الإنسان نحو الحرية والمعنى.
— خاتمة:
يتضح من هذا التلاقي أنّ السيمياء والهيرمينوطيقا ليستا مجرد أدوات نقدية، بل هما مساران يكمل أحدهما الآخر: السيمياء تمنحنا الوعي بالبنية والعلامة، والهيرمينوطيقا تمنحنا الوعي بالمعنى والتأويل. والشعر، بفضل طبيعته الرمزية الكثيفة، يظل المجال الأرحب لتجريب هذا التكامل. إنّ قراءة قصيدة أو نص روائي في ضوء هذين الأفقين تكشف أنّ الأدب ليس انعكاساً للواقع فقط، بل هو فضاء لإعادة تشكيل المعنى والوجود. وكما قال هيدغر: “اللغة بيت الوجود”، فإن السيمياء ترينا مفاتيح هذا البيت، بينما الهيرمينوطيقا تجعلنا نسكنه بوعي.