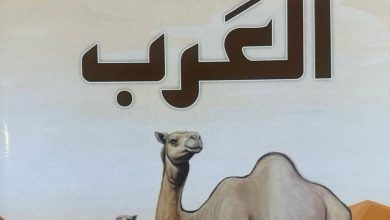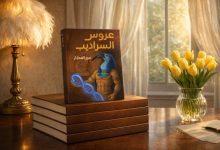عبد الهادي شلا يكتب: يوم مغاير
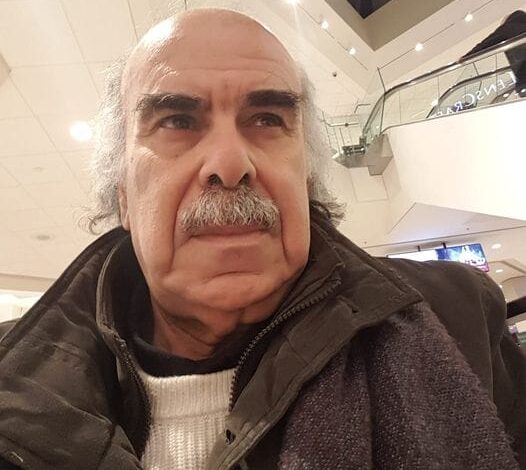
بإمكانك أن تطلب قهوتك الصباحية و تختار افطارك اليومي من الكرواساه الفرنسي أو كيك انجليزي بالكريمة أو فلافل وفول.
بإمكانك ان تجلس في الشرفة تتأمل الطبيعة و تَشكُل الغيوم في السماء.
و بإمكانك ان تُلقي نظرة طويلة على صفحتك في الفيسبوك أو الاستغرام وحين تَمِل و تَضجر … بإمكانك ان تجلس في الصالة الكبيرة على الأريكة المريحة تتنقل بين الفضائيات الكثيرة جدا و تتابع أخبار الفنانين، والمهرجانات وفي العدد القليل من القنوات التي تنقل أخبار المجازر والتدمير وصور الشهداء الأبرياء من المدنيين في غزة..
بإمكانك ان تُشعل سيجارتك الكوبيةالفاخرة و تتنهد مُتعاطفا مع صورة طفل مولود للتّو يحمله رجل إسعاف وسط دخان القنابل الفسفورية.
بإمكانك ان تذهب لمسيرة تشجب العدوان وقد تحمل يافطة أو صورة شهيد.
كل ما يمكن أن تقوم به لا يعادل رجفة قلب أم لم تحتضن أطفالها قبل أن يُدمَّر عليهم بيتهم.
لا تعادل دمعة أب تَحجَّرت في مآقيه و ينادي على من تَبقى حيا تحت الأرض ولا مجيب.
لا تعادل يومك الكئيب الذي بدأته تقليديا ولم ينتهي ..!!!