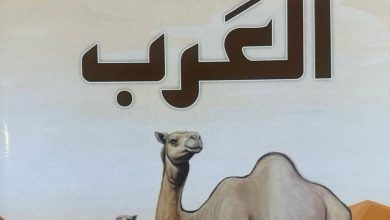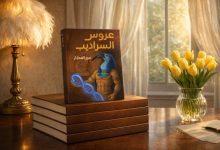د. ربيع عبد العزيز يكتب علوم العرب من الشفهية إلى الرقمنة

انتقلت إلينا العلوم العربية عبر ثلاث مراحل رئيسة: أولى تلك المراحل هي مرحلة الرواية الشفاهية؛ التي تضرب بجذورها في العصر الجاهلي، وتمتد إلى منتصف القرن الثاني الهجري، حين انتصر التدوين والنسخ، وحلا محلها.
وللشفاهية ظروف عديدة اقتضتها وساعدت على التمكين لها؛ منها قوة ذاكرة أوائل العرب، واستشراء الأمية في الكثرة الكاثرة منهم، وندرة مواد الكتابة. ومع أهمية الدور الذي أسهمت به الشفاهية، في نقل علوم العرب، من جيل إلى جيل، إلا أنها كانت سببا في ضياع الكثير من تراثنا العربي؛ بحيث لم يصلنا منه إلا أقله، أو على حد تعبير أبي عمرو بن العلاء:(ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير).(1)
ولقد كان التوسل بالرواية الشفاهية، في حفظ أشعار العرب وأنسابهم، عملا فرديا تغذيه- بالدرجة الأولى- عصبية قبلية، وتنقصه روح العلم، ولكن بمرور الوقت تمكنت الرواية الشفاهية من الأخذ بروح العلم؛ بمعنى أنه كان للخبر الأدبي رواة متخصصون، وللخبر الديني رواة متخصصون، وللخبر التاريخي رواة متخصصون؛ فزهير بن أبي سلمى كان راوية شعر ولم يكن نسابة، بل لقد تخصص في رواية أشعار بعينها؛ كأشعار خاله: بشامة بن الغدير، وأشعار زوج أمه: أوس بن حجر. وكان أبو هريرة متخصصا في رواية الحديث النبوي، أما الصديق أبو بكر-رضي الله عنه- فكان متخصصا في علم الأنساب.
وإلى مرحلة الرواية الشفاهية يرجع الفضل في ظهور بواكير المصطلحات النقدية، التي يعد من أقدمها مصطلح الإقواء، وهو عيب إيقاعي ينشأ عن اختلاف حركة روي القصيدة رفعا وخفضا، أو نصبا ورفعا، أو خفضا ونصبا؛ كقول النابغة الذبياني- وهو في يثرب- من قصيدته المتجردة:(2)
أَمِنْ آلِ مَيَّةَ رائـحٌ أو مُغْتَــــدِ…عجلانَ ذا زادٍ وغيرَ مُــزَوَّدِ
زعم البوارحُ أن رحلتنا غدًا…وبذاك خبرنا الغُدَافُ الأسودُ
حيث جاء الروي مرفوعا في كلمة(الأسودُ)، مخفوضا في كلمة(مُــزَوَّدِ)، ولم يفطن النابغة إلى إقوائه، وهابه اليثربيون فجاءوا بأَمَةِ تغنت أمامه بالبيت فأدرك العيب، ثم أصلح حركة الروي فقال: (3)
زعم البوارحُ أن رحلتنا غدًا…وبذاك تنعابُ الغُرابِ الأسودِ
ومن المصطلحات التي تدين للرواية الشفاهية بفضل وجودها، مصطلح الفحولة، وهو مصطلح ألقى الأصمعي بذوره في الحقل النقدي، وأقام على أساسه رسالته: فحولة الشعراء، كما اتخذ ابن سلام الجمحي المصطلح نفسه أساسا لكتابه: طبقات فحول الشعراء.
ويعد مصطلح عبيد الشعر واحدا من المصطلحات النقدية التي ظهرت في مرحلة الرواية الشفاهية، وكان الأصمعي أول من سكه، وأطلقه على من يغربلون قصائدهم
قبل إذاعتها في المحافل؛ من أمثال زهير والحطيئة؛ قال الأصمعي: ” زهير بن أبي سلمى والحطيئة، وأشباههما عبيد الشعر؛ لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين”(4)
كما يدين مصطلح الانتحال بفضل وجوده لمرحلة الرواية الشفاهية، وإليه يلفتنا ابن سلام الجمحي بقوله: (وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثه: حماد الراوية، وكان غير موثوق به، وكان ينحل شعر الرجل غيره، وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعار).(5)
ما يهمنا تأكيده هو أن المصطلحات التي ظهرت في مرحلة الرواية الشفاهية، كانت منطلقا لتأسيس علم المصطلح عند العرب، وهو علم أسهم إسهاما فعالا في ضبط المفاهيم، وأفرز أجيالا متتالية من علماء المصطلح؛ الذين أغنوا المكتبة العربية بمؤلفاتهم؛ كالرماني في كتاب الحدود، والتهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون، والكفوي في كتاب الكليات، والشريف الجرجاني في كتاب التعريفات.
وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة التدوين. واللحظة الحاسمة في هذه المرحلة هي نسخ القرآن في عهد عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فإن قداسة القرآن أزالت التوجس من التدوين والنسخ، وأضفت عليهما كثيرا من الثقة.
وذائع أن العرب لم تعرف النقط والشكل فيما دونت من العهود والرسائل، فكان من البدهي أن تخلو ألفاظ القرآن الكريم – حال تدوينه بمعرفة كتاب الوحي- من النقط والشكل، ولكن هذا الوضع جعل الالتباس محدقا بالمعاني القرآنية، وجعل الوقوع في الشرك احتمالا قائما ومخيفا؛ فالقاريء الذي يضم الهاء في لفظ الجلالة من قوله تعالى:( إنما يخشى الله من عباده العلماء)، يقع في الشرك غير واع ولا قاصد.
يضاف إلى مخاطر التباس المعاني والوقوع في الشرك بحسن نية، أن ولاة الأمصار كانوا في حاجة إلى نسخ من كتاب الله ليحتكموا إليه فيما يعن لهم من أمور الرعية.
لكل ما سبق كان نسخ القرآن ونقط حروفه وتشكيلها، ضرورة دينية، وكان –في الوقت نفسه- بداية لتحولات كبرى في حياة العلوم العربية. يكفي أن حركة التأليف الخصبة؛ التي دارت حول الإعجاز البلاغي، ما كان لها أن توجد لو لم يُنْسَخْ القرآن، ولم تصل نسخ منه إلى أيدي العلماء.
ومن ثمار نسخ القرآن ظهور طوائف من مهرة الخطاطين؛ كابن مقلة وغيره ممن أحاطوا كتابة المصحف بالتوقير، فتأنقوا في رسم الحروف، وتفننوا في التحبير والتذهيب وانتقاء الأقلام التي يكتبون بها، والأوراق التي يكتبون فيها، بحيث لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن كتابة المصاحف كانت الأساس الذي قامت عليه جماليات الفن الإسلامي، وإليها يرجع الفضل في ظهور مدارس الخط العربي، والتأليف في نشأتها والترجمة لأعلامها.
وبدوره شجع نسخ القرآن على تدوين الحديث النبوي. واللحظة الفارقة في تاريخ تدوين الحديث تبدأ مع البخاري (194هـ:231هـ) الذي اصطنع منهجا بالغ الصرامة في جمع صحاح الأحاديث، وتدوينها، وترتيب موضوعاتها.
وأسفر جمع الحديث وتدوينه عن ظهور مصطلحات حديثية عديدة تقاس بها الأحاديث سندا ومتنا؛ كالصحيح، والضعيف، والمرفوع، والمتصل، والمرسل، والعالي، والموضوع، وغيرها من المصطلحات التي شكلت نواة لعلم مصطلح الحديث.
كذلك أسفر جمع الحديث وتدوينه عن ظهور علم الجرح والتعديل؛ الذي يعد بكل المقاييس مفخرة علمية من مفاخر العرب، كما أسفر عن حركة تأليف باذخة تضم كتب المساند والصحاح والاستدراكات وغيرها من كتب الحديث وعلومه. وهكذا كان نسخ المصحف وتدوين الحديث من أقوى العوامل التي عززت الاتجاه نحو تدوين العلوم العربية.
وبظهور بيت الحكمة في عهد هارون الرشيد(149هـ: 193هـ)، ثم تعاظم شأنه في عهد المأمون) 170هـ::218هـ)، كانت حركة النسخ قد قطعت شوطا طويلا تأكد معه أن التدوين- لا الرواية الشفاهية- هو الذاكرة الأقدر على حفظ العلم وتداوله. وكان لبيت الحكمة أكبر الأثر في إغناء العلم العربي بالمترجمات المنقولة من اليونان وفارس والهند، ومنها كتاب إقليدس المعروف ب(الأصول) الذي ترجمه الحجاج بن يوسف بن مطر(أو مطران) من اليونانية إلى العربية. وذكر بروكلمان أن الحجاج ترجم الأصول مرتين؛ الأولى تعرف بالهاروني، نسبة إلى هارون الرشيد، والأخرى: تعرف بالمأموني، نسبة إلى المأمون، وهي ترجمة مهذبة، وعليها يعول.(6)
ومع أن كل المؤشرات كانت تدل على أن التدوين يكتسب كل يوم أنصارا رفيعي المكانة؛ كالراشديين: أبي بكر وعثمان- رضي الله عنهما- والخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون، والإمام البخاري، إلا أن المدونات الشعرية لم تحظ بثقة المحافظين من نقاد العرب؛ فالأصمعي – وهو أعلم أهل زمانه باللغة والشعر- كان كثير الثقة في الحفظ والرواية الشفاهية للشعر، عديم الثقة فيما كان من الشعر مدونا، كما كان ابن سلام الجمحي يرفض الأشعار التي يتداولها الناس منقولة من الكتب، ويلح على أن أهل العلم بالشعر أجمعوا على ألا يأخذوا من صحيفة ولا يرووا عن صحفي.(7)
والواقع أن رفض المدونات الشعرية من جانب النقاد المحافظين، كان له ما يبرره؛ فالأصمعي أقام بالمدينة المنورة زمانا لم ير فيه قصيدة إلا مصحفة أو مصنوعة(8)، وابن سلام الجمحي لاحظ أن محمد بن إسحق كتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط، فضلا عن أشعار النساء، كما كتب أشعارا منسوبة إلى عاد وثمود(9)؛ غاضا بذلك بصره عن قوله تعالى: (وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى)( النجم، آية 50 :51).
وبرغم هواجس التصحيف والتحريف والانتحال؛ التي اقتضت رفض الشعر المدون من الأصمعي وابن سلام الجمحي، فقد انتصر التدوين في النهاية، بل لقد دُوِّنَتْ مختارات الأصمعي الشعرية المعروفة اصطلاحا باسم الأصمعيات، ودَوَّنَ الفضل بن الحباب الجمحي كتاب ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، وراجت سوق النسخ رواجا كبيرا، وأخذ العلم المدون ينتقل على ظهور الإبل بين الحواضر الإسلامية، لاسيما بعد ظهور حوانيت الوراقة في بغداد ودمشق والقاهرة والقيروان، ونزوع الخلفاء والأمراء إلى تشييد المكتبات في قصورهم، وإلى اقتناء نفائس الكتب والزهو بهذه المقتنيات؛ مما كان له أثر بعيد المدى في انتشار العلم، ومطالعة الأسفار، على نحو غير مسبوق.
وأما ثالث المراحل فكانت مرحلة الطباعة، وهي مرحلة صادفت في بدايتها توجسا دينيا استدعى إصدار فتوى، في عام 1716م، من شيخ الإسلام في استانبول، بإجازة الطباعة.
وطبقا لما ذكره الدكتور إبراهيم السامرائي– في محاضرة له بمركز الشيخ جمعة الماجد، مبثوثة على الشبكة العنكبوتية- فإن هناك زهاء مائة وستة وسبعين كتابا مطبوعا بحروف عربية في مطابع أوربية. وفي عام 1727م طبعت مطبعة إبراهيم الهنغاري، في استانبول، أول طبعة للقرآن الكريم في بلد مسلم، ثم كان أن تتابع ظهور المطبوعات العربية في ديار العرب ومطابعهم.
وبرغم وجود مطابع في لبنان وسوريا والعراق فإن إنشاء مطبعة بولاق (عام 1819م أو 1821م) بأوامر من الوالي محمد علي، مَثَّلَ نقلة نوعية في تاريخ العلم العربي؛ إذ قدمت مطبعة بولاق آلاف الكتب المطبوعة؛ التي جعلت العلم العربي أكثر انتشارا، وجعلت الحصول عليه أقل صعوبة وأكثر يسرا.
ولعل علم التحقيق أحد أبرز العلوم التي أسفرت عنها مرحلة الطباعة، وهو علم أرسى دعائمه المستشرقون؛ الذين يرجع إليهم الفضل في تعليم الطلاب العرب أصول تحقيق النصوص ونشرها، وفي ظهور جيل من أوائل المحققين العرب؛ منهم العلامة محمود شاكر؛ الذي حقق تفسير الطبري وأخرجه مطبوعا في ستة عشر مجلدا، وحقق كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي وأخرجه مطبوعا في ثلاثة مجلدات.
ومنهم المحقق أحمد شاكر؛ الذي حقق مسند أحمد وأخرجه مطبوعا في خمسة عشر جزءا، كما حقق الشعر والشعراء لابن قتيبة وأخرجه مطبوعا في مجلدين.
ومنهم المحقق عبد السلام هارون؛ الذي حقق كتاب خزانة الأدب للبغدادي وأخرجه مطبوعا في ثلاثة عشر مجلدا، وحقق كتاب الحيوان للجاحظ وأخرجه مطبوعا في ثمانية أجزاء، كما حقق الكتاب لسيبويه وأخرجه مطبوعا في خمسة أجزاء.
وأودع أثبات المحققين العرب خبراتهم في مؤلفات تؤصل قواعد علم التحقيق، وتشرح مناهجه في جمع نسخ المخطوطات ومضاهاتها، وتخريج شواهدها، وإعداد فهارسها، وتحديد ما يجوز للمحقق وما يمتنع. وإلى أولئك المحققين الأوائـل يرجـع
أكبر الفضل في إدراج مقرر تحقيق المخطوطات في برامج الدراسات العليا بالعديد من الجامعات العربية.
وفضلا عن دور المحققين في إشاعة علوم العرب وإخراج آلاف المخطوطات إلى النور، فقد أسهم بعضهم في تصوب أخطاء علمية فادحة؛ منها على سبيل المثال أن كتابا يدعى نقد النثر ظهر منسوبا إلى قدامة بن جعفر، ولكن المحقق الدكتور حفني محمد شرف أثبت أن هناك خطأ في عنوان هذا الكتاب ونسبته، وأن الاسم الصحيح لكتاب نقد النثر هو(البرهان في وجوه البيان)، أما مؤلفه الحقيقي فهو أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن وهب الكاتب.
ومن الأحطاء العلمية التي كشفها علم التحقيق أن هناك كتابا منشورا بعنوان الفوائد المشوق، ومنسوبا إلى ابن القيم الجوزية. وفي هذا الكتاب يبدي ابن القيم حفاوة كبيرة بأساليب التعبير المجازي، حفاوة تتناقض تماما مع ما هو ذائع من عدائه للمجاز وحملته على من يعتقد به من علماء الأمة، على نحو ما يظهر في كتابه: الصواعق المرسلة على الدهرية والمعطلة.
وإزاء التناقض بين الحفاوة بالمجاز في كتاب: الفوائد المشوق، ومعاداة المجاز في كتاب: الصواعق المرسلة، تعقب المحقق الدكتور زكريا على سعيد كتاب الفوائد المشوق، وتقصي مادته في مختلف المظان، إلى أن أثبت أنه لا يوجد في تراث ابن القيم كتاب باسم الفوائد المشوق، وأن مادة هذا الكتاب ما هي إلا مقدمة تفسير ابن النقيب. وقد حقق الدكتور زكريا الكتاب وأخرجه مطبوعا في مجلد واحد باسم( مقدمة تفسير ابن النقيب).
الآن يعيش الكتاب العربي مخاضا جديدا يتمثل في الرقمنة، وهي مرحلة لم تتضح معالمها بما فيه الكفاية. وإذا لم يكن ثمة مفر من دخولها فليس ثمة مفر من التهيؤ التقني والعلمي والتشريعي لها.
ولعل من أبرز إيجابيات الرقمنة أنها ستقضي إلى الأبد على تباطؤ حركة الكتاب العربي عبر الحدود، وستجعل الحصول عليـه ميسورا بغض النظر عن البلد الذي طبعه، كما ستجعل القاريء قادرا على متابعة الجديد في عالم التأليف والترجمة والنشر، قادرا على تخزين عشرات الآلاف من الكتب في أقراص ممغنطة، أو على جهاز (u.s.b) بحيث يسهل عليه ملازمة الكتب، وقراءتها، والارتحال بها .
ولكن هذه الإيجابيات تحدق بها مخاطر ليست بالهينة، على رأسها القرصنة الفكرية؛ التي تجعل المتربصين بالثقافة العربية قادرين على أن يدسوا فيها ما ليس منها، وتجعل المغامرين ينتحلون كتبا ليست لهم، مما يعيدنا مرة أخرى إلى قضية الانتحال، ونسبة المؤلفات إلى غير أصحابها الحقيقيين.
ومهما يكن من أمر فإن دخول عصر الرقمنة قدر لا حيلة لنا فيه، ولكننا أمس حاجة إلى تهيئة كوادر علمية تسهم لا في رقمنة علومنا وآدابنا وذخائر تراثنا فحسب، بل في إنتاج تقنيات رقمنة عربية تلائم رقمنة القرآن الكريم والحديث النبوي، وإلا فإن الكيد للثقافة العربية والإسلامية ، وعبث القراصنة ولصوص الكتب، ستظل أخطارا محدقة بما نملك وما سوف ننتج من الكتب.
—————–
الهوامش:
1-ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص25، تحقيق: محمود شاكر، ط: المدني، جدة، د- ت.
2-النابغة الذبياني، الديوان، ص89، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: دار المعارف، القاهرة1985م. المرزباني، الموشح، ص26، تحقيق:علي محمد البجاوي، ط: دار الفكر العربي، القاهرة، د- ت.
3-النابغة الذبياني، الديوان، هوامش المحقق، ص89. وانظر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء1/ 163 :164، تحقيق: أحمد شاكر، ط: دار التراث العربي، القاهرة، د- ت.
4-ابن قتيبة، الشعر والشعراء1/164.
- ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص48.
- كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي4/92 :93، ترجمة: د. رمضان عبد التواب، ط: دار المعارف، القاهرة.
- ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص4.
- السيوطي، المزهر2/214، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين، ط: الثانية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د- ت.
- ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص8.