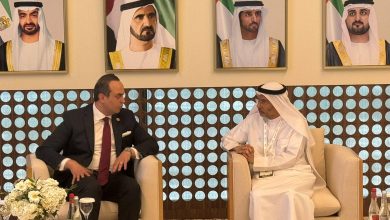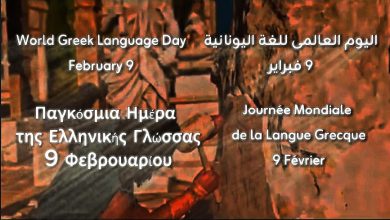عبد الغفور مغوار يكتب النقد الأدبي الأكاديمي: أدوات الناقد المتمرس ورهانات القراءة العميقة

يعتبر النقد الأدبي الأكاديمي من أرفع أشكال الممارسة الفكرية التي انشغل بها الإنسان منذ وجد النص ووجدت الحاجة إلى فهمه وتأويله. فهو ليس مجرد انطباعات ذوقية أو أحكام عابرة، بل منظومة معرفية متكاملة تستند إلى أدوات منهجية ومرجعيات نظرية دقيقة، وتتطلب من الناقد المتمرس امتلاك قدرة استثنائية على الغوص في أعماق النصوص لاستخراج بنياتها الجمالية والفكرية والثقافية.
وقد تطور النقد عبر العصور، من البلاغة الكلاسيكية عند أرسطو وعبد القاهر الجرجاني، إلى المناهج الحديثة التي رسخها نقاد القرن العشرين مثل رولان بارت، تزفيتان تودوروف، وجاك دريدا، وصولا إلى الدراسات النقدية المعاصرة التي تمزج بين التحليل النصي والمقاربات السوسيولوجية والأنثروبولوجية.
إن الناقد الأكاديمي، في هذا السياق، يعتبر وسيطا معرفيا وثقافيا بين النص والقارئ، يمارس دوره من خلال امتلاك حزمة من الوسائل العلمية، بدءا من القراءة الدقيقة والبحث التوثيقي، مرورا بفهم السياقات التاريخية والاجتماعية والثقافية للنص، وانتهاء بصياغة رؤية نقدية تحترم منطق البحث الأكاديمي وتستند إلى المراجع الموثوقة العالمية.
كما أن قوة الناقد لا تكمن فقط في حيازته للمناهج والأدوات، بل أيضا في قدرته على استثمار خبراته المعرفية واللغوية والجمالية في سبر أغوار المادة المدروسة، وربطها بحقول معرفية موازية، وإنتاج قراءة نقدية ثرية، قادرة على الإضافة إلى رصيد البحث الأدبي، وتحفيز الحوار الثقافي حول النصوص والأفكار؛ والأكثر من هذا فإن قوته تكمن في التزامه بالحياد الذي يعتبر صلب أخلاقيات النقد، فهو يبقى مراقبا دقيقا بعيدا عن الأهواء والانحيازات، محافظا على مصداقيته العلمية وموضوعيته.
-I مدخل منهجي إلى النقد الأدبي الأكاديمي وأساسياته
النقد الأدبي الأكاديمي هو إحدى الركائز الأساسية في دراسة الظاهرة الأدبية، إذ يجمع بين المعرفة النظرية الصارمة، والقدرة التحليلية العميقة، والممارسة المنهجية المنضبطة. وإذا كان الأدب انعكاسا للوعي الفردي والجماعي، فإن النقد الأكاديمي هو الآلية التي تسمح بقراءة هذا الوعي وتفكيك رموزه، من خلال أدوات ووسائل تمكن الناقد من استكناه أغوار النصوص وكشف بنياتها الخفية.
ولذلك، فإن الناقد الأكاديمي لا يكتفي بإبداء الرأي أو الانطباع، فهو مخالف تماما للنقد الصحفي أو الانطباعي، إن هذا النوع من النقد يتمحور غالبا حول الرأي الشخصي، التجربة الذاتية، والتوصيف العرضي، دون تحر نقدي معمق أو ضبط استدلالي – كما صرنا نرى عند البعض هنا وهناك-. بل الناقد الأكاديمي يمارس فعلا معرفيا منظما يستند إلى مناهج بحثية، وإلى ثقافة موسوعية، وإلى حس جمالي، مما يجعله فاعلا أساسيا في تجديد الفهم الأدبي وتطوير الدراسات الإنسانية.
1- تحديد المفهوم والتمييز المنهجي
أ) تعريف النقد الأدبي الأكاديمي
يمكن تعريف النقد الأكاديمي بأنه دراسة منهجية للعمل الأدبي، تقوم على تحليل عناصره الشكلية والمضامينية، وربطها بسياقاتها التاريخية والثقافية والفكرية، اعتمادا على مناهج علمية ومرجعيات موثوقة. ويرى الناقد الفرنسي Jean-Yves Tadié أن النقد الأكاديمي هو فن قراءة النصوص قراءة ثانية، قراءة تفسر وتحلل وتعيد بناء المعنى وفق ضوابط عقلية وجمالية.
ب) الفرق بين النقد الأكاديمي والنقد الانطباعي
بينما يستند النقد الأكاديمي إلى أسس نظرية ومنهجية، ويتطلب دقة في الاستشهاد بالمصادر، فإن النقد الانطباعي يقوم في الغالب على الموقف الشخصي والذوق الخاص. وفي هذا السياق، يشير محمد مندور إلى أن النقد القائم على الذوق وحده يظل محدود الأثر، أما النقد القائم على العلم والمعرفة فهو الذي يرسخ قيمة العمل الأدبي في تاريخ الثقافة. فهو يقول في مقدمة كتابه: “والذي نقصده بعبارة النقد المنهجي هو ذلك النقد الذي يقوم على منهج تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة، ويتناول بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات يفصل القول فيها، ويبسط عناصرها ويبصر بمواضع الجمال والقبح فيها.” (النقد المنهجي عند العرب، 1996)
2- مرتكزات العمل النقدي الأكاديمي
لكي يكون الناقد الأكاديمي قادرا على مقاربة النصوص بعمق، يحتاج إلى مجموعة من المرتكزات المعرفية والمنهجية، وهي بمثابة الأساس الذي تبنى عليه عملياته التحليلية.
أ) الخلفية المعرفية الموسوعية
الناقد المحترف يملك قاعدة معرفية واسعة تشمل:
– الأدب وتاريخه: الإلمام بالمدارس الأدبية والحركات الفنية.
– النظريات النقدية: من الكلاسيكية إلى ما بعد البنيوية.
– العلوم الإنسانية: الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، اللسانيات.
ب) الوعي بالمنهج
اختيار المنهج النقدي ليس عملا اعتباطيا، بل يخضع لطبيعة النص وأهداف القراءة. فقد يعتمد الناقد المنهج التاريخي إذا كان يسعى لربط العمل بسياقه، أو البنيوي إذا كان يركز على تحليل البنية الداخلية، أو السيميائي إذا كان معنيا برصد العلامات والدلالات.
ج) الحس الجمالي
المعرفة وحدها لا تكفي، لأن الناقد بحاجة إلى ذائقة فنية تمكنه من إدراك جماليات النص وتقييم أثرها في القارئ. كما أن الحس الجمالي يتيح له موازنة التحليل العقلي بالانفعال الإبداعي، وهو ما يمنع النقد من التحول إلى تقرير علمي جاف.
3- أهداف الناقد الأكاديمي
يتمحور دور الناقد المتمرس حول أهداف أساسية، منها:
– الإضاءة على البنية الداخلية للنص: كشف تماسكه أو هشاشته البنيوية.
– تفسير المعنى: البحث في الدلالات الظاهرة والخفية.
– تأطير العمل في سياقه التاريخي والثقافي.
– تطوير النظرية النقدية: عبر تقديم قراءات مبتكرة تفتح آفاقا جديدة.
-II أدوات الناقد الأكاديمي المنهجية وإمكاناته المفاهيمية
1- أُسس منهجية: أدوات العملية النقدية الأكاديمية
أ) النقد التكاملي – أدواته المفاهيمية
إن المنهج التكاملي من أبرز أدوات الناقد الأكاديمي المعاصر، ويقوم على خمسة “مفاتيح إجرائية” أساسية وفق ما عرضها نعيم اليافي، وكما صاغها عامر رضا:
الموسوعية: قاعدة معرفية واسعة تتيح للناقد استخدام أدوات متعددة.
الانتقائية: اختيار الأدوات الأكثر ملاءمة للنص المعني.
الانفتاحية: انفتاح ذهني للنقاد على منهجيات متنوعة.
التركيب: دمج الأدوات المختارة ضمن خطة تحليلية متماسكة.
النصية: احترام بنية النص وهويته دون تشويه أو إفراط في التوظيف النقدي.
كما يقول الدكتور اليافي عن هذا التقسيم: ” تعد الكلمات السابقة عن النقد التكاملي حديثا مجتزءا ومتمما في آن لحديث سابق عن المغامرة النقدية …، لا يمكن أن يتم فهم أحدهما إلا بالرجوع إلى ثانيهما، وبتعبير أدق وأصح لا يمكن أن يتم فهم موقفي النقدي ورأيي وأطروحاتي فيما يتعلق بإشكالية النقد – رؤية ومصطلحا ومنهجا – إلا بالرجوع إليهما معا.” (اليافي، ص. 20)
من هنا نفهم أن هذه المفاتيح لا تفرغ النص من معناه، بل تعزز فهمه، شرط أن يتم استثمارها بدقة ووعي.
ب) أدوات التحليل الرقمية: اللتروميترية والعصر الرقمي
أحدثت اللتروميترية أو ” القياس الأدبي” (littérométrie) ثورة في نقد الأدب الرقمي، فهي تخصص فرعي من الدراسات الأدبية في مجال العلوم الإنسانية الرقمية، وقد اقترحها الباحث بول فييفر ووضحها بشكل مفصل ميشيل برنارد وباتيست بوهيت. يهدف هذا التخصص إلى تطوير أساليب وأدوات منهجية لقياس وتحليل النصوص الأدبية، مع التركيز على دراسة ظروف إنتاجها وتلقيها. يعتمد القياس الأدبي على مبادئ القياس المعجمي (lexicométrie) والقياس اللغوي (logométrie)، ويستخدم تقنيات تحليل البيانات والإحصاء النصي، مثل برنامج Alceste، ليتمكن من التحقق الموضوعي من الفرضيات دون اللجوء إلى التفسيرات الذاتية أو التعسفية. يتضمن القياس الأدبي استخدام أدوات خاصة لإنتاج النصوص الرقمية (مثل تنسيق XML/TEI)، وأدوات لتحليل وتعداد المفردات والمقارنات بين النصوص، بالإضافة إلى مؤشرات إحصائية وتنظيمية توضح بنيتها. كما يستعين بأدوات عرض بصرية لتمثيل النتائج، مثل الرسوم البيانية والمخططات، مما يجعل من القياس الأدبي منهجا علميا دقيقا لدراسة النصوص الأدبية ضمن سياقاتها التاريخية والثقافية. وهو يقوم على:
– إحصاءات عددية: كثافة المفردات، أطوال المقاطع، توزيع العناوين.
– مقارنة نصين أو أكثر، ورصد تطور المفردات أو أنماط التركيب.
هذه الأدوات تظهر الثراء البنيوي للنصوص بطريقة دقيقة وموضوعية.
ج) منهجية التحليل التقليدي المنهجي
تعتمد المناهج الأكاديمية الراسخة على تحليل نصوصي دقيق ومنظم، وذلك من خلال:
– تفكيك العناصر الأدبية: الحبكة، الشخصيات، الإطار الزماني والمكاني، الأسلوب اللغوي.
بناء إشكالية نقدية واضحة: من خلال صياغة أسئلة تحليلية مثل: “كيف يجسد النص الصراع الداخلي؟”، ثم تطوير الحجج والاستدلالات.
مراجعة ومناقشة الأدبيات السابقة: لا تقتصر على جمع المعلومات فقط (أي رصد الخلفية)، بل الهدف منها أيضا الكشف عن نقاط الضعف أو الثغرات فيها، وبالتالي بناء فهم جديد أو توجه بحثي مختلف.
د) المنهج التاريخي البنيوي في النقد
يعتبر كتاب «Méthodes de critique littéraire» لإليزابيث رافو—رالو، مرجعا منهجيا مهما ومفيدا للطلاب كما للنقاد في مجال الأدب المقارن والدراسات الأدبية، حيث يقدم نظرة عامة على المناهج النقدية المختلفة (مثل الشكلانية، البنيوية، التحليل النفسي، السوسيولوجية، إلخ) ويوضح كيفية تطبيقها. كما يعرض دراسات نقدية مثل الهرمنيوطيقية، الأسلوبية، السيميائية، الاجتماعية …
ويظهر كيفية قراءة النصوص عينيا عبر حجرات نقدية متميزة، ويحلل أدواتها ونقاط ضعفها.
كما قدم نورثروب فراي في كتابه “Anatomy of Criticism” – حسب ويكيبيديا – إطارا موحدا للنقد عبر أربع اتجاهات: التاريخي، الأخلاقي، الأسطوري، البلاغي.
2- إمكانيات الناقد الأكاديمي
أ) منظومة معرفية متعددة التخصصات
للإجابة على مثل هذا التساؤل “ما الذي يميزه -الناقد- ويعزز قدرته على التغلغل في النص؟”، جوابنا هو أن الناقد القادر يجمع بين:
– الإلمام بالأدب وتاريخه.
– فهم نظري لمنهجيات النقد المتنوعة.
– ثقافة إنسانية واسعة تغطي فلسفة، علم اجتماع، لسانية، علم نفس.
فهذا الخليط يمده بمرونة تحليلية، وقدرة على ربط النص بعوالمه الاجتماعية والثقافية.
ب) الحس الجمالي التحليلي
يمثل الحس الجمالي التحليلي الركن الأساسي في عملية النقد الأدبي، حيث لا يكفي أن يكون الناقد ملما بالمعارف النظرية والمناهج النقدية فحسب، بل يجب أن يمتلك أيضا ذائقة فنية مرهفة تمكنه من تقدير جماليات النص وتأثيراته العاطفية والفكرية. هذه الذائقة النقدية هي التي تعمل كجسر يربط بين الجانب العقلاني (المعرفة النظرية) والجانب الانفعالي (التأثر بالنص). فالناقد الذي يفتقر لهذا الحس يصبح بحسب رأينا الشخصي المتواضع مجرد “مصوب تقني”، يكتفي بتحديد الأخطاء النحوية أو العروضية أو التعبيرية دون أن يدرك القيمة الفنية الحقيقية للنص. على سبيل المثال، قد يحلل ناقد قصيدة من حيث وزنها وبحرها وقافيتها، ويشير إلى خروج الشاعر عن قواعد العروض، لكن الناقد الذي يمتلك الحس الجمالي التحليلي سيتجاوز ذلك ليتأمل كيف أن هذا الخروج قد أحدث إيقاعا جديدا ومبتكرا يعزز المعنى العاطفي للقصيدة. مثال آخر، قد يرى ناقد في قصة ما شخصيات غير مكتملة الحبكة، بينما يرى الناقد الآخر الذي يمتلك الحس الجمالي التحليلي في هذا النقص تعمدا من الكاتب لخلق شعور بالغموض أو لإبراز هشاشة الشخصيات. هذا الحس هو ما يمكن الناقد من قراءة ما بين السطور واستكشاف الدلالات الخفية التي لا يمكن للمنطق وحده أن يكشفها.
ج) مرونة منهجية وانتقائية واعية
امتلاك الناقد الأكاديمي لهذه الميزة التي تعتبر من أهم سمات النقد الفعال، حيث لا ينبغي عليه الالتزام بمنهج نقدي واحد بشكل مطلق، بل يجب أن يكون قادرا على استخدام عدة مناهج، أو حتى أجزاء منها، بما يخدم النص قيد الدراسة. فالنص الأدبي قد يكون غنيا بأبعاد متعددة (نفسية، اجتماعية، تاريخية، جمالية) لا يمكن لمنهج واحد أن يحيط بها كلها. هذه المرونة المنهجية هي ما يميز الناقد المتبصر عن المقلد. على سبيل المثال، عند دراسة رواية “مدن الملح” لعبد الرحمن منيف، قد يبدأ الناقد بتحليل البنية السردية والشكلانية (المنهج البنيوي) لفهم كيفية بناء النص، ثم ينتقل إلى المنهج السوسيولوجي لفهم أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الشخصيات والأحداث، وقد يستخدم في بعض الأجزاء من الرواية المنهج التاريخي لربط الأحداث بالحقائق التاريخية لتلك الفترة. وفي مثال آخر، عند تحليل قصيدة للشاعرة نازك الملائكة، يمكن للناقد أن يطبق المنهج النفسي لفهم الدوافع الداخلية للشاعر، وفي الوقت نفسه يستخدم المنهج الجمالي لتحليل الصور الشعرية والرموز الفنية في القصيدة. هذه الانتقائية الواعية تسمح للناقد بتقديم قراءة ثرية ومتكاملة للنص، متجاوزا حدود الأطر النظرية الجامدة.
د) استثمار النقد في الحياة الواقعية
وفقا لهذه الفكرة، لا يقتصر دور النقد على كونه تمرينا فكريا في تحليل البنية السردية أو الصور البلاغية فحسب، بل يمتد ليكون جسرا بين النص وحياة القارئ، مما يسمح باستثمار الدروس والأفكار المستخلصة في فهم الواقع. فالناقد الأكاديمي، من وجهة نظر تودوروف، يجب أن يكون معتنيا بـ”معنى” النص وقيمته الإنسانية. على سبيل المثال، عند تحليل رواية “مزرعة الحيوان” لجورج أورويل، لا يقتصر النقد على دراسة شخصيات الحيوانات كرموز فنية، بل يتوسع ليشرح كيف تستخدم الرواية هذه الرموز لتسليط الضوء على الأنظمة الشمولية في الواقع، وكيف تنشأ الخيانة والطغيان. وعند قراءة رواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي، لا يكتفي الناقد بتحليل البنية الروائية، بل ينظر إليها كدراسة عميقة للطبيعة البشرية، والضمير، والعدالة، مما يجعلها مرآة تعكس أسئلة وجودية حقيقية يعيشها الإنسان. بهذا، يصبح النقد أداة لإثراء فهمنا للعالم، وتطوير وعينا الأخلاقي، وإعادة توجيه الأدب ليكون له دور حيوي وفعال في حياة الأفراد والمجتمعات.
-III التفعيل التطبيقي للأدوات النقدية – دراسة حالة
1- مدخل تطبيقي
بعد استعراض الأسس النظرية والأدوات المنهجية للنقد، تأتي المرحلة الأكثر أهمية وحسما وهي التفعيل التطبيقي لهذه الأدوات. فالنقد العلمي لا يكتمل بمجرد فهم النظريات، بل تبرز كفاءة الناقد الأكاديمي الحقيقية في قدرته على تطبيق هذه المعرفة على النصوص الأدبية بشكل مباشر وملموس.
وهذه الفكرة يعبر عنها بوضوح الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو، الذي يرى أن النقد يجب أن يكون منغمسا في تفاصيل النص. في كتابه “الأدب والغرابة”، يؤكد عبد الفتاح كيليطو أن لا جدوى من أي خطاب نقدي لا يستند إلى النص ذاته، فالمعرفة النظرية لا تثمر إلا حين تختبر في تفاصيل النصوص، ويعاد اكتشافها من خلاله. انطلاقا من هذا المبدأ، يتضح أن المنهج النقدي لا يقاس بجمال صياغته النظرية، بل بفعاليته في كشف خبايا النص، وإثراء فهمنا له، وتقديمه للقارئ في ضوء جديد.
2- اختيار النص
في سياق التفعيل التطبيقي للأدوات النقدية، وقع اختياري على نص شعري مكثف للشاعر العربي أدونيس، من ديوانه “المطابقات والأضداد” عنوانه “السماء الآن هي نفسها الموت”. هذا النص رغم بساطته التركيبية فإنه يتميز بكثافته الدلالية، مما يجعله أرضا خصبة لتعدد القراءات وتداخل المناهج، حيث تتقاطع فيه الرمزية مع السيميائية، ويتداخل فيه البعد الفلسفي مع الشعري. فهو لا يكتفي بإثارة الأسئلة الوجودية حول الانتماء والمكان، بل يعيد تشكيل العلاقة بين الذات والكون من خلال لغة تتسم بالاختزال والتكثيف.
إنه نص يختبر قدرة الناقد على الغوص في طبقات المعنى، واستنطاق الإيحاءات الكامنة خلف الكلمات، مما يجعله نموذجا مثاليا لتفعيل أدوات النقد الأكاديمي في مستوياتها النظرية والتأويلية.
3- تطبيق الأدوات المنهجية
أ) التحليل السيميائي
في ضوء التصور السيميائي لأمبرتو إيكو، الذي يرى أن النص الأدبي ليس مجرد حامل لمعنى ثابت، بل هو “آلة لتوليد المعنى” تتفاعل مع القارئ وتعيد تشكيل دلالاتها باستمرار، يمكن اعتبار قصيدة أدونيس شبكة كثيفة من العلامات التي تتجاوز المستوى اللغوي لتلامس البنية الرمزية والثقافية. فالقصيدة لا تقرأ بوصفها خطابا شعريا فحسب، بل كمنظومة دلالية تتقاطع فيها الرموز الكونية (السماء، الأرض، الشمس، الزمن) مع إشارات تاريخية وحضارية (العبودية، الإبادات، اللغات، الكتابة)، مما يجعل كل عنصر فيها قابلا للتأويل وفق سياقات متعددة.
تتجلى في القصيدة علامات متكررة مثل “السماء”، “الأرض”، “الزمن”، “الكتاب”، “اللغة”، وهي ليست مجرد مفردات بل رموز مشحونة بدلالات متراكبة. “السماء” مثلا، تتحول من رمز للسمو والقداسة إلى علامة للموت والعبث، كما في قوله: “والسماء الآن هي نفسها الموت”. هذا التحول الدلالي يعكس انزياحا سيميائيا يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والكون، ويطرح سؤالا وجوديا حول معنى الانتماء والغاية. كذلك، فإن “اللغة” في القصيدة لا تقدم كوسيلة للتواصل، بل ككائن حي يبارك الدماء ويتطاير في أنابيب كونية، مما يحولها إلى علامة على التواطؤ والخراب، ويقوض مركزيتها كأداة للدلالة.
بهذا المعنى، لا تكتفي القصيدة بإنتاج صور شعرية، بل تخلق نظاما سيميائيا مفتوحا، حيث كل علامة تستدعي أخرى، وكل دلالة تنقض سابقتها أو توسعها. إن القارئ، وفقا لإيكو، لا يستهلك النص بل يعيد إنتاجه، وهذا ما تتيحه قصيدة أدونيس بامتياز، إذ تضعنا أمام نص لا يقرأ مرة واحدة، بل يعاد تأويله في كل قراءة، ويظل مفتوحا على احتمالات لا نهائية من الفهم والتفكيك.
ب) التحليل البنيوي
وفق تصور رولان بارت الذي يعتبر النص بنية مغلقة، تتحدد قوانينها من داخلها لا من خارجها، يمكن قراءة قصيدة أدونيس باعتبارها نظاما لغويا مكتفيا بذاته، حيث تتفاعل عناصره وفق علاقات داخلية صارمة، لا تحيل بالضرورة إلى مرجعيات خارجية. فالنص لا يفسر عبر نوايا المؤلف أو السياق التاريخي، بل من خلال البنية التي تشكل وحداته وتربطها ببعضها البعض. في هذا السياق، تتبدى القصيدة كبنية شعرية تتأسس على التكرار، والتقابل، والانزياح، وهي تقنيات بنيوية تنتج المعنى داخل النص ذاته.
يتكرر في القصيدة نمط لغوي قائم على التوازي البنيوي بين مفاهيم متضادة: السماء/الموت، الأرض/العبودية، اللغة/الدم، الكتابة/الإبادة. هذا التوازي لا يقرأ كإحالة إلى واقع خارجي، بل كآلية داخلية تشكل منطق النص. فحين يقول أدونيس: “السماء الآن هي نفسها الموت”، لا يقدم وصفا كونيا، بل يفعل علاقة بنيوية بين عنصرين متقابلين، يندمجان داخل النص ليشكلا وحدة دلالية جديدة. كذلك، فإن استخدامه لعبارات مثل “اللغة تبارك الدماء” و”الكتابة تُباد” يخلق شبكة من العلاقات التي تعيد تعريف الوظائف التقليدية لهذه المفاهيم، وتنتج بنية شعرية تقوم على قلب المعايير.
إن القصيدة، وفق هذا المنظور، لا تقرأ بوصفها تعبيرا عن تجربة ذاتية أو موقف فلسفي، بل كبنية لغوية مغلقة، تنتج معناها من خلال انتظام عناصرها وتفاعلها الداخلي. فكل جملة، وكل صورة، وكل انزياح، يخضع لقانون داخلي يربطه بما قبله وما بعده، ويسهم في بناء الكل النصي. بهذا، تتحول القصيدة إلى نظام دلالي مستقل، لا يحتاج إلى تفسير خارجي، بل إلى تفكيك داخلي يكشف عن منطقها البنيوي الخاص.
ج) التحليل النفسي
حسب مقاربة غاستون باشلار، الذي يرى أن الصورة الشعرية ليست مجرد بناء لغوي بل انعكاس لرغبات ومخاوف لاواعية، يمكن قراءة قصيدة أدونيس بوصفها تجسيدا لحالة نفسية مأزومة، تتأرجح بين الرغبة في الانفلات من الواقع والبحث عن مأوى رمزي في فضاءات متخيلة. فالقصيدة لا تكتفي بتوصيف العالم، بل تكشف عن توتر داخلي عميق، حيث تتصارع الذات مع مفاهيم الانتماء، الزمن، والمصير، وتعيد تشكيلها عبر صور شعرية مشحونة بالقلق والاغتراب.
يتكرر في القصيدة حضور الذات المتشظية، التي لا تعرف من أين أتت ولا إلى أين تمضي: “نحن الأشباح الآدمية التي تدب على هذه الأرض بقدمين اثنتين، لم نعد نعرف من أين نأتي أو من أين أتينا وإلى أين نمضي.” هذه الصورة، في ضوء باشلار، تعبر عن لاوعي مأزوم، يبحث عن موطئ قدم في عالم يتهاوى. فالذات هنا ليست فاعلة، بل متلقية للضياع، تتنقل بين الأمكنة دون أن تستقر، وتعيش الزمن كحالة من الرمل المتساقط، لا كخط ممتد. كذلك، فإن صورة “الكتاب الذي يتطاير حرفا حرفا في أنابيب كونية” ترمز إلى تفكك الهوية المعرفية، وانهيار المرجعيات، مما يعكس رغبة لاواعية في الهروب من سلطة المعنى، ومن مركزية اللغة.
أما صورة “السماء الآن هي نفسها الموت”، فهي ذروة هذا التوتر النفسي، حيث يتحول الفضاء الأعلى، الذي غالبا ما يرتبط بالأمل والخلاص، إلى مرآة للموت. هذا الانقلاب الدلالي يكشف عن خوف دفين من المطلق، ومن الفراغ الكوني، ويجعل من القصيدة صرخة لاواعية في وجه العدم. إن الذات الأدونيسية، في هذا السياق، لا تبحث عن إجابة، بل تطرح الأسئلة بوصفها ملاذا أخيرا من الانهيار، وتعيد تشكيل العالم عبر صور شعرية تنبع من عمق النفس، لا من سطح اللغة.
د) الربط بالسياق الثقافي
لا تنفصل قصيدة “السماء الآن هي نفسها الموت” عن السياق الحضاري الذي تنبثق منه، فهي تتغذى من توتر ثقافي عميق، حيث تتقاطع الأسئلة الشعرية مع تحولات الهوية، وانهيار المرجعيات، وتفكك المعنى. في هذا الإطار، لا تقرأ الصور الشعرية بوصفها تعبيرا فرديا فحسب، بل بوصفها صدى لأزمة جماعية حلت بأمة كاملة، تتجلى في مفردات مثل “الكتاب الذي يتطاير حرفا حرفا في أنابيب كونية”، وهي صورة تختزل انهيار البنية المعرفية، وتفكك اللغة بوصفها حاملة للهوية والسلطة. هنا، لا يعود الحرف وسيلة للقول، بل يتحول إلى شظايا، مما يعكس فقدان الثقة في قدرة الثقافة على احتواء الذات أو تفسير العالم.
كما أن حضور “الأشباح الآدمية التي تدب على هذه الأرض بقدمين اثنتين” يشي بوعي مأزوم، يتحدث من داخل لحظة حضارية مثقلة بالاغتراب. هذه الكائنات ليست بشرا بالمعنى الثقافي المألوف، بل تجسيد لذات فقدت مركزها، تتنقل في فضاء لا يمنحها انتماء ولا معنى. في هذا السياق، تتحول القصيدة إلى فعل تفكيك رمزي، يعيد مساءلة الموروث، ويقترح شعريا إمكانات جديدة للوجود خارج الأطر المغلقة. إن النص لا يكتفي بوصف الخراب، بل يشتبك معه، ويعيد تشكيله عبر لغة تنبثق من هشاشة الثقافة لا من صلابتها، مما يجعل من الشعر أداة مساءلة حضارية بامتياز.
4- قراءة مركبة
عند الجمع بين المقاربات الرمزية والبنائية والنفسية والثقافية، يتضح أن قصيدة “السماء الآن هي نفسها الموت” لا تقرأ من زاوية واحدة، بل تنفتح على مستويات متعددة من الدلالة، تتشابك لتكون نسيجا شعريا كثيفا:
– رمزيا، تتجلى علاقة متوترة بين المطلق والنسبي، حيث تتحول السماء من فضاء للتعالي إلى مرآة للخراب، مما يعكس انقلابا في البنية الرمزية التي طالما ربطت العلو بالخلاص.
– بنيانيا، يقوم النص على تقابل بين فضاءين: الأرض التي تسكنها الأشباح الآدمية، والكون الذي تتطاير فيه الحروف، مما يخلق توترا بين الثبات والتلاشي، وبين التجسيد والتجريد.
– نفسيا، ينبثق من الصور قلق وجودي عميق، حيث الذات لا تعرف من أين أتت ولا إلى أين تمضي، وتعيش الزمن كحالة من الرمل المتساقط، لا كخط ممتد، كما قلنا سابقا.
– ثقافيا، يلوح أثر المنفى لا بوصفه جغرافيا، بل كحالة رمزية، حيث اللغة نفسها تنفى من معناها، والهوية تتفكك إلى أشلاء معرفية، كما في صورة “هل صار علينا أن نقشر حروف الكلمات وأجسام الأشياء، لكي نفهم؟”.
هذا التكامل في التحليل يجسد ما أشار إليه تزفيتان تودوروف حين اعتبر أن أفضل النقد هو الذي يزاوج بين المعرفة النظرية والإنصات العميق لصوت النص، فالقصيدة لا تفكك فقط عبر المفاهيم، بل يصغى إليها بوصفها كائنا حيا، ينبض بتوترات الذات والكون، ويعيد تشكيل العالم من داخل هشاشته.
5- القيمة الأكاديمية للتطبيق النقدي
يمثل التطبيق النقدي صلب الممارسة الأكاديمية للنقد الأدبي، إذ يتيح اختبار النظريات في سياقها الحي، ويكشف عن مدى مرونتها وفعاليتها في مقاربة النصوص. فالنظرية، مهما بلغت من التجريد والدقة، تبقى ناقصة ما لم تفعل في قراءة نصية تبرز قدرتها على الإضاءة والتفسير، وهذا فسرناه سابقا. من هنا، لا تعد الأدوات النقدية غاية في ذاتها، بل وسائل لفهم النصوص وإدراك بنياتها العميقة، وتفكيك أنساقها الجمالية والدلالية.
إن القيمة الأكاديمية للتطبيق لا تكمن في مطابقة النص للنظرية، بل في الحوار الذي ينشأ بينهما، حيث يختبر المنهج، ويعاد النظر في مفاهيمه، ويصقل بناء على ما يطرحه النص من تحديات. فالتطبيق النقدي الجاد لا يكتفي بتوظيف الأدوات بشكل آلي، بل يتطلب حسا تأويليا، وقدرة على التكييف المنهجي، بما يضمن قراءة متجددة للنصوص، تراعي خصوصيتها وتستنطق إمكاناتها.
وهذا ما يؤكده محمد برادة حين يشدد على ضرورة حيوية القراءة النقدية التي تتجدد بتجدد النصوص، في إشارة إلى أن النقد الأكاديمي لا يزدهر إلا حين يتحرر من الجمود المنهجي، ويتفاعل مع النصوص بوصفها كائنات حية، لا مجرد موضوعات تحليل. فالتطبيق، بهذا المعنى، ليس مجرد تمرين نظري، بل ممارسة معرفية وجمالية، تعيد تشكيل العلاقة بين القارئ والنص، وتفتح أفقا لتجديد النظر في المفاهيم النقدية ذاتها.
-IV إمكانيات الناقد الأكاديمي في سبر أغوار المادة المدروسة
1- منظومة معرفية متعددة التخصصات
الناقد الأكاديمي لا يكتفي بإلمام جزئي بالأدب، بل يمتلك منظومة معرفية متكاملة تشمل النقد، الألسنية، الفلسفة، علم النفس، وعلم الاجتماع، ما يمنحه قدرة فريدة على ربط النصوص بعوالمها الثقافية والفكرية. هذا التعدد المعرفي لا يأخذ على أنه ترف، بل ضرورة لفهم النصوص في سياقاتها المركبة، وتفكيك بنياتها الرمزية والدلالية.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور عبد النبي اصطيف أن الناقد المعاصر ينبغي أن يكون ملما باتجاهات النقد المقارن والثقافي، بما يمكنه من تجاوز حدود التقليد المحلي والانخراط في حوار نقدي عالمي، يراعي خصوصية النص العربي دون أن يعزله عن ديناميات الفكر الأدبي الكوني. فالمعرفة المتعددة التخصصات لا تثري أدوات الناقد فحسب، بل تعزز من قدرته على إنتاج قراءة نقدية تتسم بالعمق والمرونة، وتسهم في تطوير الخطاب النقدي العربي ليواكب التحولات المعرفية والجمالية المعاصرة.
2- الوعي المنهجي والانتقائية الواعية
الناقد الحقيقي لا يكتفي بتطبيق منهج واحد على جميع النصوص، بل يتحلى بوعي منهجي مرن، يمكنه من اختيار الأدوات النقدية الأنسب لطبيعة النص المدروس. فالنقد الأدبي ليس ممارسة ميكانيكية، بل فعل تأويلي يتطلب حسا انتقائيا واعيا، يوازن بين صرامة النظرية وخصوصية الإبداع. هذا ما تؤكده برامج أكاديمية رصينة، مثل برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الذي ينص على أن الطالب ينتقي الأدوات المناسبة لتحليل النصوص الإبداعية في ضوء المناهج والنظريات الأدبية واللسانية الحديثة، مما يعكس توجها تربويا نحو التعدد المنهجي والانفتاح على مقاربات متنوعة.
وفي السياق ذاته، يبرز في كتاب “مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته” للدكتور صلاح فضل، تأكيده على أهمية المزج بين المناهج دون الوقوع في التوفيق السطحي، حيث يرى أن الناقد المثقف هو من يحسن اختيار المنهج بحسب طبيعة النص، ويعيد تشكيل أدواته النقدية بما ينسجم مع خصوصية التجربة الأدبية، مشددا على أن الجمود المنهجي يفضي إلى قراءة مبتورة، بينما الانتقائية الواعية تنتج قراءة مركبة، تنفتح على مستويات متعددة من المعنى.
إن هذا الوعي المنهجي لا يعني التشتت، بل يدل على نضج نقدي يمكن صاحبه من التحرك بين البلاغة والأسلوبية، بين السيميائيات والتداوليات، دون أن يفقد البوصلة المعرفية التي توجه قراءته. فالناقد الناجح لا يخضع النص للنظرية، بل يخضع النظرية لأسئلة النص، ويعيد تشكيل أدواته بما يليق بفرادته.
3- الحس الجمالي النقدي
المعرفة وحدها لا تكفي لتكوين قراءة نقدية مؤثرة، فالحس الجمالي هو ما يمنح الناقد القدرة على الإنصات إلى نبض النص، والتفاعل مع إيقاعه الداخلي، واستشعار ما يتجاوز بنيته اللغوية نحو أفقه الإنساني. الذائقة الفنية ليست امتدادا للثقافة فحسب، بل هي نتاج تفاعل وجداني ومعرفي، يصقل عبر التأمل والتجربة، ويغذى بالحب الحقيقي للمادة الأدبية. فالنص لا يقرأ فقط بعين العقل، بل يستشعر بجمالياته، ويعاد تشكيله في وجدان القارئ الناقد، الذي يرى فيه ما لا يقال صراحة، بل يلمح إليه عبر الصورة والظلال.
هذا التفاعل يتقاطع مع مفهوم الانفعال الجمالي كما طرحه الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلو-بونتي، الذي يرى أن الجمال لا يدرك بوصفه موضوعا خارجيا، بل يعاش كخبرة داخلية، حيث يتداخل الإدراك الحسي مع الوعي الجمالي، ويصبح النص امتدادا لجسد القارئ ووعيه. فالناقد لا يصف الجمال، بل ينفعل به، ويعيد إنتاجه عبر لغة نقدية تتسم بالحيوية والانخراط.
كما يتناغم هذا التصور مع نظرية جماليات التلقي لدى هانس روبرت ياوس، التي تؤكد أن المعنى لا يُولد في النص وحده، بل في العلاقة بين النص والقارئ، حيث تصبح الذائقة النقدية أداة لإعادة تشكيل التجربة الأدبية. فالقارئ ليس متلقيا سلبيا، بل شريكا في إنتاج المعنى، يفعل النص عبر أفق توقعاته، ويعيد تأويله في ضوء خبراته الجمالية والمعرفية.
بهذا المعنى، يصبح الحس الجمالي عنصرا جوهريا في الممارسة النقدية، لا يستغنى عنه، لأنه يضفي على التحليل بعدا إنسانيا، ويحول القراءة من فعل تقني إلى تجربة وجودية، تعيد وصل القارئ بالنص، وتعيد وصل النص بالحياة.
4- القدرة على التحليل التقني والتقني التحليلي
لا تكتمل الممارسة النقدية دون امتلاك أدوات تحليلية دقيقة، تمكن الناقد من تفكيك بنية النص واستكشاف طبقاته السردية والرمزية. فالمقاربات البنيوية والسيميائية، كما أشرنا سابقا، تتيح فهم العلاقات الداخلية التي تحكم النص، من خلال مفاهيم مثل “السانكرونية”، و”التركيز”، و”المدة”، وهي أدوات تضيء البنية الزمنية والسردية، وتكشف كيف يعاد تشكيل المعنى عبر التلاعب بالزمن والخطاب.
في هذا التصور، ينظر إلى النقد بوصفه خطابا ثانيا يتماهى مع لغة النص، لا يعلق عليه من خارجه، بل يدخل في نسيجه، ويعيد إنتاجه بلغة تحليلية تتناول بنياته دون أن تفقد استقلالها التأويلي. فالنقد لا يصف النص، بل يعيد تشكيله ضمن “ميتالغة” تستبطن منطقه الداخلي، وتكشف آلياته التعبيرية.
لكن هذا التحليل لا يمارس بوصفه تفكيكا تقنيا جافا، بل يتطلب حسا جماليا وانفعالا وجدانيا، كما تشير إليه فلسفة الإدراك الجمالي، التي ترى أن المعنى ينبثق من تفاعل الجسد والوعي مع العالم، وأن النص يقرأ عبر تجربة حسية داخلية، لا عبر أدوات خارجية فقط. فالتقنيات السردية ليست مجرد بنيات، بل هي تجليات لحس إنساني، يستشعر ويعاد تأويله.
وهنا تتقاطع هذه الرؤية مع جماليات التلقي، حيث يصبح التحليل فعلا تواصليا بين النص والقارئ، يفعل فيه القارئ أدواته النقدية ضمن أفق توقعاته، ويعيد تشكيل النص في ضوء تجربته الجمالية. فالتقنية ليست نقيضا للجمال، بل هي وسيلة لبلوغه، حين تمارس بوعي وانفعال، لا ببرود أكاديمي.
بهذا المعنى، فإن القدرة على التحليل التقني لا تختزل في معرفة المصطلحات أو تطبيق المناهج، بل تتطلب انخراطا وجدانيا، وذائقة نقدية تعيد وصل التقنية بالروح، وتحول القراءة إلى تجربة جمالية تحليلية، تضيء النص وتعمق أثره.
5- الانفتاح على التعدد النقدي والتاريخي
الناقد المثقف لا يكتفي بالانتماء إلى مدرسة واحدة أو مرجعية محددة، لأن النقد الأدبي هو حقل متداخل، تتقاطع فيه الرؤى والمناهج عبر الثقافات والتواريخ. فالدعوة إلى ترسيخ النقد العربي لا تعني الانغلاق على الذات، بل تستدعي انفتاحا واعيا على التجارب الغربية، بما فيها من مناهج تحليلية، ورؤى فلسفية، ومقاربات جمالية. هذا الانفتاح لا يفقد الناقد هويته، بل يعمقها، حين يعيد قراءة النص العربي في ضوء أدوات عالمية، دون أن يفرط في خصوصيته الثقافية.
إن الموقف الذي يرى في النقد الأوروبي مصدرا للإثراء لا للإلغاء، يعبر عن وعي تاريخي ونقدي، يدرك أن الأدب لا يقرأ في فراغ، بل في سياق حضاري متغير، وأن التعدد المنهجي هو ما يمنح القراءة عمقا ومرونة. فالنقد البنيوي، والتفكيكي، والتأويلي، والسيميائي، ليست بدائل متصارعة، بل أدوات متكاملة، تستخدم بحسب طبيعة النص، وأفق القارئ، وهدف القراءة.
6- التفاعل الخلاق بين المرجعيات
هذا الانفتاح لا يمارس بوصفه استيرادا آليا، بل بوصفه تفاعلا خلاقا، يعيد تشكيل المفاهيم الغربية ضمن سياق عربي، ويعيد تأويل النصوص العربية في ضوء حس نقدي متجدد. فالناقد الحقيقي لا يقلد، بل يحاور، ويعيد إنتاج المعرفة النقدية عبر تجربة شخصية، تزاوج بين العمق التاريخي والانفعال الجمالي.
وهنا تتقاطع هذه الرؤية مع فلسفة ميرلو- بونتي في الإدراك، ومع جماليات التلقي، حيث يصبح النقد فعلا وجوديا، لا مجرد تطبيق منهجي. فالتعدد النقدي لا يقاس بعدد المناهج، بل بقدرة الناقد على التحول، وعلى الإنصات إلى النص من زوايا متعددة، دون أن يفقد صوته الخاص.
هكذا إذن، يمكن اعتبار الانفتاح النقدي ضرورة إبداعية، تحرر القراءة من الجمود، وتعيد وصلها بالحياة، وبالآخر، وبالزمن.
7- التواصل مع الجمهور وإنشاء الحوار النقدي
لا يمارس النقد في عزلة معرفية، بل يتأسس ضمن فضاء جماعي يعيد تشكيل القراءة بوصفها فعلا تواصليا. فالنقد، في جوهره، لا يكتفي بإنتاج المعنى، بل يسعى إلى تداوله، وإلى خلق حوار يضفي على التفسير شرعية ومصداقية. ذلك أن التفسير يحقق قيمته من خلال الحوار النقدي حوله، مما يؤكد أن الفعل النقدي لا يستمد مشروعيته من صرامة منهجيته فحسب، بل من قابليته للتفاعل المجتمعي.
إن النقد الذي يعرض بشكل مبرر، ويقبل ضمن الأطر الثقافية والاجتماعية السائدة، هو الذي يكتسب مصداقية فعلية. فالمصداقية هنا ليست مجرد صفة ذاتية، بل هي نتاج علاقة جدلية بين الناقد والجمهور، حيث يعاد إنتاج المعنى في ضوء التلقي، والمساءلة، والتفاوض المعرفي. وبهذا، يصبح النقد فعلا عموميا، يتجاوز حدود النص ليخوض في أسئلة القيم، والتمثيل، والسلطة، والذوق.
ومن ثم، فإن إنشاء الحوار النقدي يعتبر ضرورة منهجية، تضمن للنقد حيويته واستمراريته. فكل قراءة نقدية، مهما بلغت دقتها، تبقى ناقصة ما لم تختبر في فضاء التداول، وما لم تقابل بقراءات أخرى تثريها أو تعارضها. على هذا الأساس، يتحول النقد إلى ممارسة ديمقراطية، تعيد الاعتبار للقراءة بوصفها فعلا جماعيا، متجددا، ومفتوحا على الاحتمال. مما يبين أن الناقد المحترف يجب أن يكون جزءا من شبكة تفاعلية نقدية تعيد إنتاج قراءته وتنقحها.
-V كفاءات الناقد الأكاديمي في الإقناع والتأثير
1- الناقد باعتباره وسيطا ثقافيا مؤثرا
لا يقتصر دور الناقد الأكاديمي على إيصال الرأي، بل يتعداه إلى التأثير في منظومة القبول الثقافي، وتشكيل الذائقة العامة. فهو الوسيط الذي يعيد ترتيب المشهد الأدبي، عبر تخليصه من الرداءة، وتقديمه في صورة قابلة للتداول النقدي. هذه المهمة تتطلب كفاءات مركبة تجمع بين الموهبة، والثقافة، والخبرة، والنزاهة، إضافة إلى قدرة استدلالية تقنع المتلقي وتؤثر فيه.
في هذا السياق، تؤكد دراسة منشورة في مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية أن التفكير النقدي يعتبر أداة أساسية لتطوير وعي الطلاب، وأن التعليم النقدي لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يحفز على التحليل والتفاعل، ويسهم في بناء قدرات الإقناع والتأثير لدى الأكاديمي، سواء كان أستاذا أو ناقدا. كما تشير إلى أن البيداغوجيا النقدية، وفق رؤية باولو فريري، تعزز من قدرة الناقد على مساءلة الخطاب، وتنمي مهاراته في التحليل والنقد البناء، مما يجعل منه فاعلا ثقافيا قادرا على تشكيل الوعي الجماعي عبر أدوات معرفية وتواصلية فعالة.
إن هذه الكفاءات لا تمارس في فراغ، بل ضمن فضاء تداولي يعيد إنتاج المعنى، ويمنح النقد شرعيته من خلال الحوار المجتمعي. فالمصداقية لا تستمد من صرامة المنهج وحدها، بل من قدرة الناقد على التأثير، وعلى خلق حوار نقدي يعيد تشكيل القراءة بوصفها فعلا جماعيا، متجددا، ومفتوحا على الاحتمال.
2- النص النقدي كحوار مشترك / النقد كحوار
النقد الأدبي لا يمارس في عزلة معرفية، بل يتأسس ضمن فضاء تواصلي يعيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ. فالنقد لا يكتفي بتفسير العمل الأدبي، بل يثير الفضول، ويحفز على التفاعل، ويخلق حوارا حيا تتداخل فيه الرؤى والانطباعات. كما ورد في مقال منشور على موقع Histoires en ligne ما مضمونه: من خلال الاعتماد على النص والأسلوب والمضمون، يكشف النقد المحكم عن ثراء العمل. إنه يشجع على التفكير ويغذي المناقشات المثيرة. وهكذا، يكون القارئ ليس فقط على اطلاع، ولكنه أيضا ملهم لاستكشاف ومشاركة القصص.
هكذا يصبح الناقد صوتا محفزا، لا يفرض رأيا، بل يفتح أفقا للتأمل، ويغرس قيم التمعن والاستكشاف. فالنقد الذي يمارس بوصفه حوارا، يعيد الاعتبار للقراءة بوصفها فعلا جماعيا، ويمنح النص حياة جديدة في وجدان المتلقي. إنه لا يغلق المعنى، بل يوسعه، ويعيد إنتاجه في ضوء تجربة جمالية ومعرفية متجددة.
3- النقد الأدبي باعتباره مدخلا للقارئ العميق
الناقد المتمكن لا يكتفي بتقديم رأي أو تلخيص، بل يعيد تشكيل تجربة القراءة لتغدو أكثر عمقا وطموحا. فالنقد الأدبي، حين يمارس بوعي وتحليل، يصبح مدخلا إلى فهم استبطاني للنص، يحرك القارئ نحو التأمل وإعادة النظر في تصوراته. كما ورد في مقال منشور على موقع Savoirs Libres “Comprendre les enjeux de la critique littéraire”: “النقد الأدبي لا يقتصر على رأي بسيط حول عمل ما، بل يعقد حوارا عميقا بين العمل والقارئ. إنه يشجع على التفكير، والتفسير، وأحيانا حتى على إعادة النظر في تصورات الفرد الخاصة.”
وبناء عليه، يسهم النقد في ربط علاقة فكرية وجمالية بين النص والقارئ، لا تقوم على التلقي السلبي، بل على التفاعل والتأويل. إنه يحفز على تجاوز القراءة السطحية نحو استكشاف المعاني الخفية، ويرسخ فعل القراءة كمسار معرفي داخلي، يعيد تشكيل الذات عبر النصوص.
4- المؤثر الفلسفي – المنهجي في النقد: بين النظرية والممارسة
يتأسس النقد الأدبي على خلفيات فلسفية ومنهجية تحدد رؤيته للعالم وللنص، وتؤطر العلاقة بين النظرية والممارسة. فكما توضح دراسة الدكتور حسام الدين فياض في المقالة الواردة في موقع “أنفاس نت” حول النظرية النقدية المعاصرة، فإن النقد لا يمارس بمعزل عن تصور فلسفي للواقع، بل ينبثق من موقف معرفي يسعى إلى مساءلة البنى الثقافية وكشف الأبعاد الإيديولوجية الكامنة في الخطاب. هذا التصور، الذي برز بوضوح في مدرسة فرانكفورت، يجعل من النقد فعلا تحرريا يتجاوز الوصف إلى إعادة تشكيل الوعي، ويؤكد أن الممارسة النقدية لا تنفصل عن الأسس الفلسفية التي توجهها.
وفي السياق ذاته، يبرز محمد بلعيد في دراسته المنشورة بمجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية (العدد 62، 2020) أن نقد النقد الأدبي لا يكتسب مشروعيته إلا حين يمارس ضمن منهجية علمية واضحة تستمد فلسفتها من الحقل الأبستمولوجي. ويشدد على أن الممارسة النقدية لا تختزل في تطبيق آلي لنظرية، بل تتطلب وعيا بالأطر النظرية التي تحكمها، وبالحدود التي تفصل بين التبعية المنهجية والاستقلالية الفكرية. من هنا، يتضح أن المؤثر الفلسفي والمنهجي في النقد لا يقتصر على التنظير، بل يتجلى في كيفية بناء الممارسة النقدية نفسها، وفي قدرتها على التفاعل الجدلي مع النص والسياق.
6- بين الحياة والنظرية: النقد باعتباره فعلا حيويا
يرى تودوروف في كتابه “Critique de la critique” أن النقد الأدبي لا ينبغي أن يختزل في أدوات التحليل أو في إعادة إنتاج النظريات، بل يجب أن يكون فعلا حيا يتصل بالحياة، ويسهم في فهمها وتغييرها. فالنقد، في تصوره، لا يمارس داخل حدود النص وحده، بل يتجاوزها ليصبح صوتا يتحدث عن الإنسان، عن القيم، عن التجربة، وعما يتجاوز المكتوب نحو ما يعاش. يقول تودوروف ما مضمونه إن النقد الجيد هو ذاك الذي ينخرط في حوار مع الحياة، لا يكتفي بما كتب في الكتب، بل يسعى إلى إضاءة ما يعاش خارجها.
هذا التصور يعيد الاعتبار للنقد بوصفه ممارسة إنسانية، لا تقنية فقط، ويؤكد أن الناقد الحقيقي هو من يعيد وصل الأدب بالحياة، ويجعل من القراءة فعلا وجوديا، لا مجرد تمرين ذهني. فالنظرية، مهما بلغت دقتها، تبقى ناقصة ما لم تختبر في ضوء التجربة، وما لم تفعل في سياق إنساني حي.
هكذا يصبح النقد مصباحا يضيء النص من الداخل، ويعيد وصله بالعالم، ويمنح القارئ فرصة لتأمل ذاته من خلال الأدب، لا أن ينعزل في تقنيات القراءة وحدها.
الخاتمة
في ضوء التحولات المعرفية والمنهجية التي شهدها الحقل النقدي، لم يعد النقد الأدبي الأكاديمي مجرد ممارسة تحليلية، بل غدا فعلا ثقافيا مركبا، يعيد تشكيل العلاقة بين النص، والقارئ، والمجتمع. فالناقد اليوم لا يكتفي بتفسير النصوص، بل يسهم في ضبط القيم الثقافية، وتوجيه الذائقة، وتوسيع أفق التلقي. كما تقول صليحة بردي في دراستها المنشورة في مجلة “Aleph”:
“يمثل كل من النقد الأدبي والنقد الثقافي مجالين معرفيين يتقاطعان أحيانا ويتمايزان في أحيان أخرى من حيث الموضوع، المنهج، والغاية.”
بهذا المعنى، يصبح الناقد الأكاديمي وسيطا بين الماضي والحاضر، بين النظرية والتجربة، وبين المعرفة والمؤسسات. فكما يوضح عبد الرسول الغفاري في كتابه النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، فإن الممارسة النقدية لا تكتمل إلا حين تفعل النظرية في سياق حي، وتختبر في ضوء النصوص، والتجربة، والتفاعل القرائي. النقد ليس انعكاسا للنظرية، بل هو تجسيد لها، وتحويلها إلى أدوات حية تسهم في بناء وعي أدبي متجدد.
من هنا، تبرز الحاجة إلى نقد أكاديمي منفتح، يعيد وصل الأدب بالحياة، ويخاطب الجمهور بلغة معرفية متحررة من الانغلاق المنهجي. فالمستقبل لا يبنى على التخصص الضيق، بل على القدرة على التفاعل، والتأويل، والتجديد. والناقد المتمرس هو من يعيد اكتشاف النصوص، ويصنع للثقافة مسارا يتجدد مع كل قراءة، ويمنح النقد حياة تتجاوز الجدران الأكاديمية نحو فضاء إنساني أرحب.
المراجع المعتمدة
أولا: المراجع العربية
محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، نهضة مصر، القاهرة، 1996.
نعيم اليافي، أطياف الوجه الواحد دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، دراسات أدبية، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط. 1، 1992.
رضا عامر، المناهج النقدية المعاصرة: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2020.
الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود شاكر. القاهرة: دار المدني، 1992.
أدونيس، المطابقات والأوائل، دار الآداب بيروت، 1988.
محمد برادة، أسئلة الرواية أسئلة النقد، دار الفنك، الدار البيضاء، 2000.
صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته، ميريت للنشر والمعلومات، 2002، ط. 1.
ثانيا: المراجع الفرنسية
Tadié, La critique littéraire, PUF, 1998.
Barthes, Roland. Critique et vérité. Paris : Éditions du Seuil, 1966.
Tzvetan Todorov, Critique de la critique, Éditions du Seuil, 1984
Derrida, Jacques. De la grammatologie. Paris : Éditions de Minuit, 1967.
ثالثا: المواقع الإلكترونية
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rom%C3%A9trie
https://revision.unimasys.com/comment-rediger-une-critique-litteraire-guide-complet-pour-les-etudiants/?utm
https://abcpresse.com/les-differentes-methodes-danalyse-litteraire.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_de_la_critique?utm
https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A.html
https://www.anisstaif.com/downloads/anisstaif_Al_Sharqa_Al_Thaqafia_99.pdf
https://www.hnjournal.net/volume6/issue5/6-5-9.pdf
https://histoiresenligne.com/articles-mis-a-jour/limportance-de-la-critique-litteraire-dans-la-promotion-de-la-lecture/?utm
https://www.anfasse.org/فلسفة-و-تربية/36-فلسفة/11694-النظرية-النقدية-المعاصرة:-مدرسة-فرانكفورت-نموذجاً-دراسة-تحليلية—-نقدية—د-حسام-الدين-فياض
https://aleph.edinum.org/14459