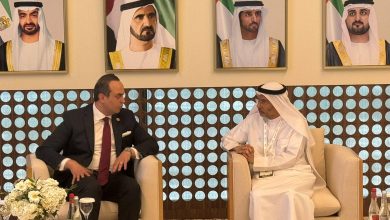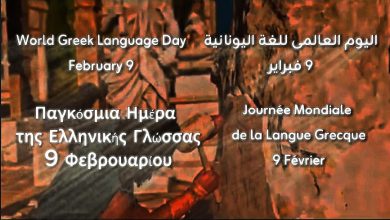عماد خالد رحمة يكتب نزعة الجدل ودورها في إرساء قواعد المعرفة الإنسانية

تُعَدُّ النزعةُ الجدليّة من أبرز القضايا التي يعيشها الفرد في مجتمعنا العربي، كما في المجتمعات الأخرى. غير أنّ الأفراد يختلفون في أساليبهم ومناهجهم في التعاطي مع الحالات والمواقف الجدلية؛ فبعضهم يميل إلى التعاطف مع الآخر وتفهُّم مواقفه، بينما يميل آخرون إلى النظر في القضايا والمسائل الحياتية من زاوية تحليلية، متجرّدين من العاطفة والانفعال.
وقد يُبدي بعض الأشخاص ميلاً ثابتًا وصارمًا نحو تصنيف الآخرين تصنيفًا ثنائيًّا حادًّا، مؤسِّسين منطقهم وفهمهم للجدل على ثنائيات قطعية، كـ(أبيض – أسود)، و(معي – ضدي)، متبنّين نهجًا إقصائيًّا يُختصر في: “إن لم تكن معي، فأنتَ ضدّي”، بدلاً من السعي إلى فهم القضايا فهمًا تركيبيًّا يشمل جوانبها السلبية والإيجابية على حدّ سواء.
ورغم أن التقسيم الثنائي قد يكون مفيدًا في بعض المواقف التي تتطلب قرارات عاجلة لا تحتمل التأجيل، إلا أنه يُعدّ من أكثر النزعات الفكرية ارتباطًا باضطراب القيم والأخلاق الإنسانية، لا سيما عند المراهقين، وبعض كبار السن الذين يتقمّصون حالة من “التصابي” أو “المراهقة المتأخرة”. فهذه الأخيرة تُعبّر عن أزمة هوية وتغيّر في الثقة بالنفس، تحدث غالبًا بين سِنَّيْ الخامسة والأربعين والخامسة والخمسين، وهي ظاهرة يمكن وصفها بأنها صدمةٌ نفسية ناجمة عن إدراك تناقُص العمر، أو الإحساس باقتراب النهاية الحتمية (الموت)، وهو ما يُولِّد في النفس خوفًا وقلقًا عميقَيْن، وربما شعورًا بالفشل أو القصور في الإنجازات الشخصية، وما يرافقه من اكتئاب وندم وقلق مرتفع.
إنّ النزعة الجدلية، بهذا المعنى، سِمة تجعل الفرد دائم الاستعداد للدفاع عن قضايا مثيرة للجدل. وفي المجال الفلسفي، يُطلق على المولَعين بالجدل اسم “السفسطائيين”، وهم أدعياء الفلسفة والعلم والمعرفة. ورغم امتلاكهم ثقافة بسيطة وسطحيّة، خصوصًا في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة، إلا أنهم بارعون في الخطابة والبلاغة، وهما جوهر اهتمامهم. وبفضل هذه المهارة، يعمدون إلى قلب الحقائق وخلطها، ويبدون استعدادًا دائمًا للنقاش إلى ما لا نهاية، وبلا كلل.
السفسطائيون يُكثرون الكلام المُموّه، ويعتمدون أساليب فاسدة في المنطق، ويتّسمون بعدم التهذيب، ويصرفون الأذهان عن الحقائق أو المسلَّمات العقلية والمنطقية، ويضلّلون خصومهم عن سبيل الحقيقة، مهما كانت واضحة. وكلّ ذلك من أجل كسب المال، والوصول إلى المناصب والنفوذ، عن طريق الخداع والاحتيال وفنون الإقناع الظاهري. فلا الحقيقة تعنيهم، ولا مشاعر الآخرين؛ إنّهم يسعون فقط إلى الجاه والمال والسلطة. ومنهم المتفيقهون، والرويبضة، والمتعالمون، والمتثاقفون، وغيرهم من الأدعياء.
ومن خلال دراسة هذه النزعة، يتبيّن أنَّ الأفراد ذوي الميل العالي للجدل يندمجون في الحوارات الجدلية بوعيٍ وقصد، ولا يتجنّبونها، بينما ينخرط بعضهم في عدوان لفظي شديد بسبب افتقارهم إلى المهارات الجدلية الرصينة. وبعض الأفراد يرون في الجدل تحدّيًا ذهنيًّا مثيرًا، وفرصةً لإثبات الذات، ودفاعًا عن المواقف والآراء. ومع ذلك، يختلف الأفراد في شدة رغبتهم في الخوض بالجدل؛ فذو النزعة الجدلية العالية يشعر بالإثارة والرضا عن الذات كلّما أوغل في الجدال، بينما يسعى ذو النزعة المنخفضة إلى تجنّب الجدال، ويشعر بالارتياح كلما ابتعد عنه، لا سيما إذا كان الجدل محتدمًا أو قاسيًا. وإذا اضطرّ للدخول فيه، فقد يشعر بالانزعاج قبل وأثناء وبعد ذلك.
وتُعَدّ الرغبة في الجدل – من حيث المبدأ – سِمةً إيجابية وبنّاءة، فهي أداة فعّالة في التواصل مع الآخرين أو معارضتهم. فكلمة “يُجادل” تعني أن يسعى الفرد إلى بناء مزيج من الأفكار العقلانية والمنطقية المتّسقة، يُبرّر من خلالها رأيه أو موقفه. وهذا التبرير – مهما بلغت قوته أو ضعفه – يمكن أن يساعد على الإقناع، أو على نقض آراء الخصم أو تهميشها.
ومع ذلك، قد يحمل الجدل طابعًا سلبيًّا، خصوصًا حين يتحوّل إلى هجومٍ شخصي على الآخر. فالجدل اللفظي العدواني أو البذيء هو صورة مدمِّرة من صور التواصل. وقد ميّز الباحثون بين نمطين من الجدل: الجدل الإيجابي الخلّاق، والجدل القائم على التهجّم والمغالطة، الذي يستهدف الأشخاص لا الأفكار. فهناك دافعان متباينان لدى الأفراد المتحاورين: الأول هو الرغبة في مناقشة قضية خلافية، شخصية كانت أم عامة، والثاني هو الرغبة في التقليل من شأن الآخر واحتقاره وانتهاك كرامته.
أصحاب الدافع الأول يركّزون على جوهر الفكرة المطروحة، أما أصحاب الدافع الثاني، فينصرفون إلى استفزاز الطرف الآخر وتحطيم معنوياته عبر التهكّم والسخرية والازدراء. وهؤلاء لا يسعون إلى الحقيقة، بل إلى الهيمنة النفسية وتحقير الخصم. وبئسَ هؤلاء في ميزان الفكر والأخلاق.
عماد خالد رحمة ـ برلين