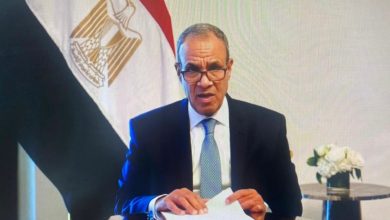قراءة هيرمينوطيقية ونفسية رمزية في قصيدة عز الدين المناصرة بقلم عماد خالد رحمة
(وكان الصيف موعدنا):

أولاً: المدخل التأويلي (المنهج الهيرمينوطيقي).
الهيرمينوطيقا تفترض أن النص الأدبي هو كيان حي، لا يكشف معناه من القراءة السطحية، بل من الدخول في جدلية الفهم بين ذات القارئ وأفق النص.
في هذه القصيدة، يقدّم عز الدين المناصرة الصيف بوصفه رمزاً للقاء الموعود، لكنه يتفتت أمام واقع الغربة والفقد. “الصيف” هنا ليس مجرد فصل زمني، بل إطار زمني-عاطفي مشحون بدلالات اللقاء والصفاء، يقابله “الغربة السوداء” بوصفها نقيضاً للدفء والنور.
“وكان الصيف موعدنا”: افتتاحية تنطوي على يقين سابق أو عهد مضى، لكنه تحوّل إلى ذكرى. هذه الجملة تتكرر في النص لتشكل بؤرة دلالية تحيط بها الصور والمشاعر.
الغربة السوداء: استخدام اللون الأسود هنا لا يصف فقط شعوراً، بل يخلق “أفق تأويلي” يوحي بالعزلة الروحية وغياب الأمل، وكأن الشاعر يقيم مقابلة بين حرارة الصيف وبرودة المنفى.
النص، من منظور تأويلي، يتحرك بين قطبين: وعد اللقاء وخذلان الزمن، في حركة دائرية تبدأ بـ”الموعد” وتنتهي بمروره وانقضائه، مما يوحي بانكسار الأمل وبقاء الجرح مفتوحاً.
— ثانياً: التحليل الأسلوبي
1. البنية الإيقاعية.
النص كٌتِبَ بلغة الشعر الحر، لكن يلتزم بتكرار لازمة “مرّ الصيف، كان الصيف موعدنا” لتوليد إيقاع دائري يوحي بدوران الزمن بلا تغير حقيقي في المصير.
وجود الجمل القصيرة المتقطعة (“أنا منهم…”) يمنح النص توتراً إيقاعياً يعكس انفعال الشاعر الداخلي.
2. الصورة الشعرية.
التشبيه الحسي-الوجداني: “كأنكِ مهرة ترعى بقاع الواد”، “كأنكِ شمعة الأعياد”؛ هذه التشبيهات لا تكتفي بالبعد البصري، بل تحمل شحنة عاطفية عالية، تربط الحبيبة بالحرية والجمال والدفء.
التضاد اللوني والزمني: بين “الغربة السوداء” و”الصيف الصاحي” تتجلى جدلية النور والظلام، الحياة والموت، الحضور والغياب.
الاستعارة النفسية: “حليب الشوق في الأثداء” تعبير يجسد الشوق كغذاء جوهري، لكنه أيضاً يربطه بالأمومة، ما يضفي عليه بعداً وجودياً.
3. البنية الحِجاجية.
النص ليس فقط تفريغاً للعاطفة، بل خطاب موجه للحبيبة، يحاول إقناعها أو تذكيرها بما كان، وبما تعنيه عودتها، وكأن الشاعر يخوض معركة ضد النسيان.
— ثالثاً: التحليل النفسي الرمزي.
من منظور التحليل النفسي الرمزي، النص يتعامل مع الحبيبة بوصفها تجسيداً للوطن، حتى وإن بدت في ظاهر النص امرأة حقيقية:
_ الصيف = زمن العودة أو الحلم السياسي بالتحرر.
_ الحبيبة = الوطن الأم، أو حالة البراءة الأولى قبل النفي والمنفى.
الغربة السوداء = المنفى الجسدي والنفسي، والشعور بالنبذ من الجماعة (“أن الكل يجحدنا”).
رمز “المهرة” يشير إلى الحرية المفقودة، بينما “شمعة الأعياد” تحيل إلى النور المؤقت الذي يشتعل في المناسبات ثم ينطفئ، أي أن اللقاءات أو الأحلام الوطنية كانت ومضات عابرة.
تكرار الاعتراف: “هجرت شعري وفني” يكشف عن إحساس بالعجز أو التضحية القسرية، وكأن الشاعر تخلى عن ذاته الإبداعية لأجل الحلم الأكبر الذي لم يتحقق.
القصيدة تنتهي بنفس العبارة التي بدأت بها، مما يخلق “دائرة مغلقة” تمثل الزمن النفسي للمنفي: الحاضر لا يتقدم، بل يعيد نفسه في ذاكرة الفقد.
-رابعاً: البعد الفلسفي-التأويلي النهائي.
القصيدة في جوهرها نص عن الخذلان التاريخي بقدر ما هي نص عن الحب الشخصي. فهي ترسم مشهد اللقاء المؤجل الذي يتكرر وعده دون أن يتحقق، حيث “الصيف” هو استعارة عن اللحظة المثالية التي لا تأتي، و”الغربة السوداء” هي الوجود الحقيقي الذي يبتلع الأمل.
من هنا، نص عز الدين المناصرة يلتقي مع تقاليد شعر المنفى العربي (من أمل دنقل إلى محمود درويش) في جعل العلاقة العاطفية مرآة للعلاقة بالوطن، ولكنه يضيف بعداً شخصياً مكثفاً يجعل القارئ يتردد بين قراءتين: قراءة الحبيبة كأنثى، أو كوطن.
–الخريطة الرمزية والدلالية للقصيدة
الصورة أو المفردة الشعرية المعنى المباشر (الظاهر) المعنى الرمزي/النفسي المعنى السياسي/الوطني
الصيف فصل من السنة، زمن الدفء والنور زمن الصفاء واللقاء الموعود، لحظة الأمل المرحلة المنتظرة للتحرر أو العودة للوطن
الموعد لقاء متفق عليه تحقق الرغبة المؤجلة وعد التحرير أو الانتصار الذي لم يكتمل
الغربة السوداء اغتراب بعيد عن الوطن عزلة نفسية وروحية، شعور بالنبذ المنفى القسري، والخذلان من الجماعة أو السلطة
حليب الشوق في الأثداء صورة حسية للأمومة حاجة عاطفية أساسية، غذاء الروح ارتباط الوطن بصورة الأم الحنون التي تُشبع الانتماء
الحلوة العينين الحبيبة الموصوفة رمز الجمال والطمأنينة الوطن كملاذ بصري ووجداني
المهرة في بقاع الواد أنثى حصان ترعى حرية وانطلاق وبراءة الوطن كأرض خصبة وحرة
شمعة الأعياد ضوء احتفالي مؤقت دفء مؤقت وسط ظلام طويل انتصارات أو لحظات وطنية قصيرة الأجل
هجرت شعري وفني توقف عن الإبداع تضحية بالذات من أجل هدف أسمى ترك النشاط الفردي لخدمة القضية الوطنية
أفعى تلسع الأجساد أفعى سامة خطر دائم، ألم مباغت الاحتلال أو القمع السياسي
جيوش الشوق فيض الحنين قوة دافعة لا تهدأ طاقة المقاومة والإصرار على العودة
بابك باب الحبيبة منفذ إلى الأمان أبواب الوطن المغلقة أمام المنفيين
قسوة الزمن صعوبات الحياة إحساس بالعجز أمام قدر لا يرحم خذلان التاريخ أو فشل المشروع التحرري
الوادي/الروابي أماكن طبيعية فضاءات الحلم الأرض الفلسطينية أو العربية بوصفها مكان اللقاء
_ ملاحظات على الخريطة:
كثير من الرموز في النص ثنائية المعنى، تعمل على مستوى الحب الشخصي وعلى مستوى الانتماء الوطني.
العلاقة بين الحبيبة والوطن في النص ليست مباشرة (لم يصرّح الشاعر أن الحبيبة = الوطن) لكنها علاقة إسقاطية، أي أن الشاعر يحمّل الحبيبة مشاعر موجهة أصلاً للوطن.
تكرار عبارة “مرّ الصيف” في بداية وختام النص يخلق رمزاً دائرياً لفقدان الأمل، حيث يظل الموعد مع الوطن أو الحبيبة مؤجلاً.
نص القصيدة
“وكان الصيفُ مَوْعِدَنا
وكانت ﻓﻲ عيونك بسمةٌ تجلو
همومَ الغربة السوداء
حليبُ الشوق ﻓﻲ الأثداء
ﺇﻟﻰ عينيك يدفعنا
ألا يا حلوة العينينِ،
لو تدرينَ،
أن الكُلَّ يجحدنا
وأن الغربة السوداء ، قد أدْمَتْ سواعدنا
ومرَّ الصيفُ، مرَّ الصيفُ، كان الصيف موعدنا !!!
وأنتِ وأنتِ تبتئسين لو مرَّتْ
نسائمُ صيفكِ الصاحي
وأُسمعتِ الغناء الحلو من عصفور تفّاحي
يغنّي جرح من رحلوا
أنا منهم … ﻭﻓﻲ الساحات أفعى تلسع الأجسادْ
أنا منهم … كأنّكِ مُهْرةٌ ترعى بقاع الواد.
كأنَّكِ شِبْهُ نائمةٍ، بلا وَتَرٍ، ولا أعوادْ
كأنَّكِ قد نسيتِ زنابقَ الذكرى،
كأنَّكِ شمعةُ الأعيادِ
لو تعلمين بأنّي
هجرتُ شعري وفَنّي
وتهتُ بين الشعابِ
على سفوح الروابي
أَحُثُّ خطوي سريعاً
لخطوكِ المطمئنِّ
لو تعلمين بأني
هجرتُ شعري وفنّي.
جيوشُ الشوق … ما مرَّتْ … وأحبابكْ
مضت سنتان … ما دقّوا على بابكْ
ومن يدري
أيرجع عطفك الغامر
وتستمعين للشاعر
أقص عليك ما لاقيته من قسوة الزمنِ
وعن شوقي ﺇﻟﻰ وطني
ومرّ الصيفُ،
مرّ الصيفُ،
كان الصيف موعدنا !!!”