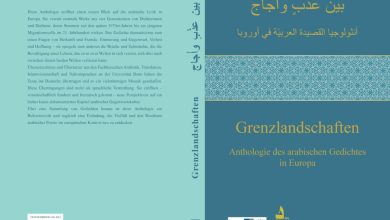“للتو فقط عرفت اسمي” لجيهان الشهابي.. رحلة الشعر والوعي في نصوص جيهان الشهابي

عمّان-متابعة أوبرا مصر
تنتمي نصوص “للتو فقط عرفت اسمي” لجيهان الشهابي إلى ما يمكن أن نطلق عليه “النثر الشعري” الذي يتكئ على الرمز والإيحاء ويرتكز بشكل أساسي على النهل من بئر الذات وتيارات الحساسية الجديدة، حيث يُعاد تشكيل العالم من منظور داخلي/ شخصي، يدور حول محور العاطفة وتتحول عبره الأسئلة الذاتية الخاصة إلى فعل وجودي عميق وموقف من العالم المحيط.
ومنذ النص الأول في المجموعة الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن (2025)، يطالعنا نص “رويدك”، وفيه تبني الكاتبة صوتها الشعري المنفرد والواعي، إذ تخرج من شرنقة التبعية نحو نوافذ الذات: “رويدكَ أيها العمر، فأنا للتوِّ عرفتُ اسمي.. للتوِّ فقط أدركتُ كم هو جميل!، تعرفتُ على صوتي منذ قليل، رسمتُ وجهي ولم أجد له من الشبه أربعين، أبصرتُ نجمًا حين افترش الهدب والْتَحف المنى، لما تبلل حين الدمعُ همى ما راودته الأطيافُ عن قمرهِ، ولا غرر الوهمُ بحلمهِ، ما استوحش في فيافي الليل الطويل.. أحببتُني طفلةً في الصف، تتلاقفُ الأرقامَ أصابعُها، تتراقص الحروف على لسانها، تُنقِّل الترقيم على شفتيْها.. تراوغُ التشكيل”.
يمثل الحوار العميق مع الذات عند الشهابي هنا تجسيداً للحظات انبثاق وتجدد “وعي بالوجود”، أشبه بلحظة إداراك فارقة للأنا (أنا أُسمّي نفسي إذا أنا موجودة)، وصحوة متأخرة لا تحمل معنى الندم بل على العكس من ذلك تحتفي بالدهشة والجمال؛ أنا أرى، أحب، وأتشكل من جديد.
هذا الاحتفاء بالذات يتحول في نصوص أخرى إلى مواجهة مع الآخر الذي يريد استلابها، يتجلى ذلك في نص “ولادة”، حيث يتجه الخطاب لذلك الغائب، ربما يكون حبيباً، أو ذكرى، أو حتى ذات قديمة تخلع عنها الكاتبة عباءة الصمت والخضوع، لتدخل في فعل “الولادة” الوجودي، وكما في جميع النصوص، تتقد اللغة بانفعالات حارقة، لكنها في ذات الوقت تبني شعريتها على المجاز والتكثيف الموحي، والكاتبة تبدو هنا صاحبة قاموس ثري بالثنائيات: الألم/الأمل، الهدوء/الثورة، الحضور/الغياب، في نوع من التوتر الفني الذي يمنح النص بعديه؛ الجمالي والفلسفي: “ها هي الحياة تخلع عنها رمادية حضورك، وتذيقك بعضًا من قسوة برودك فتُلبسك شيئًا من صنع يدك..، تنزع أشواكك ورماحك.. تنزعك..، تنزع منها وجودك برمته.. يا للنزف! يا للنزف!، اندمل الجرح بعدما لفظك والتأم القلب الذي رماك”.
وفي نص “التحام” تتجلى الرمزية الوجودية بشكل واضح، حيث تفتتح الكاتبة نصها بمشهد صباحي فيه هديل حمام وزقزقات، لكنه لا يلبث أن ينقلب إلى حرب داخلية/ روحية. يقدم النص صراعاً بين العناصر الخارجية من ماء ونوارس وزرقة.. وبين الداخل المتقلّب ليتشكل من كل ذلك لوحة يمكن القول إنها “بانورامية” للذات/ الكاتبة/ الساردة التي لم تعد معنية بالبحث في الخارج، بل أصبحت هي نفسها ساحة للمعركة، وهنا تتحول مفردات مثل البحر والسماء والليل.. من عناصر طبيعية إلى دلالات شعورية تترك مكانها الخارجي وتتجول في الداخل: “يأتي الصباح وهديل الحمام يلاعب أطراف الشبابيك، والزقزقات تُبشر بفرح وشيك، تبتلُّ أقدامي بمدٍّ بارد يتغلغل في لهيب الرمال، ويتراءى لي توتر النوارس يغزو السماء، كأشرعة بيضاء روَّضت الريح وعاشت في ارتحال، وها هو قلمي يُرَصُّ على ورقة خجلى فتبوح، وأناملي تمر على شفاه واجمة فتقو، ها هي أنفاسي تمسح على وجنة شاحبة فتتورد وتفوح، وها هي الزرقة تطوي السواد، وينطق النهار بأبجديته بكل وضوح، وأطوف حول نفسي، أطوف..، عمَّ أبحث والبحر والسما، والنوارس والمراكب والمدى، والليل والنهار، والوجوم والبوح والكبح والجموح، كلها في أعماقي تصول وتجول”.
ويتعمق ذلك الصراع في النصوص الأخرى ومنها “سكوت” حيث تحاول الشهابي القبض على “الفراغ”، أي “اللاشيء”، وعلى تلك المساحات الرمادية التي تتفلت من بين يدي اللغة ويصعب الإمساك بها، فهناك نقطة لم تُكتب، وكلمة لم تُقال، وشعور لم يُفصح عنه.. وإذ ذاك فإن السكوت يتحول إلى قوة، ويخرج من كونه علامة ضعف وتخاذل إلى حالة من الفاعلية والتأثير، ويصبح الصمت لغة أقوى من الكلام: “والنقطة التي ما خُطَّت في آخر الكلام ستبقى تدور في سماء وسماء، تاهت عن السطر وخرجت عن مضمون الحوار، تدمع مرة وتنهمر مرة، تلمع نجمةً ليلة، أو تغمَض عينًا أطفأها البكاء.. تتأرجح الأمواج بين مدٍّ وجزر، يُثقَل بالزبد كاهل الرمال.. أي ربيع وأي نيسان إن تردَّدت خُطى آذار؟! وأي شعور يسكن القلب، حين تختنق في سكوتك أنفاس البيان؟!”.
وأخيراً، تمثل نصوص “للتو فقط عرفت اسمي” رحلة تنطلق من الذات إلى الخارج، وتحاول تفكيك علاقتها المتشابكة مع العالم ومع اللغة.. وتتميز المجموعة بالبصمة الخاصة لجهة النبرة الحساسة واللغة الشفافة والحفاظ على دهشة السؤال وعمق الخيوط بين الحلم والواقع.
وقد قدم للكتاب د.علي الشوابكة الذي رأى أنه: “عمل أدبيّ يتوسّل النثر الشاعريّ واللغة العابقة بالبوح الذاتي والتأمّل الوجداني، في ما يتعالق مع الذات من وجود وهُويّة وانتماء وحبّ؛ إذْ تنتمي نصوصه إلى أدب الذات حيث يلتقي الوجدانيّ بالمجرّد”، مشيراً إلى أن العنوان كان عتبةً مكثَّفة الدلالة؛ ليعبّر عن لحظة إدراك عميقة للذات وتحوّلاتها، وتتمثّل هذه اللحظة باكتشاف الاسم الذي يُعَدُّ رمزًا للكينونة بعد رحلة المؤلِّفة مع الاغتراب والقلق المشروع للإنتاج الإبداعي.
ويقول الشوابكة: “لقد تجاوزت الكاتبة مساحات البوح العاطفي إلى تلك الفضاءات اللغوية والفكرية التي تتقاطع فيها الصورة، والتأمل، والمجاز، والتعبير الداخلي عن الذات، بطرق مفتوحة على التأويل؛ حيث تتجلّى المسافة الجمالية بوصفها شرطًا جوهريًّا في تفعيل أفق توقّع المتلقّي وفقَ ما جاء في نظرية التلقّي الحداثية”، مضيفاً: “وفي هذا السياق لا يُقاس نجاح النصوص بجودتها الفنية فحسب، بل بقدرتها على إشراك المتلقي في إنتاج المعنى من خلال (أفق التوقع) و”الفراغات النصية) التي يدفع النصُّ المتلقي لملئها. وهذه هي (المسافة الجمالية) التي تحددها نظرية (ياوس) بوصفها التباعد بين ما يتوقعه القارئ بناءً على تجاربه القرائية السابقة، وما يقدمه النص من بناءات لغوية وجمالية تُفاجئ هذا التوقع وتخلخله”.
ويؤكد د.علي: “مَنْ يتفيّأُ ظلال هذه النصوص الأدبيّة هنا لا يتلقّى الإفصاح المباشر بقدر ما يجد نفسه متورِّطا في تجرِبة حسيّة رمزية، يتنقل فيها بين ضفاف الصورة الشاعرية، وانفلات المعنى، واستبطان الشعور، ممّا يضفي على هذه النصوص الطابع الفني والمباعدة بينها وبين البوح التقريري أو النثر الخطابي؛ ما من شأنه أنْ يمثّلَ تجليات المسافة الجمالية لكونها تشكّلُ البعد الفاصل بين التجربة الذاتية واللغة التي اعتمدتها الكاتبة وعاءً لهذه التجربة”.