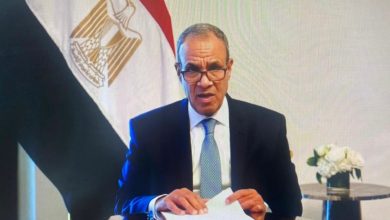أحمد حلمي يكتب رجل الفودكا.. رواية التيه الإنساني بين الاغتراب والتكرار

تأتي رواية “رجل الفودكا” للكاتب أحمد الشريف ضمن موجة الروايات التي تنشغل بتجربة المنفى العربي في أوروبا، غير أنها تذهب أبعد من الحكاية السياسية أو الاجتماعية المباشرة لتلامس سؤال الإنسان المخلوع من جذوره، الذي لا يجد لنفسه مكانًا في أي جغرافيا، سواء في وطنه القديم أو في البلاد الباردة التي لجأ إليها بحثًا عن الأمان.
لكن الشريف لا يقدّم هذا الاغتراب بوصفه أزمة وطنية فقط، بل كجرح وجودي شامل، يجعل من بطل الرواية – اللاجئ العراقي تايه – نموذجًا لإنسان العصر الذي فقد صلته بذاته وبالعالم في آن واحد.
يبني الكاتب عالمه داخل مدينة نرويجية قاسية المناخ والمزاج.
هنا يعيش تايه متنقلاً بين وظائف متقطعة وغرف ضيقة وأصدقاء يشبهونه في الغربة والضياع.
يبدو كمن يعيش داخل دائرة من الخواء، لا يجد فيها عزاءً سوى زجاجة الفودكا التي تمنحه وهم الحياة. لكن هذا الوهم سرعان ما يتحول إلى إدمان حقيقي، يجعل الخمر بديلاً عن كل المعاني الأخرى: الوطن، الحب، الأمان، والذاكرة.
من خلال شخصية تايه يرسم الشريف صورة دقيقة للاغتراب الإنساني في صورته الحديثة: الإنسان الذي لم يعد يعرف لمن ينتمي أو لماذا يعيش.
ومع أن الرواية تتحرك في فضاء المنفى، فإنها تبتعد عن السياسة المباشرة، وتنشغل أكثر بمتابعة تفتت الذات المهاجرة أمام البيروقراطيات الأوروبية، وصراعها بين الرغبة في الاندماج والحاجة إلى التمسك ببقايا الهوية القديمة.
يُحسب للكاتب أنه اختار لغة بسيطة ومتماسكة، تقترب من الشفافية اليومية دون أن تقع في الابتذال.
الجمل قصيرة، متلاحقة، تشبه أنفاس البطل المتعبة أو شرارات وعيه المتقطع بين السكر والصحو.
تُظهر الرواية قدرة على التقاط التفاصيل الصغيرة التي تصنع الوجود اليومي: رائحة الشقة، ملمس الثلج، صمت المقاهي النرويجية، وبرودة النظرات في مكاتب العمل.
هذه اللغة الواقعية الهادئة تمنح السرد صدقًا وجاذبية، وتسمح للقارئ بالدخول إلى عالم تايه الداخلي من دون حواجز بلاغية أو استعراض لغوي.
ومع ذلك، فإن هذا الخيار الأسلوبي الذي يمنح النص طاقته الأولى هو نفسه الذي يحدّ من عمقه أحيانًا.
فاللغة، ببساطتها الشديدة، تميل إلى المباشرة الإخبارية في مواضع كثيرة، خصوصًا حين يشرح الكاتب دوافع الشخصية أو تاريخها المؤلم بدلاً من أن يجعل القارئ يكتشفها عبر الفعل والمشهد.
فيتحول السرد من تصوير حي إلى تلخيص، ومن تجربة إلى تقرير.
إنها لغة صادقة لكنها لا تحتمل دومًا الصمت الضروري بين الجمل، ذلك الصمت الذي يُنشئ المعنى كما تُنشئه الكلمات.
من ناحية البناء، تبدو الرواية أقرب إلى سيرة متقطعة منها إلى رواية ذات حبكة متماسكة.
الأحداث لا تتطور بقدر ما تتكرر في أنماط متشابهة: جلسات الشراب، الذكريات، محاولات التواصل مع الآخرين، ثم العودة إلى الوحدة.
هذا التكرار يخدم المعنى الوجودي للنص – أي الدوران داخل دوامة اللاجدوى – لكنه يُفقد الرواية أحيانًا حسّ الحركة، فيغدو القارئ كمن يرافق الشخصية في مكان واحد لا يتغير.
ربما قصد الكاتب أن يعكس في شكل السرد إحساس البطل بالركود، لكن الإفراط في الدائرية جعل الزمن الروائي ساكنًا أكثر من اللازم.
كان يمكن لهذا التكرار أن يصبح أكثر تأثيرًا لو أنه يحمل في كل دورة كشفًا جديدًا عن الشخصية أو تحولاً في علاقتها بذاتها، بدلاً من أن يبقى على مستوى الوعي نفسه تقريبًا من البداية حتى النهاية.
رغم هذا الخلل البنائي، تظل الرواية مشحونة بصدق شعوري لافت.
فالشريف لا يكتب عن المنفى من الخارج، بل من داخله، بنبرة من يعرف وجع العزلة وارتباك الهوية.
ولعلّ هذا الصدق هو ما يجعل القارئ يتجاوز هنّات التركيب ومباشرة السرد، ليجد نفسه أمام نصّ إنساني عارٍ من التجميل، يقول أشياء بسيطة لكنها تمسّ جوهر التجربة البشرية: الخوف، الندم، والحنين إلى الأمان الأول.
وفي هذا المعنى، لا تقدّم “رجل الفودكا” قصة بطل واحد، بل حكاية جيل كامل من المنفيين، أولئك الذين غادروا بلدانهم هربًا من الرعب، ليكتشفوا في أوروبا نوعًا آخر من الفراغ، أقل عنفًا لكنه أكثر برودة.
الفودكا في الرواية ليست مجرد مشروب، بل استعارة مركزية تختصر فلسفة النص.
إنها رمز لآلية الإنسان في مواجهة العالم حين يعجز عن احتماله: جرعة من النسيان تكفي لمواصلة العيش.
الفودكا، إذن، ليست هروبًا من الوعي فقط، بل وسيلة للنجاة المؤقتة.
كل كأس في النص تعادل لحظة صدق أو رغبة في التراجع عن الحياة.
بهذا المعنى، تتحول الرواية إلى تأمل في علاقة الإنسان بالخدر كحيلة للبقاء، تمامًا كما استخدم كامو مفهوم العبث ليشرح تمسك الإنسان بالحياة رغم لا جدواها.
تحضر المرأة في الرواية بعدة وجوه: الزوجة النرويجية، العاشقات العابر، والابنة الصغيرة.
جميعهنّ يعكسن جانبًا من الانكسار الداخلي للبطل، أو ربما من عجزه عن التواصل الحقيقي.
الزوجة تمثل جدار الثقافة الغربية الباردة، والعشيقات رمز للعلاقة المقطوعة مع الجسد والآخر، أما الطفلة فهي الحنين المصفّى، الأمل الأخير الذي يبقي على إنسانيته.
وعلى الرغم من أن الكاتب لا يمنح هذه الشخصيات عمقًا كافيًا لتصبح كيانات مستقلة، إلا أنها تضيء وجهًا من وجوه المنفى: غياب المرأة كبيت رمزي، وكأم ثانية، وكمعادل للحياة المستقرة.
في عمقها، ليست رجل الفودكا رواية سياسية أو اجتماعية بقدر ما هي تأمل في معنى البقاء وسط العدم.
إنها تسأل: كيف يمكن للإنسان أن يواصل الحياة بعدما فقد كل ما يجعله إنسانًا؟
وهذا السؤال الوجودي هو ما يمنح النص ثقله الحقيقي، ويخرجه من ضيق الواقعية التسجيلية إلى رحابة الأدب الفلسفي الإنساني.
لكن الشريف لا يعمّق هذا البعد فلسفيًا بما يكفي، إذ يظل أسرى التجربة الفردية دون أن يوسعها إلى رؤية فكرية أكثر وضوحًا، ما يجعل الرواية تكتفي بالتعبير لا بالتأمل.
في نهاية المطاف، يمكن القول إن “رجل الفودكا” عمل يوازن بين الصدق والعطب، بين الجمال والارتباك.
هي رواية كتبت بقلب حيّ أكثر مما كتبت بعقل هندسي.
تكمن قوتها في إحساسها الإنساني الصافي، في لغتها التي تقترب من النفس دون حواجز، وفي قدرتها على نقل وجع الاغتراب من دون خطابة.
لكنها في الوقت نفسه تعاني من ميل إلى التكرار وبعض المباشرة على حساب التوتر الدرامي والإيحاء الجمالي.
ومع ذلك، فإن أثرها يبقى بعد القراءة طويلاً، لأنها لا تقدم حكاية تُروى، بل حالة تُعاش — حالة إنسان يبحث عن معنى الحياة في كأس، ثم يكتشف أن الكأس مرآة لروحه وحدها.