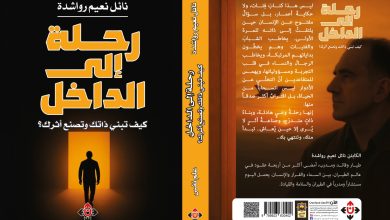أحمد رجب شلتوت نقد وتفكيك الهيمنة الغربية: من إدوارد سعيد إلى قاسم الأسدي

لم يعد سؤال العلاقة بين الشرق والغرب مسألة صور ذهنية متبادلة أو سوء تمثيل ثقافي فحسب، بل تحوّل، مع تحولات العالم المعاصر، إلى سؤال سيادة ومعرفة وملكية وذاكرة. فمنذ أن زلزل إدوارد سعيد بنية الفكر الغربي بكتابه الشهير الاستشراق عام 1978، لم يعد ممكنًا قراءة الخطاب الغربي عن الشرق بوصفه خطابًا علميًا بريئًا أو توصيفًا محايدًا. لقد كشف سعيد أن الغرب لا يصف الشرق، بل يصنعه، وأن المعرفة حين تُنتَج داخل منظومة قوة، تصبح أداة هيمنة لا وسيلة فهم، والهيمنة نفسها لم تبقَ على صورتها القديمة. فالاستعمار العسكري الكلاسيكي تراجع، لكن أدوات السيطرة لم تختفِ، بل أعادت إنتاج نفسها بأشكال أكثر نعومة ودهاء: العولمة، المؤسسات الدولية، خطاب﴿ “التراث الإنساني”، وادعاءات الحماية والإنقاذ. في هذا السياق يبرز مشروع المفكر العراقي قاسم الأسدي بوصفه امتدادًا نقديًا لمشروع سعيد، لكنه في الوقت ذاته قفزة نوعية تنقل النقد من مستوى الخطاب والتمثيل إلى مستوى أكثر مادية وخطورة: مستوى اختطاف التاريخ ومصادرة الذاكرة.
الخطاب بوصفه سلطة
لا تكمن أهمية إدوارد سعيد فقط في نقده للاستشراق، بل تمتد إلى الطريقة التي أعاد بها تعريف العلاقة بين المعرفة والسلطة. فالاستشراق، كما بيّن، ليس مجرد حقل أكاديمي، بل منظومة خطابية متكاملة تشكّلت داخل السياق الاستعماري، وأسهمت في تثبيت صورة نمطية عن الشرق بوصفه “آخر” ثابت الصفات: ساكن، عاطفي، متخلف، بحاجة دائمة إلى وصاية خارجية. ميتعينا بأفكار ميشيل فوكو حول الخطاب، ليبرهن أن النصوص الأدبية والعلمية والفنية ليست انعكاسًا للواقع، بل أدوات لإنتاجه. هكذا تحولت كتابات فلوبير، ورينان، وغيرهما، من مجرد نصوص أدبية إلى لبنات في بناء رؤية استعمارية شاملة، تشرعن الهيمنة السياسية والعسكرية باسم المعرفة.
غير أن مشروع سعيد، رغم ثوريته، ظل مشدودًا إلى عالم النصوص والخطابات النخبوية. فقد كشف كيف يُمثَّل الشرق، لكنه لم يغُص طويلًا في كيفية نهبه ماديًا، أو في الآليات المؤسسية التي تتولى اليوم إدارة هذه الهيمنة باسم الإنسانية والعلم.
هنا تحديدًا يتقدم مشروع قاسم الأسدي خطوة أبعد. ففي كتبه، وفي صدارتها “عولمة الآثار واختطاف العراق”، لا ينشغل بكيف يكتب الغرب الشرق، بل بكيف يستلبه؟. يأخذ آثاره، تاريخه، ذاكرته المادية، ثم يعيد تقديمها داخل سرديات غربية تُفرغها من سياقها الوطني والإنساني الحقيقي، ويطوّر الأسدي مفهوم “الاستعمار الأثري” لوصف نمط جديد من الهيمنة، لا يعتمد على الجيوش، بل على البعثات العلمية، والمتاحف الكبرى، والمؤسسات الدولية. فحين تُنقل قطعة أثرية من موطنها، أو يُعاد تأويل موقع تاريخي خارج سياقه، لا يكون الأمر فعل حفظ، بل فعل نزع سيادة. وبالتالي يتحول خطاب “التراث الإنساني المشترك” من شعار أخلاقي إلى أداة سياسية. فالتراث، حين يصبح مشتركًا، يفقد أصحابه حق التصرف فيه، ويغدو ملكًا لمراكز القوة التي تحدد معناه، وتدير عرضه، وتتحكم في سرديته.
وإذا كان سعيد قد فضح الهيمنة في اللغة والتمثيل، فإن الأسدي يكشفها في المؤسسات. فهو يوسّع مفهوم الهيمنة ليشمل دور المنظمات الدولية، والبعثات الأثرية، ومشاريع الحماية التي تُفرض على دول منهكة بالحروب والعقوبات. هنا لا تعود السيطرة فعل قمع مباشر، بل عملية إدارية وقانونية تُمارَس باسم الخبرة والإنقاذ.
ويربط الأسدي، بذكاء لافت، بين نهب الآثار ونهب الموارد الطبيعية، واضعًا ما يمكن تسميته بـنظرية النفط والآثار. فكما جرى إخضاع الجغرافيا العراقية عبر النفط، جرى إخضاع تاريخها عبر الآثار. كلاهما جزء من عملية استعمارية واحدة، تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تستهدف الجوهر ذاته: السيطرة على الأرض والذاكرة معًا.
تحتل منظمة اليونسكو موقعًا مركزيًا في نقد قاسم الأسدي لآليات الهيمنة الثقافية المعاصرة، إذ ينظر إليها باعتبارها أحد أهم تجليات الاستعمار الناعم في عصر ما بعد الاحتلال العسكري المباشر. وهو لا يرفض فكرة حماية التراث من حيث المبدأ، لكنه يفكك الكيفية التي تحوّلت بها هذه الفكرة إلى أداة وصاية دولية، تُفرغ الدول، خصوصًا الضعيفة أو الخارجة من الحروب، من حقها السيادي في إدارة تاريخها وذاكرتها. ففي خطاب اليونسكو، يبدو التراث وكأنه ملك للبشرية جمعاء، وهو شعار أخلاقي جذاب في ظاهره، لكنه ينطوي علي مفارقة خطيرة، فحين يصبح التراث عالميًا، يفقد صفته الوطنية، ويتحوّل من عنصر سيادة إلى موضوع إدارة دولية. هكذا لا تعود الدولة المالكة للموقع الأثري صاحبة القرار الأول في تفسيره أو إدارته أو حتى حمايته، بل تصبح طرفًا خاضعًا لشروط ومعايير تُصاغ في مراكز القوة العالمية.
ويرى قاسم الأسدي أن إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي ليس بريئًا دائمًا، بل هو في جوهره عملية سياسية مقنّعة، تفرض أنماطًا محددة من الإدارة، وتفتح الباب أمام تدخل الخبراء الأجانب، والبعثات الدولية، والتمويل المشروط، بما يعيد إنتاج علاقة غير متكافئة بين الخبير الغربي والدولة المحلية التي تُعامل باعتبارها قاصرة معرفيًا أو إداريًا. في هذا السياق، تتحول اليونسكو من منظمة دعم إلى سلطة معيارية تحدد ما هو تراثي، وما هو مهدد، وكيف يجب أن يُروى تاريخ المكان.
والخطير أن هذا الخطاب يتجاهل السياقات السياسية التي تسببت أصلًا في تدمير التراث. فحين يُدرج موقع عراقي على لائحة الخطر، نادرًا ما يُشار بوضوح إلى الاحتلال أو العقوبات أو الحروب بوصفها أسبابًا بنيوية للتدمير. تُمحى الجريمة السياسية، ويُستبدل بها خطاب تقني محايد عن سوء الإدارة أو ضعف الإمكانات المحلية، وكأن المشكلة كامنة في أهل المكان لا في من دمّره.
وهذا ما يصفه الأسدي بوصفه نزعًا مزدوجًا للسيادة، نزع الحق في حماية التراث، ونزع الحق في تفسير أسباب تدميره،
ويمتد نقد الأسدي إلى البعد الرمزي، فحين تُقدَّم مواقع مثل أور وبابل والأهوار بوصفها “تراثًا إنسانيًا”، تُفصل عن تاريخها الوطني والنضالي، ويُعاد تأطيرها ضمن سردية كونية فضفاضة، تُفرغ المكان من ذاكرته السياسية والاجتماعية. فيصبح الموقع الأثري شاهدًا على مهد الحضارة، وليس على شعب معاصر ما زال يدفع ثمن الغزو. واللافت أن الأسدي لا يدعو إلى القطيعة مع اليونسكو، بل إلى إعادة تعريف العلاقة معها، على أساس سيادة معرفية وثقافية واضحة. فحماية التراث، في رؤيته، لا تنفصل عن حق الشعوب في امتلاك سرديتها، ولا يمكن أن تُمارَس من فوق، أو بمعزل عن السياق السياسي الذي أنتج الخطر نفسه. فكل حماية لا تعترف بالجريمة، تظل، في جوهرها، شكلًا آخر من أشكال إخفائها.
تطور النقد وتحوّل المعركة
ما بين إدوارد سعيد وقاسم الأسدي، لا نكون إزاء قطيعة، بل أمام تطور طبيعي لخطاب نقدي يلاحق تحولات الهيمنة نفسها. لقد انتقل النقد من تفكيك الصورة إلى تفكيك المصادرة، ومن تحليل النص إلى تحليل المتحف، ومن سؤال التمثيل إلى سؤال الملكية، وإذا كان إدوارد سعيد قد علّمنا كيف نقرأ الهيمنة في اللغة؟، فإن قاسم الأسدي يعلّمنا كيف نراها في المتحف، وفي الخريطة، لذا فالانتقال من الأول إلى الثاني يعتبر تطورا تاريخيا لخطاب نقدي يواكب تحولات الاستعمار نفسه، لقد تحوّل النقد، في هذا المسار، من تشخيص المرض إلى تسمية الجرح، ومن فضح الصورة إلى المطالبة باستعادة الحق.
وهكذا يمثل المسار الممتد من إدوارد سعيد إلى قاسم الأسدي تطورًا نوعيًا في الفكر النقدي العربي، من مرحلة التشخيص إلى مرحلة المواجهة. لم يعد النقد الثقافي ترفًا فكريًا، بل صار أداة دفاع عن الذاكرة والسيادة في عالم يعيد إنتاج الهيمنة بأقنعة جديدة، ففي زمن تُنهب فيه الآثار باسم الحماية، وتُصادَر الذاكرة باسم الإنسانية، يصبح تفكيك هذا الخطاب فعل مقاومة بحد ذاته. ومن هنا، لا يبدو مشروع قاسم الأسدي مجرد امتداد لمشروع سعيد، بل ضرورة فكرية تفرضها لحظة تاريخية بات فيها السؤال الثقافي ملتحمًا بالسؤال السياسي، والسؤال المعرفي ملتصقًا بسؤال الوجود.
الناقد المصري أحمد رجب شلتوت