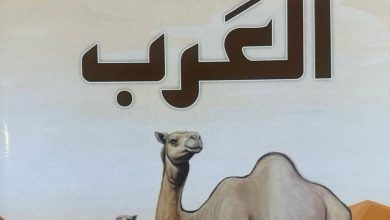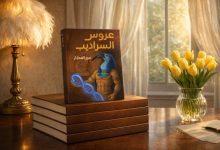قصيدة النثر والشعر الحر: بين تحولات الشكل وتجليات المعنى بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.

ظلّ الشعر العربي عبر تاريخه الطويل مقيّداً بأوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي، حتى مطلع القرن العشرين حيث ظهرت حركات تجديدية كسرت سلطة العمود الخليلي. انقسمت هذه الحركات إلى اتجاهين بارزين: الشعر الحر الذي حافظ على التفعيلة باعتبارها وحدة إيقاعية، وقصيدة النثر التي تخلّت عن الوزن برمّته لتؤسس أفقاً جديداً للقصيدة.
وقد انشغل النقاد العرب والغربيون على حد سواء بدراسة هذين الشكلين، وتحديد خصوصية كل منهما وحدود التماس بينهما.
—أولاً: الشعر الحر – تفعيلة الإيقاع بين الحرية والالتزام.
_ الشعر الحر (أو شعر التفعيلة): ارتبط في العالم العربي برواد مثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي. وقد رأى هؤلاء أن نظام الشطرين والبيت الشعري التقليدي لم يعد قادراً على التعبير عن التجربة الحديثة.
_ من الناحية الفنية:
الشعر الحر يقوم على تكرار التفعيلة (فاعلن، فعولن…) بشكل مرن، بحيث يمكن للشاعر أن يطيل أو يقصر السطر الشعري بحسب مقتضى التعبير. إنه يحقق حرية نسبية مع الحفاظ على “الذاكرة الإيقاعية” للشعر العربي.
_من الناحية النقدية:
ترى نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر أن الشعر الحر ليس ثورة ضد التراث، بل امتداد عضوي له، لأنه يستبقي الإيقاع الجوهري وإن غيّر شكله.
أما أدونيس، فرأى في الشعر الحر محاولة “لتحرير اللغة الشعرية من أسر العروض التقليدي، دون التفريط بموسيقى الكلمة الداخلية”.
فضائله:
_ 1. يتيح مساحة تعبيرية أكبر من العمود الشعري.
_ 2. يحافظ على موسيقى الشعر العربي بما يربطه بالمتلقي.
_ 3. يوفّق بين الأصالة (التفعيلة) والمعاصرة (حرية الشكل).
— ثانياً: قصيدة النثر – الشعر في أفق ما بعد الوزن.
قصيدة النثر وُلدت أولاً في فرنسا في القرن التاسع عشر مع بودلير ورامبو ومالارميه، ثم انتقلت إلى العالم العربي مع جماعة مجلة شعر (أنسي الحاج، شوقي أبي شقرا، محمد الماغوط…).
_ من الناحية الفنية:
قصيدة النثر لا تخضع لا لوزن ولا لتفعيلة. تعتمد بدلاً من ذلك على الإيقاع الداخلي المتولد من التكرار، المفارقة، الصورة، التوازي، الجملة الشعرية المكثفة. إنها قصيدة بلا “قافية” ولا “بحر”، لكنها تمتلك طاقتها الموسيقية الخاصة.
_ من الناحية النقدية:
_ جان كوهن يرى أن الشعر في جوهره ليس وزناً بل انزياح عن اللغة العادية.
_ أدونيس في زمن الشعر يؤكد أن قصيدة النثر ليست نثراً منثوراً، بل بناء شعري قائم على تكثيف اللغة وتحويلها إلى طاقة وجودية.
_ عبد الله الغذامي يصف قصيدة النثر بأنها “أقصى درجات الحداثة في الشعر العربي” لأنها قطعت مع التفعيلة والبيت معاً.
فضائلها:
1. تمنح الشاعر حرية مطلقة في تشكيل النص.
_ 2. تتيح اندماج الشعر بالفكر والفلسفة والسرد.
_ 3. تحقق انفتاحاً كونياً يجعل الشعر أكثر قرباً من روح العصر.
— ثالثاً: بين الشعر الحر وقصيدة النثر – مقاربة فلسفية ولسانية:
إذا كان الشعر الحر قد حافظ على خيط يربطه بالوزن التقليدي، فإن قصيدة النثر أعلنت القطيعة مع هذا التراث.
_ من زاوية فلسفية:
يرى هايدغر أن الشعر هو “لغة الوجود”، وبالتالي فإن الشكل الشعري يتحدد بقدرته على كشف الكينونة. الشعر الحر يحافظ على علاقة ما بالموسيقى الموروثة، بينما قصيدة النثر تفتح مجالاً لإيقاعات الوجود ذاتها خارج العروض.
_ من زاوية لسانية:
حسب جاكبسون، الشعر هو “تركيز على محور الاختيار في اللغة”. في الشعر الحر، يتم هذا التركيز عبر الإيقاع المنتظم نسبياً. أما في قصيدة النثر، فيُنجز عبر الصورة واللغة المكثفة والانسجام التركيبي.
— رابعاً: فضائل التوازي لا التضاد
ليس من الدقة النقدية وضع الشعر الحر وقصيدة النثر في موقع التضاد المطلق. فكلاهما مثّل محاولة لتجاوز قصور العمود الشعري عن التعبير عن الذات الحديثة:
_ الشعر الحر منح الشعر العربي جسراً آمناً نحو الحداثة مع الحفاظ على جذوره.
_ قصيدة النثر دفعت بالقصيدة إلى أقصى الحرية، وجعلت الشعر فضاءً كونيّاً غير مشروط.
كما يقول إدوارد سعيد: الحداثة ليست رفضاً للماضي، بل حوارٌ دائم معه. فالشعر الحر وقصيدة النثر يمثلان مرحلتين متكاملتين من هذا الحوار.
—خاتمة:
الشعر الحر وقصيدة النثر، على اختلافهما، ليسا سوى علامتين على تحولات الحساسية الشعرية العربية. الأول يوازن بين الذاكرة والحداثة، والثاني يغامر إلى أقصى حدود الحرية. وفي النهاية، فإن قيمة الشعر لا تُقاس بوزنه أو شكله، بل بقدرته على أن يكون كشفاً وجودياً ومعرفياً وجمالياً، كما عبّر هايدغر: الشعر إقامة للإنسان في الوجود.
_ 1. قصائد من الشعر الحر.
_ 2. قصائد من قصيدة النثر.
_ 3. دراسة تطبيقية تحليلية تجمع بين النصوص وتستخلص دلالاتها الفنية والرمزية والأسلوبية.
— الشعر الحر وقصيدة النثر: تجربة شعرية ودراسة تطبيقية
— أولاً: نصوص من الشعر الحر.
(1)_
على ضفافِ الغيابْ
كنتُ أفتِّشُ عن ظِلٍّ يَسندُني
فتعثّرتُ بأحلامي القديمة،
أحلامي التي ما زالتْ
ترتدي ثوبَ الطفولة،
وتضحكُ من خُطايَ المرتبكة.
(2)_
يا صديقي الذي غابَ في الجهات الأربع،
كيفَ أُخبرُكَ أنَّني أفتقدكَ
كلما اشتدّ بي صَقيعُ الوحدة؟
كيفَ أقولُ إنَّ رسائلَكَ القديمة
لا تزالُ تنبضُ في أدراجِ قلبي،
كأنها آخرُ ما تبقّى من صوتِكَ؟
–ثانياً: نصوص من قصيدة النثر.
(1)_
أنا الغريب الذي يزرعُ في الطرقاتِ أنفاسَه،
ويستيقظُ في كلِّ صباحٍ كأنَّهُ أوَّلُ مخلوقٍ على الأرض.
لا وطنَ لي سوى هذا الصمت،
ولا بيتَ لي سوى ما تبنيه الذكريات
من حجارةٍ رخوةٍ تتداعى كلما حاولتُ الاحتماء.
(2)_
الحبُّ مرآةٌ غامضة،
تريكَ ملامحَكَ كما لم تَعرفها،
تُريكَ كم أنتَ هشٌّ
وكم تستطيع أن تكونَ جبلاً
حين يداكَ تتشابكان مع يدٍ
عرفتْ طريقها إلى قلبك بلا استئذان.
—ثالثاً: الدراسة التطبيقية
1. البنية الأسلوبية:
_ في الشعر الحر (النصوص الأولى)، يظهر التقطيع الإيقاعي الحر، حيث تتوالى الصور وفق موسيقى داخلية قائمة على التكرار (مثل: كيفَ أُخبرُكَ / كيفَ أقولُ).
_ في قصيدة النثر (النصوص الثانية)، يغيب الوزن الخارجي لكن تحضر موسيقى الدلالات، حيث يعتمد الشاعر على التوازي الأسلوبي والتكثيف الصوري (مثل: لا وطن لي سوى هذا الصمت، ولا بيت لي سوى ما تبنيه الذكريات).
_ 2. الرمزية:
الغياب في الشعر الحر رمزٌ لفقدان السند الروحي، وتجسيدٌ للبحث عن الآخر في فضاءٍ قاسٍ.
_ في قصيدة النثر، الرمزية أكثر تجريداً: الغربة الوجودية، هشاشة الإنسان، الحب كمرآة تكشف الداخل.
_ 3. المنظور النفسي:
الشعر الحر يكشف عن حوار داخلي مع الآخر (الصديق، الغائب)، ما يعكس حاجة عاطفية إلى الامتلاء.
_ قصيدة النثر تركّز على الأنا الفردية، العزلة، والتأمل الوجودي، أي تعبير عن الذات المتفردة أكثر من ارتباطها بالآخر.
_ 4. البنية الهيرمينوطيقية (التأويل):
_ نصوص الشعر الحر تُؤوَّل كرحلة بحث عن المعنى من خلال الآخر، فالمحبوب أو الصديق يصبح مرآة للذات.
_ نصوص قصيدة النثر تُؤوَّل باعتبارها اعترافات وجودية: البحث عن بيت داخلي لا خارجي، وعن يقينٍ في عالمٍ هشّ.
— خاتمة:
يتكامل الشعر الحر وقصيدة النثر في كونهما فضاءين مختلفين للتعبير عن القلق الإنساني: الأول يسعى إلى ترميم علاقته بالآخرين عبر إيقاع متحرّر من العروض التقليدي، والثاني يحفر عميقاً في الذات العارية ليكشف هشاشتها وصلابتها في آن. كلاهما يعكس تحوّل الشعر العربي المعاصر من الغنائية التقليدية إلى فضاءات أرحب من التجريب والتعبير عن الإنسان في أبعاده النفسية والوجودية.