أ. د. نجيب أيوب يكتب شهرزادُ الحكيم حوارُ الظلِ
قراءةٌ ثقافيةٌ تبحثُ همومَ المرأة العربية، عبر مرايا توفيق الحكيم
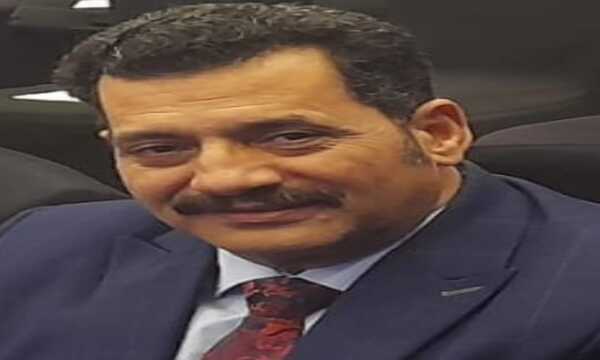
قبل الخوض والإبحار في عوالم الحكيم الفنية الذهنية المتأملة، لا بد للقارئ النابه أن يتعايش مع زخم المشهد الثقافي العربي المتعلقه بالمرأة وقضايا (الجندر) ودعاواه؛ حيث تتصاعد الأصوات بحثًا عن هوية المرأة ومكانتها في الواقع العربي المعاصر والمستقبل، وتتنوع هذه الأصوات حسب أهواء ثقافات وأيديولوجيات واتجاهات بل وأغراض سياسية واجتماعية متنازِعة.
تعود رواية (شهرزاد) كُتبت سنة 1934م للأديب المصري المُلهم ترفيق الحكيم، كمرآة عاكسة للمشهد الثقافي الجُنُوسي العربي، ولا تزال تشع ببصيرة نافذة في الوجدان الجمعي العربي حتى اللحظة. و(شهرزاد الحكيم) ليست مجرد إعادة صياغة لأسطورة شخصيتها في “ألف ليلة وليلة”، بل هي رحلة فلسفية عميقة تخترق اللاوعي الجمعي العربي لترصد هموم المرأة الجنوسية (الجندرية) بجرأة فكرية نادرة في زمان كتابتها.
وفي هذا المقال، سأحاول الحفر تحت سطح الحكاية لنستخرجَ تأملاتِ الحكيم الإبستمولوجية (المعرفيه) والسيكولوجية (النفسيه) حول علاقة المجتمع العربي كسلطة معرفيةٍ ثقافيًا، أو كسلطةٍ حاكمةٍ سياسيًا بالمرأة وقضاياها، وكيف تشكلت شخصية (شهرزاد) عند الحكيم في هذا الوقت المبكر، بعدها رمزًا للأنوثه المكبوتة والمتسائلة في آن واحد.
شهرزاد : (المعرفة/السلطة/والأنثى المحاصَرة)
1. شهرزاد كـ (إبستيمية) متحدية:
* تتحول شهرزاد عند الحكيم من أنثى رقيقة جذابة راوية حكايات التسلية لسيدها شهريار إلى (فيلسوفة وجودية) سؤالها المحوري “أين الحقيقة؟”
كان هذا التساؤل ليس بحثًا عن معلومة ما، بل هو هزَّة لأساسات المعرفة (الإبستمولوجيا) التي بنى عليها شهريار (رمز السلطة الأبوية المطلقة) عالمه الذكوري الأبوي.
* تمثل شهرزاد المعرفة الحَدْسية والتأملية، معرفة الروح والقلب والطبيعة الفطرية والتلقائية، في مواجهة معرفة شهريار العقلانية الجافة المقصودة والمنظمه، المستمدة من القوة والسيطرة، هذا الصراع يعكس إدراك الحكيم لاختزال المرأة في المجتمع العربي، وكيف تُنزَع عنها شرعية معرفتها الخاصة، التي لا تقل قيمة ولا أهمية ولا خطورة عن معرفة الرجل العقلانية.
2. سيكولوجيا العزلة والاغتراب الأنثوي:
* رسم الحكيم صورةً نفسيةً دقيقة لـ (عُزلة المرأة الفكرية والروحية) حينما وضع شهرزاد محاصَرة في قصر شهريار، ليس جسديًا فحسب، بل في إطار التصوير الذكوري لها: فحكمتُها لا تُفهم، فضولُها المعرفي يُعد تهديدًا.
* معاناة شهرزاد من الاغتراب النسوي– عن ذاتها (بسؤالها عن حقيقتها)، وعن العالم (بحبسها)، وعن حقيقة شهريار (بعدم فهمه لها) – لهي تجسيد لاغتراب المرأة العربيه، في مجتمع يفرض عليها أدوارًا محددة تتلخص في كونها (موضعا للمتعة ومثيرا للنزوة، ومجلبًا للعار) وبذا يصم المجتمع الباترياركي (الابوي) آذانه عن صوتها الداخلي.
لقد عزلها الحكيم في قصر شهريار؛ لتكون الرمز الذي يريد الإفصاح عنه والمُعَبِّر عن الحَيِّز المحدود الذي تُحشر فيه المرأة في عالم الذكر وسلطاته المعرفية.
3. المرأة كـ “أسطورة” وليس كـ “واقع”:
* جعل الحكيم من شهريار شخصية ترى في شهرزاد الآتي:
أن المرأة-الأسطورة: المخلوق السحري الغامض (مثل زنوبيا)، لا المرأة الإنسانة العادية، وهذا التجريد الأسطوري – رغم إعجاب شهريار به- هو شكل من أشكال (الإنكار) لواقعها الإنساني المعقد، بمشاعره وضعفه وحاجاته، عكس الحكيم بذلك نظرة مجتمعية، ترفع المرأة إلى مرتبة القداسة أو الأم المثالية من جهة أو العاهرة من جهات أخرى، لتسلبها إنسانيتها البسيطة وحقها في الخطأ والصواب الذي يضمن مشاركتها التنوع الواقع فعليا على الساحة المجتمعية.
4. صراع اللغة والسلطة:
* حكايات شهرزاد الأصلية كانت سلاحًا لغويًا للبقاء عند الحكيم، فالكلمة نفسها تصبح ساحة للصراع في سردية شهرزاد.
* كما أن محاولات شهرزاد التواصل الفلسفي مع شهريار تصطدم بجدار من عدم فهم لغتها أو رفضها. هذا يعكس صعوبة حوار لغوي حقيقي بين الذكوري والأنثوي في بنىً اجتماعيةٍ قائمةٍ على علاقات قوى غير متكافئة، حيث تُسكت المرأة أو يُستمع لها فقط وهذا الاستماع لها يكون على شروط الذكر وإملاءلته.
5. الحرية المطلوبة.. والممنوعة:
٠ رغبة شهرزاد الجامحة في (الحرية) – حرية الحركة خارج القصر، وحرية الفكر والتساؤل – هي لُبِ هموم المرأة الجندرية. الحكيم يطرح السؤال المحوري هنا:
هل يستطيع المجتمع العربي، ممثلًا بشهريار، أن يتسامح مع امرأة تطلب الحرية كحق أصيل لها، لا كمنحة من الذكر المهيمن؟
نهاية الرواية الغامضة تضفي تشاؤميةً مسيطرة على شخص الحكيم نفسه – من وجهة نظري كناقد- ف(هروب شهرزاد أو اختفاؤها) يُشير إلى استحالة تحقيق هذه الحرية الكاملة في ظل النظام الأبوي القائم آنذاك – وربما القائم بيننا حتى الساعة- مع إبقاء الباب مواربًا للأمل.
******
ونختتم كلامنا عن (شهرزاد الحكيم)
على أنها تمثل نموذجًا ثريًا للتحليل الثقافي/النفسي، للمعضلة الجندرية في المجتمع العربي.
من خلال عدسة إبستمولوجية، يكشف الحكيم بها عن:
* وجود (بنية معرفية أبوية) أبوستية قوية ومتمكنة تسيطرُ هذه البنية على التصورات الثقافية العامة، وتحدد ما هو مقبول من المعرفة والسلوك الأنثوي، وما هو غير مقبول م المرأة فعله.
* وشهرزاد برؤية ثقافيه.
ببحثها عن الحقيقة وتحديها للمطلق الذكوري (شهريار)، تجسد (المعرفة الأنثوية المهمشة) والرغبة في المشاركة في بناء المعنى.
* ومن منظور سيكولوجي، تعكس الرواية (الآليات النفسية العميقة) التي تنتجها هذه البنية: (عزلة المرأة) الفكرية والعاطفية، و(اغترابها) عن ذاتها ومحيطها، وتحويلها إلى (كيان أسطوري مجرد) ينفي واقعها الإنساني، من خلال صراع اللغة وعدم التواصل الفعال، اللذان يبرزان صعوبة الحوار في ظل اختلال موازين القوة بين عالم الرجل وعالم المرأة، وهما عنصرا الوجود الأنطولوجي للكينونة السيسيولوجية في البيئة العربية.
* لا تقدم “شهرزاد” حلولًا جاهزة، بل هي التشخيص الفلسفي العميق، لوضعية المرأة في المخيال والواقع الاجتماعي العربي.
* إنها دعوة ضمنية، لا تزال راهنة، لإعادة النظر في الأُسس المعرفية (الإبستمولوجية) التي تحكم العلاقة بين الجنسين في مجتمعاتنا بشكل طبيعي يرتكز على فطرة الله، ولخلق فضاء معرفي ونفسي تتحرر فيه المرأة من قصور التصورات الذكورية المتراكمة عبر تاريخ المنطقة الحاقل بالتجاوزات البشرية؛ لتكون ذاتًا فاعلة وكاملة، تبحث عن حقيقتها التي أرادها الله لها ودون قيود. ولتشارك في صياغة مصيرها ومصير مجتمعها على قدم المساواة مع الرجل، دون استلاب ثقافي يجرها نحو قيم الغرب التي داهمت مجتمعنا العربي تحت تأثير موجاته الكولونيالية (الاستعمارية) أو حبسها في تأويلات واجتهادات مغلوطة للتراث العربي الموروث، وغلقه عليها وفق طموحات الرجل المهيمنة، بدوافع ثقافية اجتماعية سياسية أيضا، تتغَيَّا استلابها والمزايدةَ بها في حلبة السياسة المشبوهة.
* فرؤية الحكيم إذن، تظل شهادةً أدبيةً وفلسفيةً فذةً تُجسد هموم المرأة، وستظل أيضًا نداءً صامتًا لتغيير يستوعب حكمتها ويطلق سراح حريتها، بعيدا عن ابتزازها واستلابها كمادة سياسية للمزايدة بها ثقافيا واجتماعيا وبالتالي سياسيا. *******
أ. د نجيب عثمان أيوب، كلية الآداب، جامعة حلوان.






