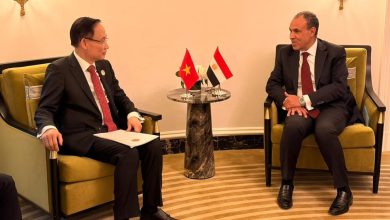بين النظم والشعر: من انتظام الوزن إلى انفجار الروح
في تمايز الإبداع عن الترصيع : بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.
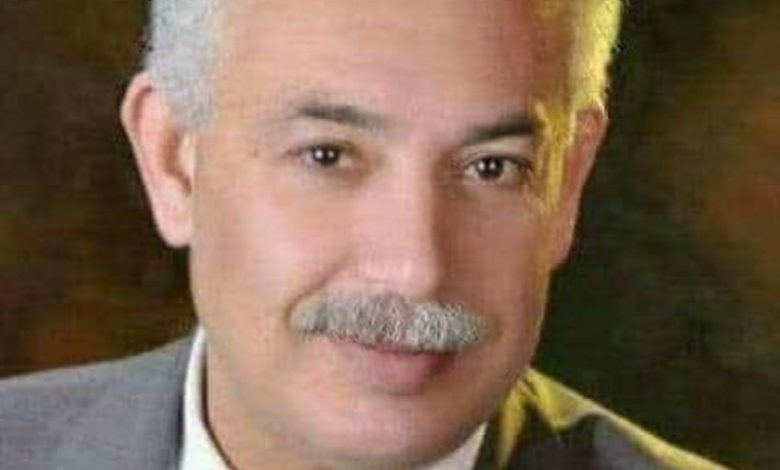
ليس كل من قال بيتاً بشاعر، كما أن ليس كل من نظم كلاماً موزوناً مقفى قد لامس جوهر الشعر. فالشعر، في حقيقته العميقة، ليس فناً لغوياً يُجيد تقنيات الإيقاع والبلاغة فحسب، بل هو وعيٌ جماليٌّ مشحونٌ بالوجدان، متجاوزٌ لحدود اللغة نحو الإشراق الداخلي للمعنى. أما النظم فهو فن الصناعة اللفظية المحكمة، التي قد تُبهر الأذن ولا تُحرّك القلب، وتُغري بالوزن دون أن تفتح نوافذ الوجدان.
أولاً: جوهر الفارق بين الناظم والشاعر.
يقول عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز»: “ليس النظم هو التأليف اللفظي فحسب، بل هو وضع الكلام موضعه على مقتضى الحال.” فالناظم عند الجرجاني قد يُحسن الصناعة، لكنه إن عجز عن النفاذ إلى الجوهر الشعوري للفكرة، صار شعره شكلاً بلا روح.
أما الشاعر فهو من يُحيل التجربة إلى كثافة وجدانية تنبض في كل بيت، فلا تكون لغته أداةً للقول بل كياناً قائلاً بذاته.
الناظمُ صانعُ إيقاعٍ خارجيٍّ؛ أمّا الشاعر فخالقُ نَفَسٍ داخليٍّ.
الناظم ينسج ألفاظاً تُرضي العروض، والشاعر يخلق صوراً تُربك المنطق وتُعيد تشكيل الوعي.
فالأول ينقل اللغة كما وجدها، والثاني يُعيد خلقها كما رآها بروحه.
ولذلك قال أبو نواس:
“الشعر شيءٌ غير ما قد علمتَهُ ** إذا لم يكن في القلبِ لم يُتَقبَّلِ.”
_ثانياً: الشعر كحدث روحي لا كصنعة لفظية.
الفرق بين النظم والشعر يشبه الفرق بين الزهرة الطبيعية وتلك المصنوعة من الحرير. كلاهما جميلٌ في العين، ولكن واحدةً فقط تفوح بعطرها. الشاعر هو الذي يمنح اللغة رائحة الحياة، والناظم هو من يصوغ شكلها دون روح.
يقول نيتشه في “مولد التراجيديا”: “الفن لا يولد من النظام، بل من الفيض، من العذاب والفرح معاً.” فالشاعر هو من يعيش انفعالاً وجودياً يُترجم بالوزن لا يتقيد به. بينما الناظم يفتّش عن القافية كما يفتّش الصانع عن المسطرة، في حين يفتّش الشاعر عن ذاته الضائعة بين المفردات.
انظر مثلاً إلى المتنبي، الذي يُعدّ مثالاً أعلى للشاعر الذي يحمل بصمته حيثما كُتبت أبياته. لو ضاعت قصيدته من الديوان وظهرت دون اسم، لقال القارئ: “هذه له.” لأن فيها صهيل ذاته وكبرياء روحه. يقول:
أنامُ مِلءَ جُفوني عن شوارِدِها
ويسهرُ الخلقُ جرّاها ويختصمُ
هذا البيت ليس بناءً عروضياً فحسب، بل كيان وجوديّ يعبّر عن رؤية المتنبي للعالم، عن إحساسه بالعظمة والوحدة، عن فلسفة الكبرياء والاختلاف.
أما الناظم، فمهما أجاد السبك، لا يُخلّف أثراً إلا بمقدار زخرف عبارته. ولذا قيل عن بعض المتأخرين إنهم “أجادوا الصنعة وأفسدوا الشعر.”
_ ثالثاً: روح الإبداع في مقابل آلة النظم.
الشاعر خالقٌ في حين أن الناظم مقلِّد. الشاعر يضيف إلى اللغة طاقة جديدة، بينما الناظم يعيد إنتاجها. وبهذا المعنى، يمكن أن نقرأ تمييز أدونيس حين قال: “الشعر ليس في الوزن بل في الانفجار الداخلي للمعنى.” فالناظم أسير الوزن، والشاعر سيده.
الشاعر يُنصت إلى صوته الداخلي قبل أن يكتب، بينما الناظم يُنصت إلى بحور الخليل ليُرضيها.
ولهذا السبب تشبه القصيدة النظمية دمية الذكاء الاصطناعي: تملك شكلاً بشرياً، لكنها بلا أنفاس.
في المقابل، لنقرأ من محمود درويش في قوله:
على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة
على هذه الأرض سيدةُ الأرض، أمّ البدايات… أمّ النهايات…
هنا تتجاوز اللغة معناها الظاهر إلى طاقة وجدانية وحضارية، إذ يتماهى اللفظ مع نَفَس الشاعر، وتتحوّل القصيدة إلى كينونة حيّة تتنفس فلسطين.
_ رابعاً: أثر السياق والذات في بناء الشعر.
النظم يكتفي بما يُقال، أما الشعر فيستمد شرعيته مما لا يُقال.
ففي قصيدة إيليا أبو ماضي “الطلاسم”، يطرح الشاعر أسئلة الوجود والعدم في نسيج من الغموض الميتافيزيقي:
جئتُ لا أعلمُ من أين، ولكنّي أتيتُ
ولقد أبصرتُ قدّامي طريقاً فمشيتُ
هنا لا نجد نظماً تعليمياً أو خطابياً، بل انفتاحاً على المجهول، وغموضاً مقصوداً هو روح الشعر ذاته.
في حين أن الناظم، لو عالج الفكرة ذاتها، لأقامها على منطقٍ خطابيٍّ يُفسد سحرها. فالناظم يشرح، والشاعر يُومئ.
_ خامساً: الشعر كهوية لغوية لا تُزَوّر.
القصيدة الحقيقية لا تُنسب بالاسم، بل بالهوية. فالشاعر الحقيقي يترك في نصه رائحة ذاته، مثلما تترك الوردة أثرها في اليد التي قطفتها.
قال تي. إس. إليوت: “الشاعر العظيم يَسرقُ بذكاء، أما الضعيف فيقتبس دون روح.” أي أن العبقرية الشعرية لا تقاس بالملكية بل بالبصمة.
ولذلك، حين نقرأ بيتاً من السيّاب، ندرك فوراً أنه له، لأن اللغة عنده ليست ألفاظاً بل دمعاً سال من جرح العراق ، يقول:
عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السَّحَرِ
أو شُرفتانِ راحَ ينأى عنهما القمرُ
إنه ليس نظماً، بل موسيقى ذاتية تنبع من عمق التجربة الوجودية.
_ خاتمة: الشعر كحقيقة للكينونة.
النظم نظامٌ للعقل، أما الشعر فهو فوضى القلب التي تصنع الجمال.
الناظم يكتب ليُقال إنه كتب، والشاعر يكتب لأنه لا يستطيع ألا يكتب.
الناظمُ حرفيٌّ، والشاعرُ قدّيسُ اللغة.
فما أكثر الناظمين الذين يبرعون في الوزن ويُحسنون الصنعة، لكنهم لا يتركون أثراً، وما أقلّ الشعراء الذين يخطّون بيتاً واحداً فيتردّد صداه في الأبد.
ذلك لأن الشعر – كما قال ريلكه – “ليس مهنة، بل مصير.”