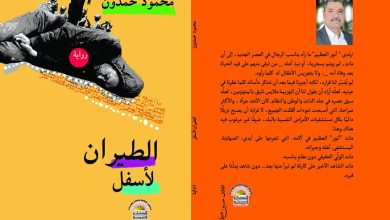أ. د. نجيب أيوب يكتب سيميائية اللغة الساحرة عند نجيب محفوظ
لغة القفش استعارة ثقافية ثرثرة فوق النيل نموذجا

جاءت لغة أديبنا الرائع نجيب محفوظ في روايته (ثرثرة فوق النيل) لا مجرد وسيلة سردية تقليدية، بل كانت في ذاتها بنية (جمالية/ثقافية) مكتملة الأركان، استهدف من خلالها أديبنا الكشف عن مأزق الحياة المصرية في حقبة تاريخية محددة، تَعَمَدَ الكلام عن المسكوت عنه فيها بشكل حِرَفِي، ففتحت لغة الرواية أفقا رحبًا للتأويل، مما جعل نص محفوظ الروائي خطابًا منفتحا لمتلقيه، ليظل قُرَّاء محفوظ مشدودين على عتبات نصوصه تتناوبهم جماليات البنية الاسطاطيقية للغة أولا، مع البعد الثقافي الترميزي الذي يسحبهم إلى أعماق الدلالات الثقافية الأخَّاذة، بأداء ثري بالأساليب الاستعارية ذات الأبعاد العميقة للقارئ المهتم بالنقد الثقافي لأدب الرواية.
وقبل تناول لغة السخرية وتداعياتها الجمالية والثقافية في روايتنا، كان حتميًا علينا أن نصف لغة محفوظ في هذه القراءة السريعة للرواية، وصفًا عامًا نلج بكم نحو الاستخدام الاستعاري الرامز بشكل جمالي ثقافي في آن واحد، يلاحظ من يُراقب لغة رواية الثرثرة أنها تتميز بخصيصتين: الأولى جمالية، في بنيتها النسقية، والثانية العمق الثقافي السياقي في في مضمرات محفوظ الثقافية.
أما عن الخصيصة الأولى (النسقية الجمالية) :
× فقد سيطرت على النسق السردي الذي جاء متماسكًا رصينا، حيث كتب الرواية بلغةٍ بسيطةٍ سهلة. في ظاهرها، لكنها مشحونة بحمولات دلالية تأخذ القارئ إلى تجربة جمالية تأملية تفتح عليه آفاقًا رحبة من التأمل والتأويل المنفتح.
× كما تميزت لغة كل شخصية عن لغة باقي شخصيات الرواية حيث تتناسب ومستواه الثقافي وسماته الشخصية، فكانت لغة الرواية أداة تأطيرًا ثقافيًا، حيث قسمت شخوصها تقسيما تنميطيًا حسب مستوى كل شخصية الثقافي ومكانته الاجتماعية، مما أوردها متناغمةً مع شخصياتها، وهذا هدف بنيوي قصده الكاتب في بناء أنساقه اللغوية في الرواية.
× استخدم محفوظ رموزا دلالية في هذه الرواية كــ(النيل والعوامة والدخان والليل والجوزة وعبدو الغفير) بنسقية جمالية، صنعت شبكة دلالية ارتبطت فنيا بالبنية العامة للرواية.
أما الخصيصة الثانية فالسياقية الثقافية:
× جاءت اللغة ملفوفة بمشاعر خيبات الأمل التي سيطرت على كل الشخصيات وفي كافة المواقف، وهذا جعلها كالمرآة التي تعكس الجو العام في الرواية الذي عاشه المجتمع المصري في حقبة الستينيات من انكسار جماعي وغربة ذاتية تتغشى كل فرد في ذاته.
× امتزاج العامية بالفصحى في مجريات السرد والحوار بالرواية، منح لغتها طاقة تعبيرية تنم عن التنوع الطبقي الكائن في طَيًّات المجتمع المصري ثقافيًا واجتماعيا.
× لم تكن حوارات الرواية محض تعبيرات عبثية ولا ثرثرة لفظية، لكنها جسدت حالة اليأس العام والانكسار الجمعي الذي يعكس حالة الاغتراب الداخلي والتيه النفسي والفكري والسياسي، فكان النظام اللغوي تعبيرا دقيقًا عن حالة العبث واللاجدوى في الثرثرة.
× تشبعت الرواية من أولها إلى آخرها بلغة متخمة بالتأثير الفلسفي المتأثر بفلسفات العصر العالمية، والتي انعكست في الأوساط الثقافية في مصر والعالم العربي، فكانت علامة من علامات التأثير الفلسفي الوجودي على الكاتب وبيئته التي أنتجته، مع تذكيرنا بمؤهل كاتبنا الذي تخرج في قسم الفلسفة بكلية آداب القاهرة.
جعل نجيب محفوظ من الحوار الساخر بين شخصياته محملاً باستعارات تعكس أزمة الانتماء والازدواجية الفكرية، في مفارقات لغوية تعكس حالة الإحباط المختلط بالسخرية بشكل سيميائي قمة في التعبير عما يريده، فلم تأت قفشات الرواية لمجرد التزيين اللغوي المُسَلِّي، بل جاءت في أداءٍ سيميائيٍ يحمل مفاتيحَ تأويليةً لأبواب التأويل، لا تخجل من أن تكشف النقاب لقارئها عن حالة اللاوعي الجمعي المشحون بحمولات الفِصَامِ العميق، بين المُعلَن من الخطاب الرسمي العام من جهة، وبين الحقيقة الواقعية المريرة من جهة أخرى؛ ليُسمعنا صوتا سرديًا صارخا من مرارة الهزيمة عبر الضحك الهستيري بين شلة المثقفين اليائسين الهاربين إلى دنيا العوامة، والحالمين بالسعادة الكاذبة في عالم الحشيش، حيث يتحدث البعض عن الحرية والعدالة ويستسيغون القهر ويتقبلون الظلم بخنوع واستسلام، ويتقنون الحديث في وصف التَدَيُّن الصادق ويخالفون تعاليم الدين في أغلب ممارساتهم، وينادون بالمساواة ويقبلون الدونية والخضوع لمن تعالى عليهم.
هكذا كشف نجيب محفوظ، المثالية المزعومة بين جماهير هذه الحِقبة الزمانية من تاريخ المصريين، في حين يعيش غالبيتهم حياةً مغايرةً تمامًا، من خلال تعبيرات ساخرة (قفشات) معبرة تعبيرا سيميائيًا، كان منها على سبيل التمثيل السريع:
أ- قول أنيس زكي: “كلنا في الهم شرق لكن على عوامة واحدة”.
ب- وقوله: “نعيش في مجتمع يرفع لافتة الفضيلة ويعيش في مستنقع من النفاق”.
ج- وقوله: “نصوم رمضان ونغتاب بعضنا البعض عند الإفطار”.
د- وقوله “الناس يموتون في الشوارع ونحن نتجادل في أسماء الروايات”.
هــ – وقوله: “يتزوجون طلبًا للاستقرار، ثم يهيمون على وجوههم بحثا عن الحرية”.
و- وقوله: “جيل يشرب الكوكاكولا ويتحدث عن الثورة”.
ز- وقوله: “الناس لا يعرفون لما يعيشون، ولكنهم يخشون الموت”.
ح- وقوله: “نعيش في دولة تبيع المبادئ في زجاجات”.
ط – وقوله: “الوطن يا عزيزي، أنا أعيش في زجاجة كوكاكولا”.
وبالقراءة السيميولوجية المتعمقة لهذا الأداء الاستعاري الثقافي، نُشير إلى أهم ما كان يريده الكاتب من هذه اللغة الساخرة، وما تُوْصِل إليه من هذه الأنساق اللغوية الساخرة، منتخبين بعضًا من هذه القفشات الساخرة:
أ- أراد الكاتب صناعة البديل النفسي المَرِح:
كوسيلة للهروب اللغوي من الواقع المرفوض، للدخول في حالة تخدير مقصود تُخفي مشاعر الانكسار والخذلان والضعف، بما نستطيع تسميته بـــ(البحث اللغوي عن بديل نفسي).
ب- وحاول محفوظ اختزال بياني مكثف للمأساة:
حيث تصنع القفشة خطابا مضادا للخطاب الرسمي العام، ضمن فضاءٍ خاص ومنعزل هو خطاب النخبة المثقفة المنعزلة في العوامة وخلال ثرثرتها المقصودة.
ج- استهدف كشف التزييف خلال أداء لغوي أكثر جُرأةً بفنية القفش الساخر:
لتفكيك كل السلطات السياسية والمعرفية والاجتماعية وحتى السياسية، ولتتحول اللغة من أداة للتزييف إلى أداة للكشف.
ومن تأمل تلك الأنساق الساخرة، يتبين له أن دلالاتٍ استعارية ثقافية واضحةً كامنة وراء أداء الشخصيات الساخر لهذه القفشات:
أ- الأداء الساخر في عبارة أنيس زكي في قوله: “إذا كان الضمير هو الحاكم، فكلنا أبرياء” دلت هذه القفشة على تفسخ القيم وتفريغ الأخلاق من مضامينها، مما نستطيع تسميته بـــ(فقدان الثقة) لآليات التبرير المستمرة وتبرئة الذات الجماعي، أي أن الكل ينفي التهمة عن نفسه في دوامة الفساد الهُلامية.
ب- وعبارة رنا الصحفية، في حوارها مع سامية: “دعنا نثرثر فالثورة مشغولة بنفسها” فيها من التهكم ما يدل على الانعزال التام عن الواقع المأزوم، ويأس النخبة المثقفة، مما أدى إلى ما نسميه بـــ(التنحي عن المواجهة المباشرة) في ظل الفراغ السياسي والدجل الإعلامي والعبث الإداري، لتتحول الثورة التي طال انتظارها من مستهدف وطني، إلى حالة لا يقينية مهتزة بين الخطاب البيروقراطي مفرغ المضمون من جهة، وخطاب المثقفين العبثي في الثرثرة التي حلت محل الفعل السياسي من جهة أخرى.
ت- وعبارة أنيس زكي: “الزمن دوار ودوار البحر لا يشفي على العوامة” وهنا يربط بأدائه المتهكم، بين دوران الزمن الذي تدور أحداثه متكررةً بدون جديد، ودوار البحر الذي يعني فقدان التوازن والتركيز الفكري والهَوَس النفسي، بربط مجازي ينم عن فقدان المعاني وضبابية الاتجاهات، بما يمكن تسميته بــــ(التيه).
هكذا استنطق نجيب محفوظ شخصيات الرواية في بناء سيميائي ذي دلالات تمزج بين (النسقي/السياقي) أو (الجمالي/الثقافي) ليضعنا أمام بناء لغوي مفارقي، كشف فيه عن مُضمرات ثقافية قُبحية، أُخفيت خلف البنى الجمالية بحيل ذكية غايةً في الذكاء، وردت لتزيل الستار عن المسكوت عنه سياسيًا، باستخدام السخرية اللغوية التي لم تكن مجرد تزيين كوميدى للتسلية، بل كانت رموزًا استعاريةً فتحت في النص طاقات التأويل الثقافي الماتع.
***********
أ.د/ نجيب عثمان أيوب.
أستاذ الأدب العربي والنقد بجامعة حلوان