الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي يكتب يحيى حقى قنديل الأدب .. وشاعر القصة القصيرة
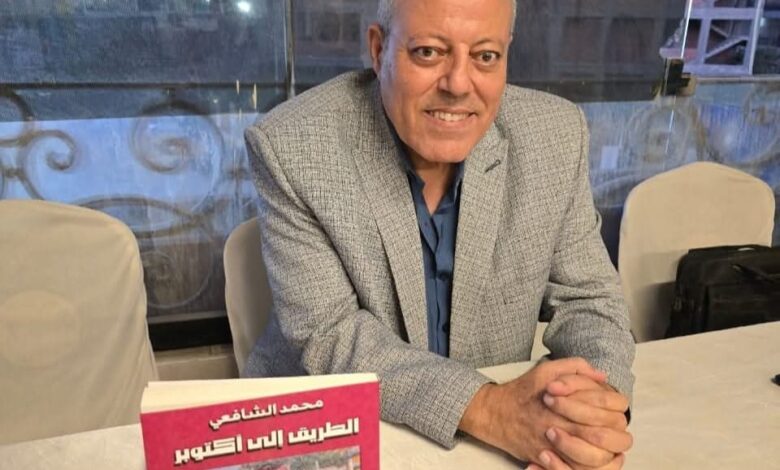
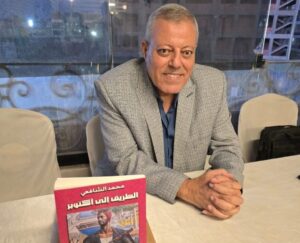
نحات يستلهم كل إبداع فنانى مصر القديمة.. ينحت كلماته برقة ورهافة.. فنان أرابيسك يضع كلماته الواحدة في حضن الأخرى.. ليصنع لوحات من الأدب المبهر.. كلماته مثل البللور الصافى.. الذى تخلص من كل الشوائب والزوائد.. ليتحول إلى سيمفونية إبداعية.. تشع البهجة والنور في نفوس قارئيه.. تمسح خلاياهم بالتسامح والإنسانية والفكاهة.. وتدفعهم إلى اكتشاف الهموم المخبؤة في وجداناتهم.. لتحولها إلى شجن شفيف يخلو من القسوة والمرارة.. يسرى في الشرايين مسرى اللحن الجميل.
عفيف النفس كريم الخلق.. دائم العطاء.. امتلك كل فضائل الاحتضان والأبوة.. والحساسية الإنسانية تجاه الآخرين.. بسيط مستنير.. يمتلك كل ملكات الإقدام والتقدمية.. يسعى خلف المعانى وكأنه صياد ماهر.. صاحب مدرسة التكثيف البليغ.. والتركيز المبهر (كوكتيل مواهب).. امتلك موسوعية التلقى .. فكان من الطبيعى أن يمتلك توأمها السيامى موسوعية الإنتاج.. إنه قنديل الأدب.. وشاعر القصة القصيرة الأديب المبدع يحيى حقى .. صاحب المشروع الملهم والمعجز..
ولد يحيى حقى في السابع من يناير عام 1905.. في حارة الميضة خلف مقام السيدة زينب.. وتعود جذوره إلى تركيا.. وتحديدا مسلمى (المورة) الذين قدم بعضهم إلى مصر في القرن التاسع عشر.. أثناء خضوع مصر للحكم العثمانى.. وقد كتب عن طفولته في أكثر من موضع في العديد من كتبه ومن هذه الكتابات (كنت الثالث بين إخوتى.. ولدت في السابع من يناير 1905 بحارة الميضة خلف مقام السيدة زينب .. في بيت ضئيل من أملاك وزارة الأوقاف.. ورغم أننا غادرنا حى السيدة زينب وأنا لا أزال طفلا .. فهيهات أن أنسى تأثيره على حياتى.. وتكوينى النفسى والفنى).. ورغم هذه الجذور التركية.. إلا أنه التحم بالروح المصرية.. وغاص في عمق أعماق الشخصية المصرية.. ليؤكد على أن مصر لا تتعامل أبدا مع أبنائها وخاصة مبدعيها (طبقا لبطاقة المنشأ).. ولكن تتعامل معهم بقوة المحبة والانتماء.. ويقول يحيى حقى في موضع آخر من كتبه عن طفولته (هاجر جدى وهو شاب إلى القاهرة – سعيا للرزق.. فلا عجب أن اختار لإقامته أقرب المساكن لجامعه المحبب- السيدة زينب- وهكذا استقر في منزل للأوقاف قديم.. يواجه ميضأة المسجد الخلفية في الحارة التي تسمى حارة الميضة.. وفتح جدى متجراً للغلال في الميدان.. وهكذا عاشت الأسرة في رحاب الست وفى حماها.. أعياد الست أعيادنا ومواسمها مواسمنا.. ومؤذن المسجد ساعتنا).
ويؤكد على ذلك في موضع آخر من كتاباته فيقول (لحسن حظى ولدت في حى شعبى بالقاهرة.. بحارة الميضة.. وراء مقام السيدة زينب رضى الله عنها.. ومنذ طفولتى وأنا في الشارع.. أخالط هؤلاء الناس الكادحين.. الذين يئمون هذا الجامع باستمرار وفى ذيلهم الشحاذون.. عرفت مثلا الأسطى حسن الحلاق- طبيب الحى- الذى يقوم بجراحات عديدة.. ولا أنسى أنه كان يقوم بختان الصبيان أيضا.. كذلك عرفت بائعة الطعمية وبائع الفول.. وبائع الدقة والسميط.. فاختلطت في الحقيقة منذ صغرى بهذا الوسط).
وقد نشأ يحيى حقى في أسرة متدينة مثقفة.. والدته شديدة التدين.. تعلمت القراءة والكتابة والحساب في مدينة المحمودية.. تقرأ الصحف والقرآن وكتب الأحاديث والسيرة النبوية.. وتحفظ كثيراً من شعر المتنبئ وأبى العلاء وأبى نواس وغيرهم ويقول عن أمه (أمى كانت عماد الأسرة.. ربتنا بيديها.. ربت ستة أبناء).. وكانت جدته لأمه حافظة للقرآن الكريم.. وتعلم والده في الأزهر الشريف.. درس اللغة العربية.. وكان شغوفا بعيون الأدب العربى.. وعمه محمود طاهر حقى كاتب وأديب وصديق أمير الشعراء أحمد شوقى.. أما شقيقه الأكبر إبراهيم فكاتب في مجلة السفير .. رشيق الأسلوب.. وهو الذى أسس مكتبة البيت.. التي ضمت ذخائر التراث العربى.. وبعض الكتب الإنجليزية.. ويقول يحيى حقى عن أسرته (أنا مدين في نزعتى الأديبة إلى البيئة وإلى أسرتى).. ورغم المدة القصيرة التي عاشها في حى السيدة زينب.. إلا أنها ظلت ينبوع إلهامه ووحيه.. فقدمها في العديد من كتبه وإبداعاته (قنديل أم هاشم .. أم العواجز.. ناس في الظل .. صفحات من تاريخ مصر.. من باب العشم.. فيض الكريم.. خليها على الله).. ويقول عن تأثير البيئة المصرية وخاصة حى السيدة زينب (إنى وإن كنت من أصل تركى قريب.. فإنى أحس بأننى شديد الاندماج بتربة مصر وأهلها.. ومعرفتى باللغة العامية المصرية وتعبيراتها.. تفوق ما حصلته منها مباشرة.. ولعل هذا الحب هو الذى جعلنى أميل إلى استخدام بعض الكلمات العامية في كتاباتى.. رغم أنى من المهووسين بالفصحى).. وكان دائم التأكيد على دور أسرته في تكوينه الأدبى والإنسانى.. فيقول عن الأسرة كلها (مغرمون جميعاً بالقراءة.. وفنون الكلمة بشتى ألوانها.. خصوصا الكلمة الرشيقة).. ويؤكد على أن شقيقه الأكبر إبراهيم هو من قاده إلى الثقافة الغربية (قادنى إبراهيم في دروب الأدب الإنجليزى.. فقرأت كثيرا لديكنز وإديسون وروبرت لويس وغيرهم).
أما عمه محمود طاهر حقى فجعله يجلس مع أمير الشعراء أحمد شوقى أكثر من مرة.. ويقول عن ذلك (رآنى شوقى مع عمى أكثر من مرة.. وفى إحدى المرات أعطانى قصته (أميرة الأندلس) وهى مخطوطة لأبدى رأيى فيها.. وقد تجرأت ونقدتها بشئ من العنف .. وكان ذلك غرورا حتى ندمت عليه بعد ذلك.. الغريب أن أمير الشعراء لم يغضب منى) وكان عمه محمود طاهر من رواد العمل في الصحافة.. وكتابة القصة والمسرحية..
وفى طفولته الباكرة ذهب إلى الكتاب بمسجد السيدة زينب.. ليحفظ القرآن الكريم.. وليتعلم مبادئ القراءة والكتابة .. ثم التحق بمدرسة أم عباس الابتدائية.. وهى مدرسة مجانية لأبناء الفقراء.. من أوقاف إلهامى باشا وقد وصف دراسته الابتدائية طوال خمس سنوات بالتعيسة.. حيث لم يكن يفهم الكثير مما يدرسه.. ويقول (كان طبيعيا أن أرسب في السنة الأولى الابتدائية.. ولكن لم ارسب بعد ذلك قط.. كنت أنجح حتى أفارق هذا الجحيم.. ولكى لا أغضب أمى أو أجرعها خيبة الأمل)..
ورغم معاناته في مدرسة والدة عباس المجانية.. يذكر لها ميزتين الأولى هي أنها المدرسة التي درس فيها الزعيم مصطفى كامل.. وقد أدرك واحدا من المدرسين الذين درس عليهم الزعيم مصطفى كامل وهو الشيخ عبد المنعم أما الميزة الأخرى في مدرسة أم عباس فتمثلت في الصداقات التي كونها مع زملائه واستمرت طوال العمر.. وحصل على الابتدائية عام 1917.. ليلتحق بالمدرسة الإلهامية الثانوية.. وانتقل منها إلى المدرسة السعيدية.. ثم إلى المدرسة الخديوية .. ليحصل على الشهادة الثانوية عام 1921.. وكان يتمنى في طفولته أن يصبح طبيبا.. ليكتشف المجهول في جسد الانسان.. ولكن خشيته من الرسوب في القسم العملى.. جعلته يذهب إلى القسم الأدبى.. ليذهب إلى مدرسة الحقوق العليا.. التي يقول عنها (كانت تمثل قمة التعليم العالى.. ولا يدخلها إلا المحظوظون) وزامل فيها توفيق الحكيم.. وتخرج منها في عام 1925. ليعمل بالمحاماة في الإسكندرية ودمنهور ليختلط بالفقراء وقضاياهم وبعالم المحاماة .. إلى أن تم تعيينه معاونا للإدارة في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط عام 1927.. وهى وظيفة تجمع بين ضابط الشرطة ووكيل النيابة.. وهى وظيفة كانت تلقى عليها كل الوزارات بأعبائها.. فيدخل شاغلها في أدق تفاصيل الحياة اليومية.. وإذا كان لمولده وطفولته في حى السيدة زينب أكبر الأثر في إبداعه وكتاباته.. فإن تجربته في منفلوط تمثل الجناح الثانى.. الذى حلق به الأديب الكبير يحيى حقى.. ليخرج لنا العديد من الأعمال الإبداعية المبهرة مثل كتابه (خليها على الله) وروايته (صح النوم).. ومجموعته (دماء وطين) عام 1957.. والكثير مما يمكن أن نطلق عليه صعيديات يحيى حقى.. والتي لم تكتف بكشف ظواهر الناس والمجتمع .. ولكنها غاصت في عمق الأعماق .. لتخرج بالجواهر والكنوز الإنسانية.. وقد أحب يحيى حقى أهل الصعيد الفلاحين فأحبوه.. حيث لم يكن متعاليا ولا منعزلا.. بل شاركهم طعامهم وسمرهم.. وحاورهم لكى يفهمهم.. وكتب عنهم محباً ومتعاطفا.. عكس توفيق الحكيم الذى سخر من الفلاحين في روايته يوميات نائب في الأرياف.. فأخفوا عنه أدلة جريمة القتل..
وقد عاش في منفلوط عامين (27- 1929).. كان لهما اكبر الأثر على حياته الشخصية والأدبية.. حيث استقلاله في المعيشة.. واتصاله المباشر بالطبيعة المصرية.. الحيوان والنبات.. والأهم اتصاله المباشر بالفلاحين.. والتعرف على عاداتهم وطباعهم.. واتصاله المباشر وبحرية بالجنس الآخر.. واستطاع أن يخرج بهذه التجربة من الحلقة المحكمة.. التي كانت تحيط به.. تلك الحلقة التي وضع فيها إسماعيل بطل رائعته قنديل أم هاشم عندما قال عنه (تلفه الجموع فيلتف معها.. كقطرة المطر يلقمها المحيط.. صور متكررة متشابهة.. اعتادها فلا تجد في روحه أمل مجاوبة.. لا يتطلع ولا يمل.. لا يعرف الرضا ولا الغضب.. إنه ليس منفصلا عن الجمع حتى تتبينه عينه).
وفى صعيد مصر اصطدم يحيى حقى.. بحجم الفقر والجهل والتخلف ومقاومة الفلاحين .. بالتمسك بأقصى درجات السلبية..
في مواجهة أوامر الحكومة.. وقد سجل تفاصيل هذين العامين في كتابه الرائع (خليها علي الله).. الذي صدر عام 1959.. أي بعد ثلاثين عاماً من مغادرته مدينة منفلوط.. كما سجل الكثير من التفاصيل في مجموعتيه (دماء وطين – البوسطجي).. وقصة حصير الجامع.. حيث وجد أن الهوة كبيرة بين الفلاح والحكومة.. من خلال موظفيها فقال عن ذلك (لم أسلم طوال خدمتي من الشعور بالأسي.. لهذه الهوة.. وجدت معظم أشغال الحكومة رغم حسن نيتها – يحار تفسيرها – تعرقل وتهدم.. وحاولت بكل قواي.. بل جعلت خطي وديدني.. أن أستلين الفلاح حتي أجعله يثق بي.. فلم أفلح.. ففي ذهنه اعتقاد راسخ بأن الحكومة لا تفهمه.. وأن الموظفين غرباء).. وفي منفلوط كانت الحمير وسيلة المواصلات الوحيدة.. فكتب عن ذلك (وجدت سعادتي مع الحمير).. ثم توسع في الكتابة عن الحمير.. وكان يحنو علي الحيوانات بشكل عام.. ويقول في ذلك (عند رؤية عيون الحيوانات.. خاصة القطط والكلاب.. أشعر أن وراءها أرواحاً حبيسة تهفو إلي الانطلاق).. وتلك العلاقات الحميمة مع المخلوقات.. جعلت القصة القصيرة (هواه الأول).. لأنها تقوم بالأساس علي تجارب ذاتية.. أو مشاهدات مباشرة.. مما يجعل عنصر الخيال فيها قليل جداً.. وقد دفعه عشقه للحياة.. إلي التأمل في التفاصيل اليومية لكل من وما حوله.. يلاحظ الطرائف والمتناقضات.. ويحولها إلي إبداع.. كما ساعدته الطبيعة المصرية بشخصياتها المتباينة.. التي تضرب بجذورها في عمق الأرض السمراء.. التي تضرب في عمق الزمن.. لتصنع التراث الطويل من القوة والضعف.. العز والانكسار.. التمرد والخشوع.. الروح القوية الصامدة.. التي قد تتراجع.. ولكنها أبداً لا تموت.. ولذلك راح يركز في قصصه.. علي مفهوم الإرادة.. فبدونها تفقد الحياة الإنسانية سموها واحترامها..
وأثناء عمله في مدينة منفلوط.. قرأ إعلاناً في إحدي الصحف.. عن طلب وزارة الخارجية أمناء للمحفوظات.. فتقدم للاختبار.. ونجح وجاء اسمه في آخر القائمة.. وذهب إلي القنصلية المصرية في مدينة جدة بالأراضي الحجازية.. واستمر بها لمدة عام واحد.. استمتع خلاله بقراءة مجلدات الجبرتي.. وفي عام 1930 انتقل إلي اسطنبول.. ليشهد تحول تركيا من الخلافة الإسلامية إلي العلمانية.. علي يد مصطفي كمال أتاتورك.. ولم يتعاطف مع هذا الانقلاب الفكري الكبير.. وذلك لمشاعره الدينية العميقة.. وبعد أربع سنوات في تركيا.. انتقل إلي القنصلية المصرية في روما.. التي مكث فيها خمس سنوات كاملة.. اتصل خلالها بالحضارة الأوربية عن قرب.. لكن تاريخ مصر وحضارتها وإبداعها الإنساني.. مع تجاربه وانتماءاته الفكرية.. جعلته عصياً علي الذوبان في تلك الحضارة الجديدة.. ويقول عن ذلك (كنت أشعر دائماً في داخلي شيئاً لا يذوب بسهولة في حضارة الغرب.. فقد وصلتها (روما) وعندي حضارة.. إن لم تفق فهي تماثل حضارتها.. وعندي دين هو نظام متكامل فيه الغناء).. ويقول أيضاً (طوال تلك السنوات لم أنقطع عن التفكير في بلادي وأهلها.. كنت دائم الحنين إلي تلك الجموع الغفيرة.. من الغلابة والمساكين.. الذين يعيشون رزق يوم بيوم).

انتقل من روما إلي باريس في عام 1939 سكرتيراً أول لسفارة مصر في فرنسا.. وعاد في عام 1951 إلي تركيا مستشاراً للسفارة المصرية في أنقرة.. وفي عام 1952 تم تعيينه وزيراً مفوضاً بالسفارة المصرية في ليبيا.. وقد أتاح له العمل الدبلوماسي.. رؤية جوانب الصورة الأخري.. بعد أن رأي الوضع المصري.. وقد انبهر بالحضارة الغربية الجديدة.. ولكنه لم يفكر أبداً أن يستغني بها عن حضارته القديمة.. واستطاع يحيي حقي الدبلوماسي.. أن يحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال.. انطلاقاً من ثقافته الموسوعية.. وإجادته لخمس لغات هي العربية – الفرنسية – الإنجليزية – الإيطالية – التركية.. وقد أنفق يحيي حقي أيامه ولياليه.. قارئاً للتاريخ والتراث والآداب العربية والشرقية والغربية.. كما أقبل علي كل الفنون.. متذوقاً ومستمتعاً (الشعر – النثر – الموسيقي – السينما – المسرح – النحت – الفلكلور).. واستطاع أن يرصد من خلال كتاباته تناقضات الداخل والخارج.. ففي كتاب خليها علي الله.. أظهر الهوة بين الحكومة والفلاحين.. وفي كتاب حقيبة في يد مسافر.. أظهر الهوة بين الشرق والغرب.
تزوج يحيي حقي للمرة الأولي في عام 1944.. من السيدة نبيلة سعودي (قريبة السيدة أم كلثوم).. وأنجب منها ابنته نهي.. ثم تزوج في عام 1954 من النحاتة الفرنسية جان ماري.. وبسبب هذا الزواج ترك العمل في وزارة الخارجية.. وانتقل للعمل في وزارة الإرشاد القومي.
كان المناضل الوطني فتحي رضوان وزيراً للإرشاد القومي.. فوجد في الدبلوماسي الناجح.. الأديب المتفرد يحيي حقي فرصة عظيمة.. فأسند إليه إدارة مصلحة الفنون والآداب – التي تحولت إلي المجلس الأعلي للثقافة فيما بعد – وذلك بداية من عام 1955.. فكان اختياراً صادف أهله.. حيث شارك الرجل في وضع أسس الثقافة المصرية المعاصرة.. وذلك من خلال اختيار أصحاب الكفاءات والرؤي المستنيرة للعمل إلي جانبه.. فاختار أولاً الأديبين نجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير.. ليكونا أقرب مساعديه.. ثم قام بتكليف رائد الفن الشعبي زكريا الحجاوي.. ليجوب مصر طولاً وعرضاً.. للبحث عن المواهب الشعبية الأصيلة.. من السواحل والصحاري والفلاحين والصعيد.. لتحقق الفنون الشعبية انطلاقة عملاقة وراقية.. ما زالت أثارها موجودة حتي الآن.. من خلال فرق رضا والقومية والنيل للفنون الشعبية.. وكان ذروة إنتاج هذا القطاع في أوبريت (يا ليل يا عين).. الذي تم تقديمه عام 1956.. المأخوذ عن أسطورة شفهية.. سمعها الأديب توفيق حنا من أحد حلاقي الإسكندرية.. وقام يحيي حقي بتشكيل لجنة شارك فيها نجيب محفوظ وأحمد رشدي صالح .. لإعداد تصور عن كيفية تقديم هذه الأسطورة في عمل استعراضي شعبي كبير.. وقام بالصياغة النهائية للأوبريت علي أحمد باكثير وزكريا الحجاوي.. وكتب الأغاني عبدالفتاح مصطفي.. وقدم الألحان أحمد صدقى, حسن صدقي وعبدالحليم نويرة وإبراهيم حجاج.. وقام بالبطولة نعيمة عاكف ومحمود رضا والمطربة شهرزاد ومحمود شكوكو وفريدة فهمي.. وقام بالإخراج زكي طليمات.. ونجح هذا الأوبريت نجاحاً مبهراً.. وطاف العديد من دول العالم.. كما أدت أفكار يحيي حقي إلي إنشاء مسرح العرائس.. وأوركسترا القاهرة السيمفوني.. وكورال الأوبرا.. وفرقة يا ليل يا عين للفنون الشعبية.. كما أنشأ عدة معاهد فنية.. كانت النواة لإنشاء أكاديمية الفنون..
استمر يحيي حقي علي قمة مصلحة الفنون والآداب.. مع أول وزير للثقافة في مصر د. ثروت عكاشة عام 1958.. وفجأة تم نقله مستشاراً بدار الكتب.. وقيل كلام كثير عن هذا النقل.. وزعم البعض أن ذلك قد تم بقرار مباشر من الزعيم جمال عبدالناصر.. وذلك لأن يحيي حقي كان صديقاً للشيخ محمود محمد شاكر.. الذي كان يطلق لسانه بكل العنف والقسوة ضد جمال عبدالناصر شخصياً.. وأن يحيي حقي كان يحضر تلك الجلسات ولا يرد.. رغم أنه واحد من أهم قيادات الثقافة المصرية بعد ثورة يوليو.. ومثل هذا الكلام مبالغات.. فلو تعرض يحيي حقي إلي غضب السلطة.. فلن يكون هذا الغضب بجعله مشرفاً عاماً علي دار الكتب.. ثم بعد ذلك رئيساً لتحرير مجلة المجلة من 1963 – 1970.. تلك المجلة التي حولها إلي مفرخة عملاقة لكل الأدباء والنقاد الشباب من جيل الستينيات.. من خلال نشر أعمالهم.. وكتابة المقدمات النقدية الرائعة لها.. وقد جعل شعار هذه المجلة (سجل الثقافة الرفيعة).. وقد كان بابه مفتوحاً طوال الوقت.. وما من أحد طرق هذا الباب.. إلا وجد عنده الأبوة والحنو والرشد والأخذ باليد إلي بداية الطريق.

بدأ يحيي حقي مسيرته الإبداعية في سن مبكرة.. مع بداية العشرينيات من عمره عام 1926.. وكانت قصته الأولي بعنوان (قهوة ديمتيري).. الموجودة في المحمودية.. ووصف عمدة البلد بشكل متطابق مع الرجل تماماً.. مما أغضب هذا العمدة.. فتعلم الدرس وكتب عن ذلك (حرصت فيما بعد علي أن أتجنب مثل هذه المطابقة.. بعد أن فهمت أن الأدب الواقعي.. ليس هو التصوير الفعلي.. وأصبحت الشخصيات التي أرسمها ليست منقولة عن فرد واحد بل مجموعة أفراد).. وراح بعد ذلك يكتب بأسلوب بسيط رشيق مليء بالثقافة.. وتحولت كتاباته الممتعة إلي متحف مفتوح حافل بالمتعة والمعرفة.. خاصة وأنه يحب الناس.. ويعشق الحوار الهادئ معهم.. لا يفرض رأيه علي أحد.. ولذلك كان يقدم شخصياته بحب لا يخلو من حكمة.. ونقد لا يخلو من تعاطف.. من خلال العرض الصادق والعميق لنماذج حية من البيئة المصرية.. وقد ساعده علي ذلك كونه غواصاً ماهراً في بحر الموروث الشعبي الهائل.. الزاخر بالطقوس والألوان.. ولذلك كتب عن ابن البلد بكرمه ومرؤته.. بلطفه وظرفه وخفة دمه.. بذكائه وقفشاته.. كما كتب عن الواقع المرير في قاع المجتمع.. عن موقف الحمير وعربات سوارس.. وبائعة الفجل.. وبائع الترمس.. إلخ.. وساعده علي كل ذلك أنه كان موسوعي النزعة.. يمتلك الفكر الخلاق.. والإبداع شديد الخصوصية.. وراح يقدم في إبداعه.. عصارة فكره.. وذوب روحه.. وخفقات قلبه العاشق.. متسلحاً بذخيرة هائلة من التراث العربي والأدب العالمي.. خاصة في فرنسا وإنجلترا وروسيا.. وكان في بداية شبابه قد تأثر كثيراً بقصص الأديب الروسي أنطون تشيكوف.. واستطاع يحيي حقي أن يخلق لنفسه بصمة شديدة الخصوصية في عالم القصة القصيرة.. بل تحول إلي رائد هذا الفن وشاعره.. فحظيت إبداعاته بالنشر في كثير من الجرائد والمجلات.. خاصة وهو المهموم بالبحث عن شخصيات الظل.. وتقديمها بحنان كامل وود حقيقي.. كما في كتابه (ناس في الظل).. ويشعر القارئ بشكل دائم أنه أمام عاشق محب.. حتي وهو ينتقد بعض السلبيات.
وتميز يحيى حقى بأنه أكثر الأدباء إحساسا بالكلمة.. يجمع بين بساطة التعبير ودهاء الفكرة ويتقن اختيار الإيقاع والجرس واللفظ حتى يصل إلى المعنى.. كما امتلك قدرة مذهلة على التكيف يكتب ما قل وأمتع.. يعزف أناشيد البساطة.. ويضع هموم الوطن بين خلاياه.. ويكتب بريشة الصدق والاحساس.. حتى صار أحد رموز القوة الناعمة المصرية.. وابن الشعب العاشق لهذا الوطن تاريخا وفكرا وفنا.. وإضافة إلى امتلاك كل أدوات التمكن الأدبى.. امتلك خفة الظل وروح الفكاهة.. لدرجة أن بعض قصصه تبدو وكأنها فكاهة خالصة.. كما امتلك القدرة على الغوص في أعماق النفس البشرية.. واعترف بأنه قرأ عالم النفس فرويد رائد التحليل النفسى.. وأخذ عنه الدافع الجنسى.. من حيث هو طاقة للحياة.. واستطاع يحيى حقى في كل إنتاجه الأدبى تقديم الطبقة الوسطى.. من خلال عشقه لهؤلاء الذين يعيشون في الأحياء الشعبية.. وفى القرى والنجوع.. وولعه بممارساتهم وتقاليدهم.. وتفاصيل حياتهم وحديثهم ويقدمهم على أنهم ملح الأرض وسادتها.. يصنعون الحياة ويعيشونها.. كما كان يرصد بكل الدقة تحولات المجتمع المصرى.. ليغوص في الروح المصرية مع النفاذ إلى جوهر اللغة الوطنية.. وكشف قدرتها على التعبير عن مشاعره وأحاسيسه.. ويستطيع القارىء أن يضع يحيى حقى في خانة الكاتب الأخلاقى.. من دون السقوط في جب الوعظ والمباشرة حيث يغزل الأحداث في قصصه.. ليصل إلى المغزى الأخلاقى الذي يهدف إليه .
وتوالت أعمال يحيى حقى القصصية والروائية والنقدية (قنديل أم هاشم 1944 – دماء وطين 1955 – أم العواجز 1955 – خليها على الله 1956 – رواية صح النوم 1959 – عنتر وجولييت 1960 – خطوات في النقد 1960 – فجر القصة المصرية 1960 – فكرة وابتسامة 1961 – دمعة فابتسامة 1966 – تعالى معى الكونسير 1969 – حقيبة فى يد مسافر 1970 – عطر الأحباب 1971 – ناس في الظل 1971 – ياليل يا عين 1972 – أنشودة الأمل 1973 – أشجان عضو منتسب 1974).
وكانت رواية صح النوم أحب أعماله إلى قلبه.. حيث قال عنها (إن هذا العمل قريب جدا إلى قلبى.. ظللت أصقل كل كلمة فيه.. وأعاود الصقل.. حتى أحسست في لحظة بأن الورقة التي أكتب عليها.. سوف تتمزق تحت سن القلم).. وتقع هذه الرواية في قسمين الأول بعنوان الأمس.. والآخر بعنوان اليوم.. وتتحدث عن بناء محطة للقطار في إحدى القرى.. التي يتغير فيها كل شيء.. والقطار رمز لثورة يوليو 1952.. وبطل الرواية (الأستاذ) رمز لزعيم الثورة جمال عبدا لناصر.. وقال عنها كنت أتصور قبل 23 يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة.. وأنها لا تنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور.
وفى كتابيه خليها على الله وكناسة الدكان.. وضع أهم سماته الإبداعية.. أما في كتاب سيرته الذاتية (أشجان عضو منتسب ) فقد حرص على تأكيد معالجته لمعظم فنون القول (القصة القصيرة – الرواية – النقد – الدراسة الأدبية – السيرة الذاتية) ولكن تظل القصة القصيرة هواه الأول ومصدر إبداعه المتميز حيث عمل على تطويرها بالثورة على أساليبها الزخرفية.. بإيجاد أسلوب يتسم بالدقة والعمق ولم تتوقف سيرته الذاتية عند كتاب واحد.. حيث نثرها في أكثر من كتاب.. ولم يلتزم بالتسلسل الزمنى.. حيث بدأها بيوم تأديته امتحان الشفوى الأخير.. في شهادة ليسانس الحقوق.. ثم تحدث عن طفولته في كتاب كناسة الدكان.. ثم تحدث في كتاب خليها على الله عن فترة عمله كمعاون للإدارة في مدينة منفلوط.
وقد نبع الفن القصصى لدى يحيى حقى من موقفه من اللغة.. واشتقاقاتها وتوظيفاتها.. ثم من التفاعل الحضارى بين الحضارات.. ويرى أن الأدب يعتمد على قوة الأسلوب.. لا نوعية الموضوعات.. وأن القوة تنبع من باطن النص – وكان يبحث عن مسودات الكتاب الكبار.. حتى يقرأها.. ليكتشف سر الصنعة.. ويؤكد على أن اللفظ هو وعاء الفكر.. ويقول في ذلك (قد اكتب الجملة الواحدة ثلاثين أو أربعين مرة.. حتى أصل إلى اللفظ المناسب الذي يتطلبه المعنى).
وقد امتلك يحيى حقى تجربة شديدة التميز والخصوصية في التجديد اللغوى للدرجة التي جعلته يقول (قد أرضى أن يغفل الجميع عن قصصى وكتاباتى.. ولكنى أحزن أشد الحزن.. إن لم يلتفت أحد إلى دعوتى للتجديد اللغوى).
وتركزت أهم سمات إبداعه.. في استخدام الصورة.. أو اللوحة القصصية.. والجمل الاعتراضية.. وفن البورتريه أو تصوير الشخصيات من عالميها الخارجي والداخلى.. وينبع غرامة بالتشبيه.. من إيمانه بأنه يخلط الماديات والمعنويات في قبضة واحدة.. ويقرب البعيد.. ويبعد القريب.. ويقرن المتناقضات.. فإذا هي تتشعب..و ويفصل بين المتناقضات فإذا هي متناقضة.
ورغم أنه كان مهووسا بالفصحى.. إلا أنه يقبل أن يذهب الكاتب إلى بعض الألفاظ العامية.. بشروط أهمها أن لايجد في الفصحى اللفظ.. الذي يؤدى كافة المعانى والإيحاءات التي يقدمها اللفظ العامى.. ورغم ذلك كان يحاول بشكل دائم نحت ألفاظ جديدة في الفصحى.. ودعا إلى الالتزام بما أسماه (الأسلوب العملى) الذي يتميز بالوضوح والدقة.. وهذا يعنى أن يكون اللفظ في موضعه بلا قلقلة – حيث لا يوجد لفظ غيره يوضع مكانه.. وهذا الأسلوب العلمى يعنى أن يتخلص النص من السجع اللفظى والذهنى.. ومن التكرار والكلمات العائمة ولذلك كانت لغته الفنية في قصصه قريبة جدا من لغة الشعر.. حيث تميل إلى التكثيف الشديد.. والتركيز المبهر.. حيث امتلك طوال حياته حبا طاغيا للشعر.. وفهما عميقا لحساسية اللغة الشعرية.. وكان ينفر من الاستطراد, والبتاهى والتظاهر بالبلاغة التي ليست في محلها.. ويكره ابتذال اللغة وزينتها الرخيصة.
وقد أحاط يحيي حقي نفسه وإبداعه.. بهالة من الشعور الصوفى الحميم.. الذي يربطه بكل ما حوله.. ويجعله في شوق دائم ودائب للنفاذ إلى جوهر المشاعر والكلمات.. والغوص في أعماق النفس البشرية وكل الأشياء.
ويصل الاجتهاد اللغوى لدى يحيى حقى.. في تجاربه التي حرص فيها على تضفير الفصحى بالعامية البليغة.. حيث كان المبدع الثانى بعد بيرم التونسى الذي استطاع استثمار كنوز المعانى في العامية المصرية.. ورغم كل هذا التجديد اللغوى.. لم يتم ضم هذا المبدع الكبير إلى مجمع اللغة العربية.. رغم وجود من هم أقل منه إبداعا واجتهادا..
وقد عاش يحيى حقى في أزمة إبداعية طوال حياته.. حيث طغت قصة (قنديل أم هاشم) على كل ابداعه.. خاصة بعد تحويلها إلى فيلم عام 1968 سيناريو صبرى موسى وإخراج كمال عطية ويقول عن هذه القصة (إنها قصة حزينة جدا.. كتبتها في حجرة صغيرة كنت أستأجرتها في حى عابدين.. إن بطل القصة شاب يريد أن يهز الشعب المصرى هزا عنيفا ويقول له أصح تحرك لقد تحرك الجماد).. وتضم مجموعة قنديل أم هاشم ثلاث قصص – إلى جانب القصة الرئيسية.. وقد نشرت قنديل أم هاشم عام 1944 رغم أنه قد كتبها بين عامى 39-1940 وكان يضيق بها.. لأنها تحولت وكأنها كل ما كتبه.. ويقول عن ذلك (خرجت من قلبى مباشرة كالرصاصة.. وربما لهذا السبب استقرت في قلوب القراء بالطريقة نفسها).. والبطل الحقيقى لهذه القصة هو إسماعيل كامل أول سفير لمصر في الهند عام 1947.
وفى منتصف السبعينيات طلب يحيى حقى من تلميذه فؤاد دوارة.. الإشراف على إعادة إصدار أعماله الكاملة.. ما نشر منها وما لم ينشر.. وقد عكف الناقد المسرحى الكبير فؤاد دوارة على هذه المهمة لمدة 15 سنة كاملة.. وارتفع بعمله إلى مستوى الإبداع الذي قدمه أستاذه واستطاع إضافة 12 كتابا إلى الأعمال المنشورة ليحيى حقى.. استخلصها من أرشيف الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر.. وقام بتصنيفها وتبويبها وتنسيقها.. وإعادة ترتيب بعضها.. فصدر كتاب عن المسرح.. وكتاب عن السينما وكتاب عن الموسيقى وكتاب عن القضايا الأدبية وكتاب عن الخطوات النقدية وكتاب في الشئون الدينية – وفى الكتاب الأخير جميع باقى المقالات.. وأخذ أحد تعبيرات يحيى حقى وأطلق عليه كناسة الدكان.. وبشكل عام خرجت كل أعمال يحيى حقى في 28 جزء.. بعد أن تم تصنيفها تصنيفا موضوعيا.. الابداع الخالص في القصة والرواية في سبعة مجلدات.. والكتابات النقدية في اثنى عشر مجلدا.. وأخيرا المقالات الأدبية في تسعة مجلدات.. وقد صدرت كل هذه الأعمال في حياة يحيى حقى.. الذي كان عفيف النفس.. وشديد الاعتداد بكرامته.. حيث رفض الكتابة في الأهرام – رغم العرض السخى جدا الذي عرضه يوسف السباعى رئيس مجلس إدارة الأهرام في ذلك الوقت.. ورغم وساطة تلميذه الأحب سامى فريد.. والذى صرخ في وجهه أنا لم أشحت بعد.. ماذا تريدون منى؟ أنا لم أطلب الكتابة في الأهرام.. ولست أريدها) حيث رأى في هذا العرض نوعا من المساعدة.. وعندما لمح الدموع في عيون سامى فريد طيب خاطره.. وقال له أنا أكتب في الهلال والمساء والتعاون مجانا.. لأنى عريسهم الذي يبيعون باسمه.. أما في الأهرام فسأكون ضمن كتيبة من الكبار وهذا لايهمنى كثيرا.

وفى سنواته الأخيرة اعتزل الحياة العامة – وعاش كما أراد في الظل.. وعندما دخل المستشفى في أيامه الأخيرة.. وكان يراوح ما بين الإفاقة والغيبوبة.. يترنم بشعر المتنبى وأبى فراس.. وكانت وصيته الأخيرة أن يدفن فور موته.. وألا تقام له جنازة أو ينصب له سرادق عزاء.. وألا ينشر نعيه إلا بعد دفنه ولذلك كانت جنازته بسيطة جدا.. سار خلفها عدد قليل جدا من الناس.. وقال البعض إن هذه الوصية هي دعابته الأخيرة.. من رجل عاش طوال عمره يعشق الدعابة.. ورأى البعض الآخر في تلك الوصية تجسيدا لرفضه الدائم للشكليات والمظاهر الفارغة.. وربما كان في تلك الوصية صفعة لهؤلاء الرسميين الذين تجاهلوه حيا- ولكنهم كانوا سيسارعون للاحتفاء به ميتا.. وقد رحل عن دنيانا قبل أن يتم عامة الثامن والثمانين بشهر واحد – رحل صاحب الإنجاز العظيم في الأدب والنقد واللغة.. من دون أن يحظى بالتكريم اللائق.. حيث حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1967 ثم منحته جامعة المنيا الدكتوراه الفخرية.. فأهداها مكتبته الخاصة – ومنحته فرنسا وسام فارس.. وفاز بجائزة الملك فيصل في القصة عام 1990.. وكل هذا أقل كثيرا مما يستحق ذلك المبدع الكبير قصير القامة – عظيم القيمة – النموذج الأمثل للإنسانية في أنبل معانيها.. ذلك المبدع الذي أدمن العطاء.. واكتسى دوما بالتواضع ولم ير إلا الجمال حتى في أبشع صور الحياة.. فهو القائل في كتابه خليها على الله (إن الحياة في أبشع صور الدمامة جميلة.. ولكننا لا نراها).






