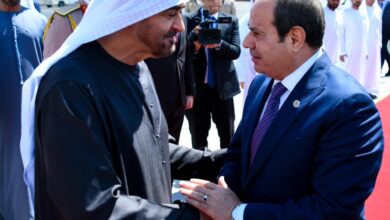المكتبة… علاء العلاف حين تصبح الكتب وطنًا آخر

طالما كانت المكتبة في ذاكرتي أكثر من مجرد غرفة تضجّ بالكتب أو مساحة تعليميّة تقليديّة، لقد كانت عالمًا آخر، بدايته طفولة ونهايته لا تزال مفتوحة على الدهشة … كنت في المدرسة الابتدائية حين بدأ أول خيط لهذا العشق، كنا ننتظر بشغف الحصة الأسبوعية المخصّصة للمكتبة، وكأنها موعد مع مغامرة جديدة. كانت الأرفف المزدحمة بالكتب تشبه عوالم لم نكن نعرف كيف نصفُها، لكنها تمسّ شيئًا في داخلنا لا نملك له اسمًا، لم تكن مجرد مكان بل كانت ملاذًا… منذ ذلك الحين، غدت المكتبة امتدادًا طبيعيّا للبيت وملجأً ألوذ إليه كلما ضاق الواقع أو اتّسعت الأسئلة أحببت الكتب لا لأنها تقرأ فحسب، بل لأنها تفتح نوافذ على حيوات لا تُحصى وتُعيد تشكيل وعينا بطريقة لا يفعلها شيء آخر القراءة بالنسبة إليّ لم تكن فعلاً ميكانيكيًا بل تجربة روحية تُغني الداخل وتوسّع أفق الرؤية وتصقل الإنسان فينا، القصص والروايات وأحداث التاريخ… لم تكن فصولًا تُطوى، بل محطات نقف عندها لنتأمل من نكون وكيف نكون، ولماذا نصبح على ما نحن عليه، وفي خضمّ تلك الرحلة، تبرز وجوه تركت أثرها فينا، وجوه من زمن الدراسة الأولى، حيث التعليم لم يكن تلقينًا بل غرسًا… أتذكّر بعض المعلّمين الذين لا تُقاس قيمتهم بما قالوه، بل بما كانوا عليه من سكينة ورحمة، كأنما في أرواحهم شيء من الطّمأنينة الإلهيّة، كان من أبرزهم الأستاذ يوسف مدرّس اللّغة العربيّة، لن أنسى حضوره اللافت ومظهره الأنيق وهندامه المتقن وحذاءَه الذي يلمع كما لو كان مرآة… لم يكن مدرّسًا فحسب، بل كان تجسيدًا للذّوق والفكر معًا… لم تكن أناقته سطحية، بل انعكاسًا لروح مرتّبة، كان يتقن لغته بلاغةً ومعنى، ويتحدّث بأسلوب يترك في النفس أثرًا عميقًا، كان نموذجًا فريدًا لمدرّس معاصر بكلّ ما تحمله الكلمة من رقيّ ودونَ أن يفقد العمق أو الوقار، كان مدرّسا من زمن لا يُشبه الحاضر كثيرًا… ولعلّ أجمل ما تُهديه القراءة للإنسان، هو هذا الامتلاء الداخليّ الذي لا يُرى، وهذه القدرة على التماس الأشياء من زوايا أكثر رحابة وإنسانية، فكلّ كتاب صادق يُقرَأ، هو مرآة جديدة ننظر بها إلى أنفسنا والعالم… وربما، هو مكتبة صغيرة في داخلنا لا تغلق أبوابَها أبدًا.