الشعر الحسّاس والشعر الفطري: بين وعي الجمال وغريزة الوجود:
بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.
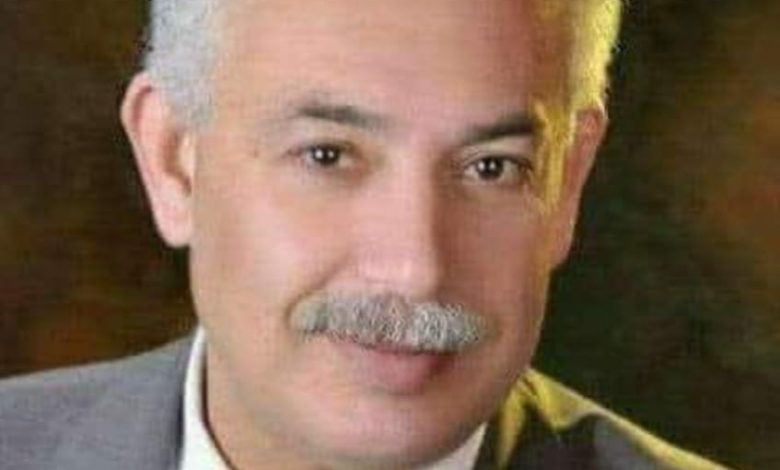
يُعدّ فريدريش شيلر (1759–1805) واحداً من أكثر العقول الألمانية عمقاً وتوهجاً، إذ لم يكن شاعراً فحسب، بل كان فيلسوفاً للحرية والجمال، ومؤرخاً يرى في الفن خلاصاً للروح من إسار الضرورة. وقد جمع في رؤيته بين الفكر الكانطي والخيال الغوتي، ليؤسس لما يمكن تسميته بـ”الوعي الجمالي بالوجود”، أي ذاك الوعي الذي لا ينفصل فيه الفن عن الفلسفة، ولا الحسّ عن الفكرة. ومن أبرز نصوصه الفكرية التي شكّلت علامة فارقة في النقد الأدبي والفلسفي على السواء، دراسته الشهيرة «عن الشعر الحسّاس والشعر الفطري»، التي تُمثّل محاولةً لتصنيف المبدعين لا بحسب الموضوعات، بل بحسب طبيعة الروح التي تُبدع.
يرى شيلر أنّ الشعر الحسّاس هو شعر التأمل الواعي، شعرُ الإنسان الحديث الذي انفصل عن الطبيعة وعن براءته الأولى، فصار ينظر إلى الجمال كغاية مفقودة، يسعى لاستعادتها بالتفكّر والفنّ. أما الشعر الفطري فهو شعر الإنسان الذي لا يزال متصالحاً مع الطبيعة، منسجماً مع كينونته، يعبر بلا انفصال بين الذات والعالم. بهذا المعنى، يصبح الشاعر الفطري — كما في نموذج هوميروس أو غوته — ابناً للطبيعة، يتنفسها ويعبر عنها بصفاء الغريزة الأولى. بينما الشاعر الحسّاس هو ابن الوعي الحديث، يتأمل العالم من بعدٍ، يعاني انفصاله عنه، ويحاول أن يُرمّمه بالكلمة، كأنّه يعيد صياغة الجمال لا من منبعه، بل من فقدانه.
إنّ هذا التمييز بين الوعي الفطري والوعي الحسّاس عند شيلر يُحاكي في عمقه الإشكالية الحديثة للفن: الصراع بين البراءة الأولى والحسّ النقدي، بين الغريزة والوعي. وقد رأى شيلر، كما أوضح في «رسائل في التربية الجمالية للإنسان»، أنّ الفن هو الوسيط الذي يُعيد التوازن بين الضرورة الطبيعية والحرية الأخلاقية. فحين يفقد الإنسان انسجامه مع ذاته، يأتي الجمال ليمنحه “اللعب الحرّ”، أي المجال الذي تتحرر فيه الروح من صرامة الواجب ومن غريزة المنفعة، وتستعيد إنسانيتها المفقودة.
وفي ضوء هذه الرؤية، يمكن القول إنّ الشعر الحسّاس هو شعر الوعي التاريخي والقلق الوجودي، أما الشعر الفطري فهو شعر الاتساق الكوني والبراءة الأصلية. ولعلّ هذه الثنائية تشبه ما أشار إليه نيتشه لاحقاً في تمييزه بين الروح الأبولونية والروح الديونيزوسية، أي بين النظام والفيض، بين الشكل والعاطفة. كما تتقاطع أيضاً مع رؤية هايدغر للشعر بوصفه “مأوى الكينونة”، حيث يصبح القول الشعري محاولة لاستعادة الأصالة التي ضيّعتها الحداثة.
في الأدب العربي، يمكن أن نجد صدىً لهذه الثنائية في تجربة المتنبي، الذي جمع بين فطرية القول وكثافة الوعي بالذات والوجود، وفي أبي تمام الذي جعل من الشعر مختبراً للعقل واللغة. كما نجدها في شعر محمود درويش، الذي يتأمل الوطن والذات بلغةٍ تجمع الحسّ التاريخي بالعاطفة الجمالية، أو في أدونيس الذي ينقّب عن أصل المعنى في رماد الحضارة. هؤلاء الشعراء يتحركون بين الحضور والغياب، بين الفطرة والوعي، بين ما يُقال وما يُستعاد من تحت ركام الزمن.
إنّ شيلر في تمييزه هذا لا يحاكم الشعراء، بل يكشف طبيعة المأزق الإنساني ذاته: الإنسان الذي خرج من الفردوس الطبيعي، ولم يعد بإمكانه أن يعيش إلا في الوعي بما فقده. وهنا، يتحول الشعر إلى ذاكرة للكينونة، وإلى جسر بين الإنسان والطبيعة، بين الحلم والواقع، بين اللهيب والرماد. فالشاعر الحسّاس، على خلاف الشاعر الفطري، لا يكتب من طمأنينة الكينونة، بل من جرحها، ولا من تماهيه مع العالم، بل من افتراقه عنه.
وهكذا، يصبح الإبداع فعلاً مزدوجاً: استعادةً وبراءةً، تأملاً وغريزة، حضوراً وافتقاداً. وكأنّ الشعر، كما يقول بول فاليري، “هو محاولة دائمة لقول ما لا يُقال”، أو كما يعبّر ريلكه: “الشعر ليس شعوراً، بل تجربةٌ في أعماق الوجود”.
إنّ جدلية الشعر الحسّاس والشعر الفطري ليست جدلاً أدبياً فحسب، بل هي مرآةٌ للروح الإنسانية في صراعها الأبدي بين البساطة المعاشة والوعي الموجِع. وإذا كان شيلر قد أراد من خلال فلسفته الجمالية أن يصالح الإنسان مع طبيعته عبر الفن، فإنّ هذه المصالحة لا تزال حتى اليوم حلماً بعيد المنال، لأنّ الشاعر المعاصر، كما قال أدونيس، “يكتب في زمنٍ فقدَ فيه العالمُ معناه، وصار عليه أن يخلقه بالكلمة من جديد”.
بهذا المعنى، فإنّ الشعر – في صورتيه الحسّاسة والفطرية – ليس فقط نغماً أو بياناً، بل هو موقفٌ وجوديّ، وسعيٌ نحو استعادة الإنسان في الإنسان.






