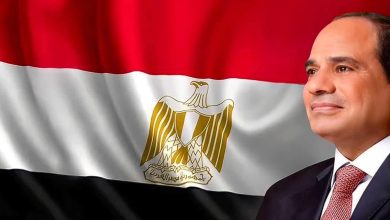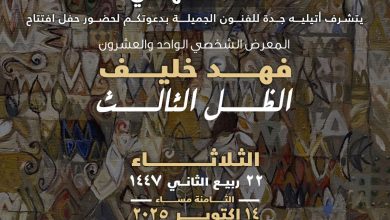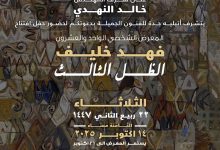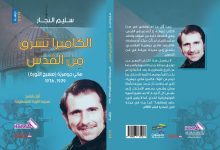منال رضوان تكتب “خطاب الروح” لنغم العيساوي: إعادة بناء الذات عبر شعرية الاقتصاد والتأمل
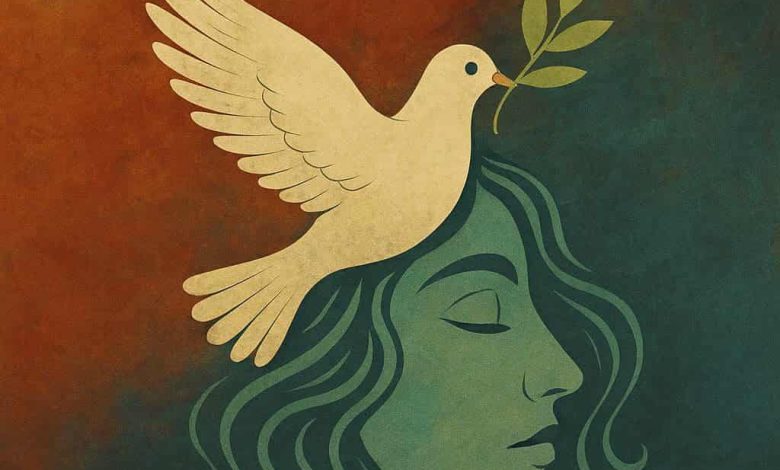
تشكّل مجموعة “خطاب الروح” للشاعرة العراقية نغم العيساوي تجربة شعرية تتجه نحو إعادة بناء الذات عبر اللغة بوصفها وسيلة انعتاق أكثر من كونها أداة توصيف؛ فالنصوص السبع والعشرون التي تتضمنها المجموعة تُقرأ ككِيان متصاعدٍ يتخذ من الروح مدارًا ومن الخطاب أفقًا، ليظهر في هذا الأفق الصوت الأنثوي الساعي إلى تحقيق توازن بين التجربة الشخصية والحمولات الوجودية، أو بين انفعال الذات في إطار العقل المعرفي، وإدراكها الماورائي في عالم مجهول هو عالم الروح.
تتحرك العيساوي داخل نصوصها ضمن نظام لغوي شديد الاقتصاد، يجنح إلى الإيجاز الكثيف الذي لا يُفقر الدلالة، فهي لا تُحمّل اللغة أكثر مما تحتمل، ولا تفرط في استخدام ألفاظ خانقة ضاغطة على انسيابية الفكرة أو عثرات في الحقل اللغوي تعيق رهافة الشعور، وإنما تُفجّر داخلها الطاقة الكامنة في البنية الإيحائية، والقصيدة لدى العيساوي وسيلة لتفريغ العاطفة في لمحتها الأولى سرعان ما تتحول إلى شكل من أشكال التفكير الوجداني الذي يُعيد تركيب العالم من منظور الذات الشاعرة.
تقول:
«يا أنايَ البعيدةُ عني
كيف تهربين من صمتي إليَّ؟
أيُّ نداءٍ هذا الذي يُوقظُ فيَّ غبارَ الأسئلة؟
أأنا التي كنتُ أم التي صارت بعدي؟
يداي ترتجفان وهما تكتبانني
كأنني أنحتُ ملامحي على جدارٍ من ضوء.»
هذه القصيدة نموذج دقيق على البنية الدائرية التي تشتغل عليها الشاعرة حيث تبدأ من سؤال الذات وتنتهي إليه، في حركة لغوية مغلقة تُحاكي دورة الوعي بين الوجود والانمحاء. هذا التكرار المضمَر في ضمير المتكلم (أناي، إليَّ، فيَّ) يُنتج نغمة داخلية قائمة على الجدل بين الانفصال والاتحاد، وهو الدليل الدامغ على أزمة الإنسان المعاصر وتمزقه، وهو ما يمنح القصيدة كثافة شعورية تتجاوز الإطار الوجداني إلى طرح أسئلة الهوية والكينونة.
توظّف العيساوي في نصوصها، وفي هذا النص بشكل خاص، صورًا تقوم على التجسيد الذهني لا الحسي؛ فـ”غبار الأسئلة” استعارة معرفية تشير إلى عبء الوعي، و”جدار الضوء” صيغة وجودية تجمع بين النور والعتمة، بين الظهور والحجب، في بنية تقوم على المفارقة. هذه المفارقة مبدأ تتبناه الشاعرة في بناء النص؛ إذ أن الذات لا تتشكل في وضوحها فقط وإنما في صراعها مع الغموض.
اللافت أن الشاعرة تُعيد تعريف العلاقة بين القول والصمت؛ فالصمت في تجربتها هو مجال الباطن وليس ضده أو نقيضه، لتتضح منطقة الانبثاق الأولى للقصيدة، حيث تتحول الكتابة فيها إلى فعل استدعاء لا إلى فعل إنتاج، وكأن القصيدة تُكتب من مكان خارج اللغة، من الحافة التي تلتقي فيها الروح بالعزلة والضجيج المنفلتة الوحدة من بين أطرافه.
من هذا المنطلق يمكن قراءة “خطاب الروح” بوصفه مشروعًا يتجاوز الشكل إلى رؤية شعرية متكاملة، تتأسس على محو الحدود بين التجربة الوجودية والتجربة الشعرية. فكل قصيدة في المجموعة ليست إلا مقطعًا من سيرة داخلية تُروى عبر شظايا الصور وتداعي الأصوات.
أما عن اللغة، فإن نغم العيساوي تمتلك وعيًا لغويًا حادًّا يجعلها قادرة على تحويل المفردة إلى كيان متحوِّل، لا يُستخدم بوظيفته المعجمية فقط وإنما يُعاد تشكيله في سياقٍ جديد. هذا الوعي يتجلى في طريقتها في تفكيك اللغة وإعادة تركيبها بما يعبّر عن التجربة الروحية في بعديها من حيث التأمل من جانب والمعاناة من جانب آخر.
لكن تظل ملاحظة واحدة راسخة، عاملة في نصوص نغم العيساوي ينبغي لنا الالتفات إليها، وهي حضور البُعد الأنثوي في المجموعة كحساسية لغوية تُعيد تعريف العلاقة بين الذات والعالم، لا مجرد ذلك الصوت الأنثوي الصريح؛ فصوت الشاعرة لا يتخذ موقع الضحية ولا المتحدّي، بل المتأمِّلة التي تُفكك التجربة الإنسانية عبر وعيها الجمالي. من هنا يمكن القول إن العيساوي تُرسّخ نموذجًا مغايرًا للشعر الأنثوي العربي الذي يصر البعض على تأطيره بداخل الفقد والخيانة والاحتياج للحنو والاحتواء. إن نموذج الوعي المتجاوز للنوع، والمنشغل بإعادة بناء الذات لا بتأكيدها، هو ما تأسست نصوص العيساوي عليه.
في الخلاصة، تُقدّم نغم العيساوي في “خطاب الروح” نصًّا متجاوزًا للتجريب الشكلي إلى تجريب الرؤية. قصائدها تقوم على الاقتصاد اللغوي، والانحياز للتأمل، وتفجير الدلالة من داخل الكلمة لا من محيطها. إنّها كتابة تسعى إلى ترميم ما انكسر في اللغة والروح معًا، عبر شعرية تعتمد البوح مادة أولى، والتجلي كغاية أخيرة.