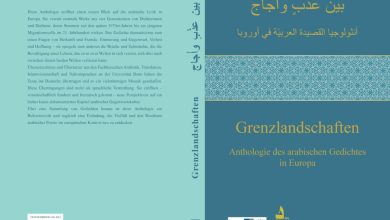“التعليم القائم على وظائف الدماغ”.. إصدار جديد للدكتور سعادة خليل
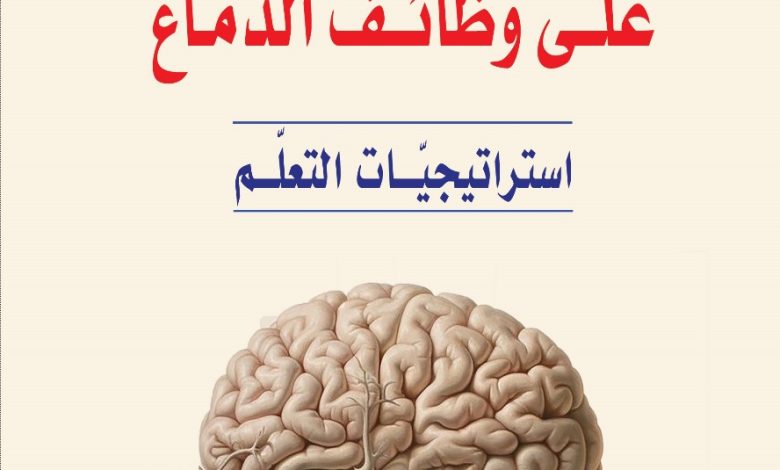
عمّان- متابعة أوبرا مصر
يأتي كتاب “التعليم القائم على وظائف الدماغ: استراتيجيات التعلم” للباحث الأردني د.سعادة خليل متماشياً مع ما يشهده الوقت الحاضر من تحولات عميقة في الفلسفة التربوية وأساليب التدريس، مقدماً بذلك إضافة نوعية في مجال الطرق المثلى للتعليم في القرن الحادي والعشرين.
ويمثل الكتاب الصادر حديثاً عن “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن (2026) دليلا ثوريا يسد الفجوة بين علم الأعصاب والفصول الدراسية كما أنه يستكشف كيف يمكن لفهم بنية الدماغ ووظيفته وتطوره أن يساعد المعلم على خلق بيئات تعليمية أكثر فاعلية وتفاعلا ودعما عاطفيا، دعوة حقيقية للتغيير الذي يبدأ من فهم الدماغ، ليمتد إلى الصفوف، وينعكس على جيل جديد من الطلاب والمعلمين، مؤكداً أنه في وقت تزداد فيه التحديات التربوية، يبدو أن الحلول لا تكمن في المزيد من الاختبارات أو المناهج، بل في العودة إلى الدماغ ذاته، العضو الأكثر غموضاً وقدرة في حياتنا، ليكون هو بوابة النهضة التعليمية المقبلة.
يشتمل الكتاب الواقع في 252 صفحة على ثلاثة عشرة فصلاً ينطلق فيها د.خليل من تجربة شخصية ومعايشة واقعية لطلاب أذكياء وفضوليين يفشلون ليس لعجز في قدراتهم، بل بسبب طرائق تقليدية للتدريس تعتمد على الحفظ والتلقين، وتغفل البعد العاطفي والاجتماعي للتعلم، ومن هنا يؤكد الباحث في مقدمته على أن هذا الكتاب يحاول الاستكشاف والتوليف ويمثل دعوةٌ للعمل، موضحاً أنه نشأ من التقاطع المثير بين علم الأعصاب وعلم التربية، فكلما فهمنا آليات الدماغ المعقدة، زادت قدرتنا على تصميم بيئات تعليمية تفاعلية وفعّالة وذات تأثيرٍ عميق، مبيناً: “في هذه الصفحات، سنتجاوز نماذج التدريس التقليدية لنتعمق في البنية الرائعة للدماغ نفسه. سنكتشف كيف تنشط الخلايا العصبية، وكيف تتشكل الذكريات وتسترجع، وكيف تؤثر المشاعر على التعلم، وكيف يلعب الانتباه والدافع والنوم أدواراً حاسمة في النجاح الأكاديمي”.
يركز الفصل الأول على “أساسيات وظائف الدماغ للمعلمين”، وفيه يشرح المؤلف الأدوار الحيوية للقشرة الجبهية، الحُصين، واللوزة الدماغية في عملية التعلم، مع توضيح أهمية “اللدونة العصبية” التي تكسر فكرة الجمود الذهني وتفتح الباب أمام النمو المستمر للطلاب والمعلمين معاً، أما الفصل الثاني فيؤكد على أهمية “الذاكرة والتعلم”، ويتناول فيه د.خليل أنواع الذاكرة (الحسية، والعملية، وطويلة المدى)، ويعرض استراتيجيات لتعزيزها مثل التكرار المتباعد، والتصور الذهني، وسرد القصص، مشيراً إلى أن بناء الروابط العاطفية مع المعلومات يسهم في ترسيخها بذاكرة طويلة الأمد.
أم في الفصل الثالث فيبحث في موضوعات “الانتباه، التركيز، والمشاركة”، ويعرض خريطة لشبكات الدماغ الثلاث المسؤولة عن الانتباه (شبكة التنبيه، شبكة التوجيه، الشبكة التنفيذية)، ويقترح استراتيجيات صفية تحفّز هذه الشبكات، مثل استخدام الحركة، والأنشطة التعاونية، وكسر روتين المحاضرات الطويلة.
وفي الفصول اللاحقة يناقش الكتاب موضوعات بالغة الأهمية من مثل: دور النوم، والتوتر، والدافعية، والعاطفة في نجاح العملية التعليمية، وكيف يمكن للمعلم أن يصمم بيئة صفية تراعي حدود الدماغ الطبيعية في معالجة المعلومات.. وهو لا يكتفي بعرض الجانب النظري من علم الأعصاب، بل يترجمه إلى خطوات ملموسة، مثل: تقسيم الدروس إلى وحدات قصيرة لمنع الحمل المعرفي الزائد، واستخدام تقنية بومودورو (25 دقيقة تعلم + 5 دقائق استراحة) كآلية صفية، وإدماج تقنيات اليقظة الذهنية (mindfulness) لتقليل التوتر وتهيئة الدماغ للتعلم، واعتماد الاختبارات القصيرة والأنشطة التفاعلية كوسائل لتعزيز ممارسة الاسترجاع. وبهذا، يقدّم المؤلف للمعلم أدوات قابلة للتطبيق، مع أمثلة عملية من الصفوف الدراسية.
ويحسب لهذا الكتاب أنه يتماشى مع موجة عالمية تعرف بـ”التعليم العصبي” (Neuroeducation)، وهي اتجاه حديث يدمج نتائج علم الدماغ في بناء السياسات التعليمية، فقد ظهرت في الولايات المتحدة وأوروبا العديد من البرامج التدريبية للمعلمين التي تركز على علم الأعصاب التربوي، كما أن جامعات عالمية مرموقة أنشأت مراكز أبحاث خاصة بهذا المجال.
ويحسب لهذا الكتاب اعتماد الباحث د.خليل على اللغة المبسطة رغم صعوبة المصطلحات العصبية، وحرصه على شرحها دون فقدان عمقها العلمي، كذلك مد الجسور بين النظرية والتطبيق، إذ هو لا يتوقف عند وصف الدماغ فحسب، بل يجيب دائماً عن سؤال “وماذا يعني هذا للمعلم في الصف؟”، ويؤكد الكتاب دوماً على البعد الإنساني، حيث يدمج الجانب العاطفي والنفسي في تفسير التعلم، ليجعل من الصف مكاناً لنمو الإنسان كله، لا مجرد تحصيل للمعرفة.