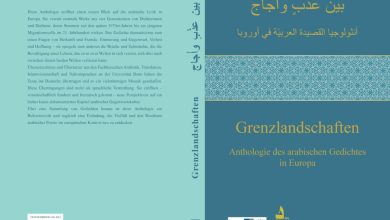خطوات على جبال اليمن: قراءة نقدية دكتور ربيع عبد العزيز أستاذ النقد الأدبي
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم

خطوات على جبال اليمن رواية للأديب السعودي: الدكتور سلطان سعد القحطاني، عدتها مائتان وخمس صفحات، بطلها محمد شرف الدين؛ الذي هوت قنبلة على جسم سيارة وهو يستقلها مع السائق وأحد المرشدين؛ فكان أن فقد ذاكرته، ووجد نفسه منبت الجذور عن ماضيه. وهو يعتقد أن اسم محمد شرف الدين؛ الذي كان يُنادى به عليه بعد الحادث، ربما يكون اسم السائق أو المرشد؛ فإن كليهما كان اسمه محمدا، وربما عثر الصليب الأحمر الدولي على الأوراق الرسمية الخاصة بأحد المحمدين فوضعها في جيبه. وقد ظلت ذاكرة محمد شرف الدين تغط في نوم عميق نحو ثمانية عشر عاما، أما أحداث ما قبل تلك الأعوام فقد سقطت من ذاكرته تماما.
ولقد آثر الدكتور سلطان سعد القحطاني أن يسرد الأحداث بضمير المتكلم غير عابئ بالسؤال المتطفل عن علاقة الكاتب بالذات الساردة . وللسرد بضمير المتكلم أثره في قدرة الروائي على تعقب العديد من دقيق التفاصيل في حياة البطل؛ مما أسهم في أن يصير البطل أكثر قربا من المتلقي، وأقدر على التأثير فيه وإثراء معرفته بالحياة وتقلباتها.
ويعول الروائي بشكل ملحوظ على تقنية “المونولوج” ليفصح بها عن الجانب الخفي من حياة البطل، ويهيئ- في الوقت نفسه – للمتلقي أن يسمع جانبا مما لا يبوح به البطل إلا لنفسه. كما يعول الروائي على تقنية الحلم؛ التي تسهم بدورها في كشف الغائر في أعماق اللاشعور من أحلام وكوابيس ظلت تلاحق محمد شرف الدين منذ خروجه من المستشفى، إلى أن استعاد ذاكرته وذاته قبيل نهاية الرواية، ثم عاد إلى جذوره.
في الإنعاش أمضى البطل ثلاثة أشهر كان خلالها عاجزا عن الكلام، وإن استطاع معرفة بعض الكلمات والأصوات التي كانت تتناهى إلى أذنيه؛ كالممرضة والطبيب والسرير والدواء والشاهي الأحمر والمسجد وصوت المؤذن. وإزاء كثرة ضحايا غارات الطيران الإنجليزي على أهل اليمن مسَّت حاجة المستشفى إلى الأَسِرَّةِ؛ فكان على البطل أن يغادرها نهائيا. وقبيل مغادرته جاءه من الإدارة مسئول أخذ يلف قطعة من القماش الأبيض حول خصره، ثم يهمس في أذنه: ” هذه نقودك يا محمد وجميع أوراقك”( ). ولبث البطل حائرا لا يدري إلى أين يمضي، وهو الذي لا يتذكر شيئا من أحداث ماضيه، ويواجه حاضرا ملبدا بالغيوم، ويواجه مستقبلا يبعث على اليأس.
وبدهي ألا يكون للزمن قيمة عند بطل بلا ذاكرة؛ فهو لا يعرف الشهور وحساباتها وأسماءها، بل يقيس الزمن بحركة الشمس والقمر ومواقيت الصلاة. وها هو ذا يناجي نفسه : ” هل للزمن في حياتي حساب، كما هو عند الآخرين؟ ! لا أظن أن الزمن يهم شخصا مثلي.”( ) وبدهي- أيضا- ألا يعرف أين هو على وجه التحديد، وكل ما يعرفه أنه يعيش في مدينة لا يعرف فيها إلا الشارع الذي يقع فيه المستشفى والمسجد، ولكنه حين تجول في الشارع ووجد مقهى لم يسعه إلا أن يلوذ به؛ ليرتشف قدحا من “الشاهي” الأحمر. ولما بادر إلى دفع ثمن الشاي تبين له أن الناس في تلك المدينة لا يتعاملون بالنقود التي يحملها؛ بحيث بدا وكأنما هو واحد من أهل الكهف، ولكن العم مصلح ؛ صاحب المقهى أدرك بحسه الإنساني أن الذي أمامه رجل غريب؛ فما كان منه إلا أن أخرج من جيبه مجموعة من النقود وأعطاه إياها.
عشرات الأسئلة تؤرق البطل وتتزاحم على عقله، غير أن سؤال المأوى كان الأكثر تأريقا له . وهو يبث أرقه مناجيا نفسه : ” أين أنام هذه الليلة؟ “( ) وقد أحس بفطرته أن صلاة العشاء في المسجد ستكون الحاسمة، ولم يخب إحساسه؛ إذ أبلغه المؤذن: الشيخ صالح أن في سطح المسجد غرفة صغيرة ستكون سكنا له حتى حين.
أهم ما كان يميز محمدا بعد أن بدأ يستوعب أزمته، أنه كان قوي العزم على أن يصير إنسانا يعتمد على نفسه، وبهذا العزم عرض على العم مصلح؛ صاحب المقهى، أن يعمل عنده صَبِيًّا، ولم يجد منه إلا ترحيبا. هكذا تسوق الأقدار للبطل من ينقذه من الضياع، ومن يعزز إحساسه بأن الله لن يترك دابة على الأرض بغير رزقها.
وعبر انتقال البطل من المستشفى إلى المقهى والمسجد ، وأخيرا إلى العمل مع الحاج علي في إصلاح أجهزة الراديو، كانت شخصيته تتطور؛ بحيث أبدى في زمن قصير تفوقا ملحوظا في إصلاح أجهزة الراديو، واكتسب لياقة التعامل مع الزبائن. ومع ذهابه وإيابه في المدينة؛ التي وجد نفسه فيها بمحض الصدفة، أدرك أنها مدينة صنعاء، وأن النقود التي كانت معه ليست يمنية.
ومن مكان مدني مثل صنعاء انتقل الكاتب بالبطل إلى مكان مدني آخر؛ فقد أوفده الحاج علي إلى مدينة عدن؛ ليشتري ما يلزم المحل من قطع غيار الراديو، فكانت رحلته إلى عدن بداية تطور حاسم في شخصيته وحياته ؛ إذ تعلم الاتجار في قطع غيار الراديو، ثم استطاع أن يفتتح محلا خاصا به بعد أن أَذِنَ له الحاج علي. كما أتم نصف دينه بالزواج من بلقيس. ومن صنعاء انتقل مع بلقيس إلى إحدى دول الخليج؛ لينخرط في تجارة الأقمشة.
ومع أن الإنجازات التي حققها عبر انتقاله بين الأمكنة كانت كفيلة بأن تمنحه سكينة في النفس، إلا أنه ظل يكبت في غائر أعماقه إحساسا قويا بالضياع، وحنينا جارفا إلى الجذور، ورغبة مُلِحَّةً في البحث عن الذات. وإلى ما سبق ترجع الأحلام والكوابيس التي كانت تلاحقه في يقظته حينا، وفي نومه أكثر الأحيان؛ ففي نومه ظلت تلاحقه امرأة عجوز ذات لباس أسود، وهي تردد على مسمعيه : ” مشكلتك لن تنتهي إلا كما بدأت.”( ) كما كان يرى- في أحلامه – أصدقاءه يتحدثون عما أنبأهم به العرافون؛ فيبعثه حديثهم على الذهاب إلى العراف لعله يجد لمشكلته حلا؛ فإذا العراف يقول له : ستزول كل مشاكلك عندما تتزوج، ثم يضيف مؤكدا ما قالته العجوز ذات الرداء الأسود : ” مشكلة لن تنتهي إلا كما بدأت” ( )، غير أن زواج محمد من بلقيس لم يقض على مشكلاته.
وتدل أحداث الرواية على صحة ما كانت تردده العجوز ذات الثوب الأسود من أن مشكلة محمد ستنتهي كما بدأت؛ ذلك أن مشكلته بدأت مع فقد الذاكرة، وأخذت طريقها إلى النهاية عندما سقط على رأسه في يوم ماطر، وبدأ يفقد ما تبقى من ذاكرته حتى إنه كان ينسى اسمه ولون سيارته ومكان بيته في صنعاء. وبالفحص الإشعاعي عولجت في مخه كدمات قديمة تركتها الحادثة التي أفقدته الذاكرة، فأخذ ينكر نفسه أمام الأطباء: ” أنا لست محمدا، ولست يمنيا”( ) ، ثم يناجي نفسه : ” بالتأكيد لي أب وأم، هذه سنة الله في خلقه…لم أهتم إن كان لي إخوة أو لم يكن قبل اليوم … ولكن حان الوقت للبحث عن جذوري”( ).
وأخذت ذاكرته تمده بأشياء قديمة جدا عن قريته وساكنيها، وبعض المعالم التي تحيط بها، وبعض المواقف السعيدة والتعيسة. ثم رأى أباه وأمه في الحلم . وبينما كان يقود سيارته ظهرت فجأة أمامه شاشة سينمائية كبيرة خلف السحب، ورأى فيها أباه وأمه كما رآهما بالأمس في الحلم، وعرف اسم أبويه ومكان قريته وأهله، ثم أمسك الهاتف واتصل بموظف الاتصالات لإيصاله بأحد أفراد عائلته. ومع قوة عزمه على استعادة ذاته ومعرفة جذوره استطاع أن يهاتف شقيقه ناصرًا، وأيقن أن اسمه محمد سعد الحمد وليس محمد شرف الدين. ولكي يؤكد لأخيه أنه شقيقه الذي فقده قبل ثمانية عشر عاما، أخذ يقول: ” أنت أخي ناصر، الثالث بين الأبناء، وأخي الأكبر علي، وأخواتي: نورة وسارة وهياء، وأمي فاطمة…”( ). وعندما عاد إلى بيته وجد شخصا يهاتفه من الفندق؛ طالبا مقابلته بأسرع ما يمكن، فأسرع إلى الفندق، واتجه بفطرته إلى شخص أمامه كأس من الشاي، فبادره بقوله: ” أهلا يا ناصر، قال: أهلا يا محمد”( ). هكذا كان سقوط محمد على رأسه بداية العثور على ذاته والرجوع إلى جذوره. وإذا كان للصدفة والمفاجأة أثر حاسم في معرفته اسم أبويه ومكان قريته وأهله، فليس هذا مما يضعف البناء الروائي؛ فمن منا لم تتدخل الصدفة والمفاجأة في حياته لتريحه من معاناته؟
الأنساق الثقافية:
تحفل الرواية بأنساق ثقافية ظاهرة ومضمرة؛ ففي نسق الذكورة والأنوثة نلاحظ كثرة الرجال : محمد شرف الدين، وصالح، ومصلح، والحاج علي، والشيخ يحيى، والأستاذ علي الشهاوي، والسائق علي محمد ، وصالح الصبري وأخيه محمود، والعم سعيد، وسعيد الماركسي، وعبد الرب ، وعمر باوزير الحضرموتي، ومنصر الفقي، وصيهود ، وأحمد شقيق بلقيس وشقيقها الآخر فارع، فضلا عن الأطباء، والضباط، والسائق العجوز، والمدرس وغيرهم من الشخصيات التي نسمع أصواتها دون أن يكون لها أسماء. وهذا العدد من الرجال يضمر في داخله فوقية ذكورية. أما أسماء الرجال فيختبئ في طواياها نسق ثقافة مجتمعية تعلي- في الأغلب- قيم الصلاح والكدح والتطلع.
كما نلاحظ أن من أسماء الرجال ما لا يرد إلا مسبوقا بألقاب وصفات تخفي في داخلها قيم المتكلم ونفسيته ونظرته إلى غيره؛ فاسم مصلح – صاحب المقهى- واسم سعيد لم يردا على لسان البطل إلا مسبوقين بكلمة العم، أما اسم علي – مصلح أجهزة الراديو- فلم يرد على لسانه إلا مسبوقا بكلمة الحاج. ولا شك أن تلك الألقاب والصفات تختبئ فيها قيمة الوفاء؛ وفاء البطل لمن أحسن إليه، وهي قيمة نبيلة يعمد الروائي إلى تسويقها فَنِيًّا دون وعظٍ.
وثمة أسماء رجال يختبئ في طواياها، نزوع الدكتور سلطان سعد القحطاني إلى الاختزال والحجاج؛ ففي حوار داخل السيارة يحتد النقاش بين الرُّكاب، فيقول سعيد الماركسي: ” لو كنتم رجالا لساعدتم أول ثائر عندكم، وهو الأسود العنسي، لكنكم خذلتموه لأنه أسود” ، ولكن عبد الرب يحاج سعيدا بقوله : ” يا جاهل، أنا مدرس وأعرف التاريخ أكثر منك. الأسود العنسي ليس أسود كما تظن، ولكنه كافر ثار على الدعوة الإسلامية، فكيف نساعد من ثار على ديننا؟ “( ) وإلى جانب حجاج المدرس عن الإسلام نجد أحد الرُّكاب الشيوخ يقول:” … لعن الله أبرهة الحبشي”( ) . ولقد اختزل اسم أبرهة مظالم عديدة استوجبت لعنته من أهل اليمن. حسبنا أن نعلم أنه كان إذا تأخر يمنيٌّ قليلا من الوقت عن المشاركة في بناء الكنيسة التي شيدها أبرهة، فإن جزاءه من أبرهة ورجاله هو قطع اليد. ومع أن الحديث مع سعيد الماركسي كان يتسع للحديث عن مكانة صحابي جليل ذي لون أسود مثل بلال بن رباح- رضي الله عنه – وعن إخفاقات نظرية ماركس، إلا نزعة الاختزال كانت ضرورة فنية نأت بالرواية عن الترهل، وهيأت للروائي أن يبقي على أزمة محمد شرف الدين حدثًا مركزيًّا يؤرق المتلقي.
وفي مقابل كثرة حضور الرجال وتردد أسمائهم وأصواتهم ، يتضاءل إلى حد بعيد حضور النساء وأسمائهن وأصواتهن؛ فباستثناء اسم بلقيس وأم حنان لا نجد إلا نساء لا أسماء لهن؛ كالممرضة السمينة ذات النظرات الغاضبة في مستشفى صنعاء، وزميلتها التي كان محمد يتجرأ على سؤالها، والشيخة المطوعة، وزوجة محمد شرف الدين الثانية. ويعد صوت بلقيس أكثر الأصوات النسائية حضورا ، لكنه لم يُسْمَعْ إلا في حالات قليلة؛ تارة داخل بيتها، وأخرى أثناء رحلتها إلى القاهرة طلبا للعلاج. وقد ظهرت – في باديْ الأمر- متزنة، راجحة العقل، متسقة مع قيم دينها ومجتمعها، وبخاصة عندما تقدم محمد لخطبتها- وهي الأرملة التي تعول طفلين- فكان أن سألته في حضور أخيها أحمد، والأستاذ علي، والعم مصلح، والشيخ يحيى: “هل هدفك من الزواج بناء أسرة ، وأنا أم لطفلين، أو هدفك سد فراغ؟”( ) فأجابها : ” هدفي بناء أسرة، ومن بناء الأسرة يحدث سد الفراغ، أما الأطفال فهم أبنائي. قالت: هذا ما عندي، والباقي عند أخي أحمد”( ).
وإذ تعلم بلقيس من الأطباء أنه لمن المستحيل أن تنجب مرة أخرى، تستسلم لقضاء الله ، وتبدي تساميا غير معهود في طبائع الكثرة الكاثرة من النساء المسلمات؛ إذ أصرت على ألا تغادر مصر إلا بعد أن تزوج زوجها بأخرى تتخيرها بنفسها، بل لقد رضيت بالعيش مع ضرتها في بيت واحد، ولكن هذا التسامي ينقلب إلى عصبية مقيتة عندما أنجبت ضرتها أنثى؛ فإذا بلقيس تغتم وكأنها الأب الجاهلي الذي يسْوَدُّ وجهه كلما بُشِّرَ بالأنثى، وإذا الشقاق يدب بينها وضرتها حتى بعثها على طلب أبغض الحلال، فكان لها ما أرادت.
عند الوهلة الأولى يبدو أن المضمر في موقف بلقيس من فكرة التعدد هو نزوعها إلى التمرد على النسق الأنثوي القار في مجتمعاتنا الإسلامية، ورغبتها في تحطيمه ؛ ففي إصرارها على أن يتزوج زوجها بأخرى وحرصها على أن تتخير الزوجة بنفسها، تتسامى على الأنانية والغيرة، وتبدي تسامحا غير متوقع، أما ما كان مضمرًا في أعماقها ؛ فهو أنها كانت تُمَنِّي نفسها بأن تنجب ضرتها ذكرا تسميه خالدا؛ بحيث يمنحها تعويضا نفسيا عن موت طفلها خالد، ولكن ضرتها أنجبت أنثى فإذا التسامي والتسامح ينقلبان نكدا وشجارا. إن التباين الحاد بين ما أظهرته من التسامي والتسامح وقمع الغيرة، وبين ما أشاعته في البيت من نكد وشجار لا لشيء إلا لأن ضرتها وضعت أنثى، يظهرها بمظهر من نسيت سهوا أو قصدا أن الله وحده هو الذي “يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ” (الشورى، الآية 49)؛ ولهذا لا أغالي إذا قلت: إن تمردها على النسق الأنثوي القار في مجتمعاتنا الإسلامية لم يكن صادرا عن اقتناع بتحطيم ذلك النسق، كما أن إصرارها على تزويج زوجها بأخرى لم يكن بدوافع إنسانية متجردة، بل كان لغاية في نفسها، وإلا ما فقدت اتزانها وتساميها، وآثرت أبغض الحلال على التسليم بإرادة الله.
وفي بيت محمد وبلقيس تردد قليلا جدا صوت الخادم الحبشية. وبقدر ما يضمر صوتها والإشارة إلى جنسيتها من طبقية، بقدر ما ينم عن تسامح الأنا مع الآخر، واحترام خصوصيته بغض النظر عن اختلافه لونًا وحضارة عن مخدوميه. وفي البيت نفسه يتردد صوت الزوجة الثانية في أقوال موجزة تدل على انصياع تام لأوامر الزوج ونواهيه.
كذلك يتردد في أحد بيوت صنعاء صوت امرأة كان محمد قد تقدم لخطبة ابنتها- قبل أن يتزوج بلقيس- فإذا هي تأمر وتنهى، وإذا وجودها يلغي وجود زوجها، وإذا هي تغلو في إملاء شروطها على العريس. ويضمر خطاب تلك المرأة تمردا على هيمنة النسق الذكوري، ونزوعا إلى إقصائه وتحقيره.
أما في أحلام محمد شرف الدين؛ فقد تردد صوت العجوز ذات الثوب الأسود؛ التي طالما كانت تقول له: ” قصتك طويلة يا بني…ولن تنتهي إلا كما بدأت”( ).
وأما المطوعة فقد تردد صوتها تغلفه الحكمة تارة ، ويغلفه العلم الغيبي تارة أخرى؛ فهي تنطق أمام المستجيرين بها بما يدل على معرفتها بأسمائهم وأسرارهم؛ لتؤكد لهم اتصالها بالأسياد من الأولياء؛ يؤكد هذا أنها تقول لمحمد على مسمع من صديقيه منصر وصيهود : ” أنت محمد شرف الدين… طلقت زوجتك الأولى قبل فترة من الزمن…تأتيك عجوز تخوفك في المنام… أسيادك الأولياء أخبروني بكل شيء…أمرك صعب ومعقد، والأمر لم يأت بعد من الأولياء، وأظنهم غاضبون عليك؛ فأنت لست طاهرا ولم تصل المغرب ولا العشاء…الحمد لله، هانت. الأولياء يطلبون منك الآن دفع مبلغ قدره.. وغدًا قبل هذا الوقت تذبح لهم خروفا أسود ليس له قرون…”( )
إن تسمية العرافة بالشيخة أو المطوعة لا تعني أن الدكتور سلطان سعد القحطاني يهادن التخلف والدجل، وإلا ما كشف ألاعيبها، وأشهدنا على ما نزل بها من العقاب بعد أن ضربت امرأة لتُخْرِجَ منها الجان؛ فإذا المرأة تموت بين يديها. وإنما تعكس تسمية الدجالة مطوعة أو شيخة نسقا إبهاريا وثقافة مجتمعية تخادع أبناءها، وتبعثهم على أن يستبدلوا بالاسم الحقيقي اسما يبهر أولئك الذين تمكن اليأس من نفوسهم، ويغريهم بالاستسلام لمطالب دجالة شاع عنها أنها شيخة مطوعة!
ولقد التمس محمد الشفاء عند الطبيب قبل أن يلتمسه عند الشيخة المطوعة. وما يهمنا هو أن حيرته بين الطبيب والشيخة المطوعة تخفي صراعا بين نسقين : نسق العلم كما يمثله الطبيب الذي التمس محمد عنده علاجا من الكوابيس التي كانت تطارده، فأخذ يشخص حالته بقوله : ” كل ليلة تأكلون خروفا (بحاله) فيزيد ضغط الدم على الدماغ وتكون عرضة للكوابيس. ( ما تأكلش) لحمة في الليل، ولا شاي، ولا تدخن ، ونم براحتك”( ). وإذ يلاحظ محمد أن تشخيص الطبيب لا يتطابق مع حالته يقول للطبيب: ” أنا لم أتعش ليلة البارحة، والغداء كان سمكا، ولا أدخن…وهذه الحال تلازمني منذ سبع عشرة سنة” ( )، ولكن الطبيب يقاطعه: ” كفاية.. كفاية” ، ويأخذ القلم ليكتب ستة أنواع من الأدوية. كما لاحظ محمد تناقضا بين شراهة الطبيب في التدخين، وبين ما ينصح به مريضه من ضرورة الكف عن التدخين؛ مما بعث محمدا على تمزيق الورقة التي سجل فيها الطبيب أنواع الأدوية، وإلقائها في سلة المهملات، فما كان من الطبيب إلا أن صاح به: ” .. مريض ومجنون” ( ).
أما النسق الآخر فهو نسق الخرافة. مؤكد أن محمدا كان ضحية تسمية الدجالة شيخة مطوعة؛ ففي أعماق هذين الاسمين من الإبهار ما يغري بالذهاب إلى صاحبتهما. ولو كنا نتحرى الدقة في تسمية كل ذي مهنة باسم مهنته الحقيقي ما كان لمحمد أن يلتمس الشفاء عند دجالة لا تملك أن تدرأ عن نفسها مرضًا.
وعلى أية حال فإن تضاؤل معدلات حضور صوت المرأة في الرواية يضمر تغليبا لمبدأ قوامة الرجال، أكثر مما يضمر إعلاء للنسق الذكوري أو تهميشا للنسق الأنثوي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ففي الرواية شخصيات تناقض إحداها الأخرى؛ فشخصية محمد شرف الدين التي تجسد قيمة الأمانة والوفاء ، تقابلها شخصية صيهود الخائن اللعوب؛ الذي غادر فجأة صديقيه : منصر ومحمد شرف الدين؛ ليبيع إلى العرافة ما لم تكن تعرف من أمر صديقه محمد، بحيث جعلها تبدو وكأنها عالمة بالأسرار، وجعل دجلها ينطلي على محمد ومنصر. وفي مقابل الزوجة التي تقصي زوجها وتلغي وجوده، نجد زوجة تنصاع لما يأمر به أو ينهى عنه زوجها. وفي مقابل أبرهة الحبشي الذي أذل أهل اليمن نجد في بيت يمني خادمًا حبشية لم يذلها أحد من أهل البيت، بل كانت تحظى باحترامهم وتقديرهم لخصوصيتها.
وفي الرواية متعلقات ثقافية؛ كالقيم والعادات والخرافات والأغاني الفلكلورية إلى غير ذلك مما يتسع له المخزون الاصطلاحي للثقافة؛ فمن تلك المتعلقات ما قوبل به محمد شرف الدين من تعاطف وحفاوة وكرم ضيافة خلال انتقاله بين صنعاء وتعز وعدن؛ ففي صنعاء تعاطف معه مؤذن المسجد: الشيخ صالح ومنحه غرفة فوق المسجد ليقيم فيها، وتعاطف معه العم مصلح ومنحه بعض المال عندما اكتشف أنه غريب. وفي تعز احتفى به أهلها فاستضافه صالح في بيته يومين.
وشبيه بما سبق قول العم علي مستدركا على ابن أخيه: “ليس من عاداتنا سؤال الضيف قبل أن يأخذ واجبه, أنسيت يا عمر؟”( )؛ فإكرام الضيف مقدم على معرفة اسمه؛ ذلك أن اسمه قد يكون باعثا على الضحك أو الانقباض أو استعادة عداوة قديمة مع أهله؛ ولهذا فالمضيف ملتزم بإكرام ضيفه انصياعا للعادة ، وتغليبا للواجب على ما سواه. وهذه المتعلقات تختبئ في داخلها عادة متجذرة في الشخصية العربية؛ وهي إكرام الضيف .
وتسجل الرواية متعلقات ثقافية مدنية؛ منها المعاملات اليومية؛ فالذين كانوا يعملون مع عمر لم يكونوا يتقاضون رواتب شهرية، بل كانوا يتقاضون نسبة من الأرباح، ويحرصون على تسجيل عمليات الشراء والبيع؛ يقول عمر: ” كلنا نشتغل ونكسب ولكل نسبته من الأرباح…وليس هناك ما يباع أو يُشْترَى ، ولا يُسَجَّلُ” ( ). ولا شك أن هذا النظام من التعامل يجعل الجميع شركاء لا أُجَرَاء، وهو أدعى لا إلى أن يحافظوا على رأس المال فحسب، بل إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم؛ حتى تكثر أنصبتهم من الأرباح.
ومن تلك المتعلقات المدنية أن عمر يخصم نسبة من أسعار قطع غيار الراديو. وإذ يشعر محمد شرف الدين أن الخصم لصالحه يقول: ” بالله عليك لا تخصم شيئا من أجلي؛ فأنا ناقل خير، وليس لي ناقة ولا جمل” ولكن عمر يرد عليه رد التاجر الفطن: ” أنا لا أخصم لك لأخسر، ولكن أخصم لك من الأرباح؛ فمكسب الزبون عندي أحسن من الربح الفوري”( ). ومثل تلك المعاملات اليومية أدل على أن للمدينة متعلقاتها الثقافية التي تختلف عن متعلقات البوادي والقرى والنجوع.
لغة الرواية:
برغم أن الفصحى هي اللغة الأكثر سيادة في رواية خطوات على جبال اليمن، فقد استطاع الدكتور سلطان سعد القحطاني أن يُعدد مستوياتها؛ فهناك المستوى التعبيري في قول محمد شرف الدين:” صنعاء هي بيتي وأهلي وروحي” ( ). وشبيه بما سبق قوله: ” مشيت أذرع شوارع صنعاء وفي داخلي ضحكة باكية” ( ). وتعكس لغة هذا المستوى ما تضطرب به نفس المتكلم من أحاسيس، كما يكثر هذا المستوى في لغة محمد شرف الدين بصفة خاصة؛ ومرد ذلك لا إلى كونه أكثر شخصيات الرواية حضورا وتحريكا لأحداثها فحسب، بل إلى كونه – أيضا- الشخصية التي واجهت أزمات مركبة لم تواجه مثلها شخصية أخرى في الرواية.
وإلى جانب المستوى التعبيري من لغة الرواية هناك المستوى المرجعي الذي تتنوع مصادره ؛ فلغة القرآن تتردد أصداؤها في قول محمد شرف الدين مناجيا نفسه: ” وأيقنت أن الله لن يترك دابة على الأرض”( ) ؛ فالصياغة اللغوية في كلام محمد تحيل إلى مرجعها القرآني في قوله تعالى: ” وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها”( هود، آية : 6)، وهي صياغة تنم عن أن فداحة الخطوب لم تهزم يقين المتكلم المتعين بالفعل أيقنت بكون الله هو المتفرد بأرزاق مخلوقاته.
وفي لغة العم مصلح أثر قوي من لغة القرآن؛ آية هذا قوله يخاطب محمد شرف الدين: ” الظلم من طباع البشر أكثر من الحيوان؛ فقديما كان هناك أحد الرعاة له تسع وتسعون نعجة، ولأخيه نعجة واحدة، ولم يقنع ذلك الثري بما عنده، فأخذ نعجة أخيه، ليكون عنده مائة.”( ) إن كلام العم مصلح يحيل إلى مرجعه القرآني في قوله تعالى: ” إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة”( سورة ص، آية : 23).
وقد تصل الملفوظات المرجعية في لغة بعض الشخصيات إلى حد الاقتباس من القرآن؛ فالعم مصلح ينصح محمد شرف الدين بالتحلي بالصبر بوصفه مفتاحا للفرج، ثم يقتبس قوله تعالى: ” فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا” ( الشرح، الآية 5 : 6)؛ وذلك لكي يضفي على نصيحته سندا قرآنيا يعظم يقين محمد بأنه مهما طال به العسر فلابد من أن يعقبه اليُسْرُ.
كذلك نجد في لغة الشخصيات أثرًا واضحًا من لغة الحديث النبوي؛ فأحد خطباء الجامع الكبير في صنعاء يقول: ” إن الجنة محفوفة بالمكاره”( ). وفي صحيح الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: ” حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره”.
والشيخ يحيى شرف الدين يخاطب محمدا مستدعيا قول النبي الكريم: ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج” ( ). وهو لكي يغري محمدا بالزواج من بلقيس، مع كون محمد شابا وبلقيس أرملة تعول طفلين، يحتج بقول النبي الكريم: ” أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة” ( ).
ومن الشخصيات من ينوع الروائي لغته بأقوال الشعراء؛ فالأستاذ علي يردد قول الشاعر:( )
مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أضحى كلانا يعاف النوم جفناه
وكما تأثرت لغة الشخصيات بالقرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي، تأثرت أيضا بأمثال العرب؛ آية هذا أن محمد شرف الدين برغم أن علاقته بأصدقائه لم تنقلب إلى عداوة فإن وفاءه لهم يبعثه على تأنيب نفسه بعد أن سافر دون أن يودعهم ، فيقول: ” … ولكني قلبت لهم ظهر المجن”( )؛ فهذا القول ليس من كلام محمد، إنما هو مثل عربي قديم يُضْرَبُ حين تنقلب أحوال الأصدقاء والأحبة من النقيض إلى نقيضه( )، ولعل أصله في قول الأحوص يشكو تَقَلُّبَ محبوبته:
قلبتْ لي ظهرَ المجنِّ فأمستْ قـدْ أطاعتْ مقالة الأعــــداءِ
كذلك تأثرت لغة الشخصيات بأمثال العرب ؛ كما في قول محمد شرف الدين : ” من لا يُغَبِّرُ شاربًا ما دَسَّمَه ” ( )؛ وهو مثل يضرب في الحث على العمل وتحمل مشاقه ولو ران الغبار على شوارب الرجال.
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الروائي كثيرا ما يتحرى المشاكلة بين الملفوظات المرجعية، وبين السياقات التي تستدعيها. ومن يتأمل ما جرى به لسان يحيى شرف الدين من قول النبي الكريم: ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج” يجد المتكلم بالحديث شيخا أزهريا وليس رجلا من عامة الناس، ويجد المخاطب بالحديث شابا له حرفة تدخله في زمرة من يستطيعون الباءة، ومن ينقصهم الانصياع للأمر النبوي: ” فليتزوج”.
وبرغم سيادة الفصحى على ألسنة شخصيات الرواية فقد عمد الروائي إلى تطعيمها بألفاظ عامية ؛ منها كلمة ” السلتة “( ) ؛ وهي وجبة عشاء، ومنها ” بنت الصّحن”( ) ؛ وهي نوع من الحلوى. ولعل الروائي أراد أن يرفع بصمة المكان قبل أن يمحوها طوفان الحضارة المعاصرة ، وبخاصة أنه لمن المتعذر أن نجد في معاجمنا القديمة أو المعاصرة ما يرادف هاتين الكلمتين.
ويبقى أن أشير إلى أن الرواية لم تخل من تعرية عيوب الواقع ونقد الانبهار بالآخر؛ فمحمد شرف الدين يشخص حالة زبائن المقهى بقوله: “كان الزبائن يستمعون إذاعة لندن ونشرة الأخبار عن الحرب الدائرة رحاها في شمال البلاد، فأي خبر لا يأتي من إذاعة لندن، لا يعتبر خبرا صادقا”( ). وهذا الانبهار بالآخر يذكرنا- من بعض الوجوه- بحالة الانبهار بالإنجليز؛ التي سيطرت إلى حين على إسماعيل؛ بطل يحيى حقي في قنديل أم هاشم.