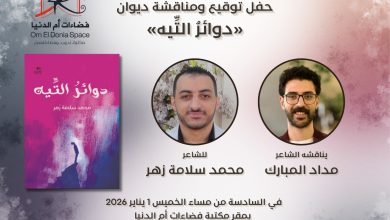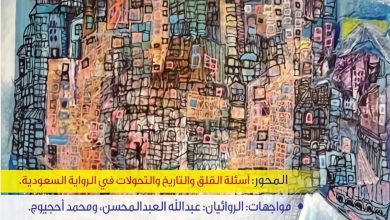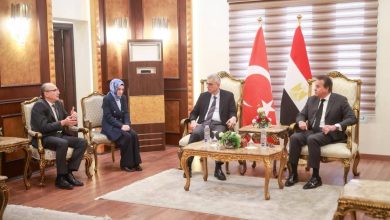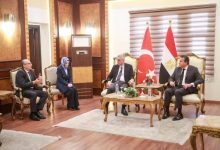عماد خالد رحمة دراسة هيرمينوطيقية–أسلوبية– رمزية في قصيدة «نشيد اللا جدوى»
قصيدة منال رضوان

تقرأ هذه الدراسة قصيدة «وسط هذا الهراء» عبر تضافر ثلاثة آفاق منهجية: الهيرمينوطيقا التأويلية (غادامير، ريكور)، الأسلوبيات البنيوية–الوظيفية (ياكوبسون، ليتش)، والرمزية–التحليل النفسي (يونغ، باشلار، كريستيفا). نبيّن كيف تبني الشاعرة د. منال رضوان خطاباً يُعلِّق المعنى بواسطة لازمة «ليس مهمّاً»، فيحوّل النفي من حكم قيمة إلى استراتيجية إنشائية لإرجاء الدلالة وتوليد توتّر بين الصوت والمعنى. وفي العمق يتبدّى نقدٌ أنطولوجي للغة ذاتها: حين «تخوننا الأبجديات» وتغدو «اللغة مقبرة» تصبح كتابة الـ«أنا» لحظةَ تلعثمٍ كاشفٍ، لا عجزاً بل أخلاق قول تقاوم فصاحة الزيف.
–تمهيد: مرافعةٌ في المنهج المركّب.
_ الهيرمينوطيقا: ننطلق من «اندماج الآفاق» عند غادامير؛ فالمعنى ليس معطًى كاملاً بل يتحقّق في لعبة السؤال–الجواب التي يعقدها النص مع قارئه، ومن تمييز ريكور بين «تفسير» العلامة و«تأويل» الرمز؛ حيث الرمز «يعطي للتفكير أكثر مما يقول».
_ الأسلوبيات: بحسب ياكوبسون الوظيفة الشعرية تجعل الرسالة تحيل إلى ذاتها؛ لذا نفحص الانحرافات والتركيبات والإيقاعات بوصفها مولّدات دلالة (ليتش). .
_ الرمزية/التحليل النفسي: نستعين بمفاهيم يونغ (الظلّ)، وباشلار (خيال المادّة: هواء/معدن/طين/زجاج)، وكريستيفا (التوتّر بين السيميائي والرمزي) لفهم دراما الذات واللغة.
ليس القصد تثبيت «معنى أخير»، بل إظهار كيف يعمل النص: كيف يُنتج قارئَه ويُعيد تشكيل حساسيته.
— أولًا: عمارةُ النفي – بلاغة «ليس مهمًّا».
1. من الحكم إلى الإنشاء.
_ تتواتر اللازمة: «ليس مهمًّا»، «لم يعد مهمًّا»، ثم يتحوّل الإيقاع إلى شرطٍ: «طالما…». هذا التحوّل من حكمٍ خبري إلى إنشاءٍ شرطي يشي بأن النفي ليس وصفاً للعالم، بل تقنية لتعليق القيمة. وفق ريكور، النفي يؤسّس فراغاً قابلاً للاحتشاد بالرمز.
2. اقتصاد «طالما»: شرعنة اللامبالاة.
تحوّل «ليس مهمًّا» إلى «طالما» يربط اللامبالاة بسببٍ بنيوي: «طالما أن الظلال تعوي…»، «طالما أن القلب… يتلعثم…». إنّه منطقُ تبريرٍ وجودي: ما دام الجذر معطوباً، فإن كلَّ إصلاحٍ للسطح لغوٌ بصريّ.
3. الإطار التلفّظي: من المتكلّمة المفردة إلى «العجوز الصمّاء»
تظهر شخصية «العجوز الصمّاء» كقناعٍ تلفّظي يردّد، فتتضاعف «الأنا» بين صوتٍ يائس وضميرٍ جَمْعيّ. هذا التوزيع يُبرِّد العاطفة ويمنح الخطاب سلطة «الخبرة» المستكينة.
—ثانيًا: جغرافيا الصور – خيالُ المادّة والاتجاه.
1. الكفّ الساقطة عن ذراع الحقيقة.
«الكفّ» أداةُ لمسٍ وتملّك؛ سقوطُها عن «ذراع الحقيقة» يجرّد الحقيقة من جهازها الحِسّي. في خيال باشلار، السقوط كثافةٌ مادّية توحي بانهيار «جسر» بين المعنى والواقع: لا يدَ للحقيقة على ذاتها.
2. الذئب المتمرّغ في حجراتٍ باردة
الذئب – رمز الظلّ اليونغي – لا يفترس، بل «يتمرّغ»؛ تُستبدل الفعاليةُ الوحشية بمتعةٍ خاملة داخل «حجرات باردة». الحجرة هنا ثلاجةٌ نفسيّة تُحنِّط الدافع، فيغدو الخطر صامتًا مُقيمًا.
3. ريحٌ تلعق الوجوه بلا أسى.
فعل «اللّعق» يجمع الحميمية بالمهانة. عنصر الهواء الذي يمنح الحرية يتحوّل لمسًا محايداً؛ طقس تعويم للسمات حيث تفقد الوجوه فرادتها.
4. يَصدأ الزمن / تتعفّن الذاكرة في جرار طين.
تزاوجُ المعدني (الصدأ) والعضوي (التعفّن) يُؤسّس ميتافيزيقا التدهور. «جرار الطين» – وعاء الحفظ الشعبي – تحفظ فساد الذاكرة لا ذاكرتها، في مفارقةٍ تكشف تاريخًا مكبوتاً.
5. الضوء يراوغ قبح انعكاسه.
انقلابُ الضوء من كاشفٍ إلى مخاتل ينقض ميثاق التنوير: الحقيقة لا تتجلّى؛ إنّما تتخفّى من صورتها في المرآة. هكذا تُسائل القصيدة ثقة الحداثة بالمرآة والبلّور.
_ 6. الوجوه المبلّلة والحنجرة المسمومة.
_ السلسلة: «نداءات لم تُسمَع/ كلمات لم تُنطق» ترسم فجوة تداولية: أثرٌ صوتي بلا مخاطَب، ولغةٌ يموت جنينها قبل الوضع. هذا هو السيميائي المكبوت عند كريستيفا: دَفْقٌ غريزيّ يُخنق في الحنجرة.
_ 7. كسر البلّور وتعتيـم المرايا
أدوات الانعكاس (بلّور/مرايا) تتحوّل موضوعًا للعطب (الكسر/الإعتام). إنّه عزلٌ للذات عن صورها كآلية دفاع ضد استبداد المرئي.
_ 8. عواء الظلال ونقر الأصداء.
تجسيدُ المجرد (للظلّ عواء، وللأصداء أظافر) يشي بـاحتلال الأثر للأصل: العالم يُدار بالظلال لا بالأشياء. إنّه منطق التمثيل الطاغي، حيث الأصداء أشدُّ حضورًا من الأصوات.
_ 9. خيانة الأبجديات/ اللغة مقبرة/ القصيدة نحيب مدفون حيًّا
ذروةُ المأساة المِتا–شعرية: انقلاب الوسيط على المُرسَل. حين تخون الأبجدية، تُدفن القصيدة – التي تُنشِد الحياة – حيّةً داخل لغتها. مفارقةٌ تجمع الأوكسيمورون (حياة/دفن) بنقد وظيفة الشعر.
_ 10. تلعثم «أنا».
الختام يثبّت بلاغة التعثّر: كتابة «أنا» تتلعثم. ليس هذا عجزاً بل تعالياً أخلاقيّاً على فصاحةٍ لا تُطابق الجرح. هنا تتجلّى هوية مجروحة (ريكور) لا تلتئم إلا بسردٍ ناقص.
—ثالثًا: البنية النفسية للمتكلّمة.
1. خَدَر عاطفي: مفردات البرودة والحياد («بلا أسى/ حجرات باردة») تدل على آلية تحقير الحدث دفاعًا عن الصدمة.
_ 2. ازدواج السطح/العمق: سطحٌ منضبط (نفيٌ متكرّر)، وعمقٌ يعوي (الذئب/الظلال). يعجز الأنا عن تكامل ظله (يونغ)، فيظلّ الصراع قائمًا بين الكبت والتسريب الاستعاري.
_ 3. سيمياء الجسد: «حنجرة مسمومة/ قلب يتلعثم»؛ الجسد لوح كتابة يتجلّى عليه اضطراب القول.
—رابعًا: قراءة أسلوبية دقيقة
_ أ. المعجم الحقلي
^ التدهور: يصدأ، يتعفّن، مقبرة، يُدفن…
_ الشفافية/الانعكاس: بلّور، مرايا، ضوء، انعكاس…
_ الحسّيات الخشنة: تلعق، تنقر، أظافر…
_ البرودة/الخواء: حجرات باردة، بلا أسى، الظلال…
هذا التوزيع يخلق تَراكُبَ حقول يُنشئ شبكة دلالية تُهيمن عليها مادّية مُعتِمة.
_ ب. الصيغ والتركيب
_ التوازي التركيبي في بدايات الأسطر يرسّخ إيقاعًا إنكارياً.
_ التحوّل من الجملة الاسمية إلى الفعلية («لم يعد…»، «تنقر…») يواكب تحوّل الموقف من ثباتٍ عدميّ إلى حركة ظلال.
_ استخدام أدوات الشرط («طالما») يشرعن تعليق الفعل.
_ ج. الأصوات والإيقاع.
القطع بعلامات الوقف والتعجّب والاستفهام («ليس مهمًا؟!») يصنع تذبذبًا نغميًّا بين التصديق والشك.
تمفصل الحروف الحلقية (ح، خ) مع الصوامت القاسية (ق، ظ) يمنح المشهد خشونةً سمعية ملائمةً لبلاغة التعثّر.
_ د. الصور البلّورية/المرآوية
تظهر المرايا والبلّور بوصفهما مكوّنين بصريين يتعرّضان للتعطيل. هذه سياسة تفكيك للمرئي لصالح سماع ما قبل-لغوي (العواء/النقر).
–خامسًا: الدائرة التأويلية – من المعنى الحرفي إلى الدلالة الوجودية
_ 1. حرفيًّا: عالمٌ فاسد، قِيم تتساقط، لغة عاجزة.
_ 2. رمزيّاً: انهيارُ علاقة الذات بوسائط إدراكها (يد/عين/حنجرة/قلب). إنّه خللٌ في قنوات المعنى.
_ 3. وجوديًّاً: المأزق ليس في العالم فحسب، بل في اللغة التي نصف بها العالم؛ لذا كان الحلّ الجمالي: الاعتراف بالخرس النسبي وتبنّي بلاغة التلعثم كـ«قولٍ صادق».
—سادسًا: مقارنات وتقاطعات .
_ مع بلانشو: فكرة «الكلام الذي يلامس حدَّ الصمت»؛ القصيدة تقترب من عَتَبة العيّ دون أن تسقط فيها.
_ مع أدونيس ومجاز المرآة: لكنّ قصيدة رضوان لا تؤسطر المرآة بل تعتمها عمداً.
_ مع سيوران: عدميّة رشيقة، غير أنها هنا عدميّة أخلاقية تُدين البلاغة لا الوجود.
—سابعاً: أسئلة للبحث والمتابعة.
1. كيف تتبدّل لازمة «ليس مهمًّا» داخل دواوين أخرى للشاعرة؟ هل هي نبرة مرحلة أم بنية مكرّرة؟
2. ما علاقة ثنائية (المرئي/المسموع) بتجربة جيلية أوسع في الشعر العربي الراهن؟
3. هل يمثّل «تلعثم الأنا» جِناسًا وجوديًّا لقلق الهوية النسوية بين الصوت الخاص والخطاب العام؟
—خاتمة: نحو أخلاق التلعثم.
لا تُنهي القصيدة العالمَ بنفيٍ شمولي، بل تضمّنُه داخل معمارٍ لغويّ يكشفُ هشاشته. وحين تكتب الأنا – «متلعثمةً» – فإنها تُعلن ميثاق صدق جديداً: أن نمنح الجرح حقّه في تعطيل الفصاحة. هكذا تتحوّل العدميّة الظاهرية إلى يقظةٍ نقدية تهدم مرآة الزيف لتُبقي نافذة السؤال مفتوحة.
— ملحق: مقاربة مقطعية للأسطر المفتاحية.
«ليس مهمًّا ما يحدث»: تعليق القيمة/_ افتتاح الإطار الإنكاري.
«الكف الساقطة عن ذراع الحقيقة»: تعطيل أدوات الإثبات.
«الذئب المتمرّغ في حجرات باردة»: تجميد الظلّ/الغريزة.
«الريح التي تلعق الوجوه بلا أسى»: تعويم السمات الفردية.
«أن يصدأ الزمن/ تتعفّن الذاكرة»: ميتافيزيقا التدهور.
«الضوء يراوغ قبح انعكاسه»: انقلاب التنوير إلى مخاتلة.
«الوجوه…/ الحناجر…»: فجوة تداولية بين النداء والنطق.
«نكسر البلّور/ تعتم المرايا»: احتجاج بصري على سطوة الصورة.
«خيانة الأبجديات/ اللغة مقبرة/ القصيدة نحيب مدفون»: مأزق مِتا–شعري.
«القلب… يتلعثم…: أنا»: أخلاق التعثّر وميثاق الصدق.
نص القصيدة :
وسط هذا الهراء..
ليس مهمًا ما يحدث،
الكف الساقطة عن ذراع الحقيقة،
الذئب المتمرّغ في حجرات باردة،
الريح التي تلعق الوجوه بلا أسى!
ليس مهمًا أن يصدأ الزمن،
أو تتعفّن الذاكرة في جرار من طين،
الضوء يراوغ قبح انعكاسه…
الوجوه مبلّلة بنداءات لم تُسمَع،
الحناجر مسمومة بكلمات لم تُنطق،
ليس مهمًا؟!
لم يعد مهمًا، العجوز الصماء تردد:
أن نكسر البلّور،
أو نترك المرايا تعتم في نوافذ الرغبة،
طالما أن الظلال تعوي خلفنا
تنقر الأصداء بأظافرها الجائعة
ليس مهمًا أن تخوننا الأبجديات،
أن تصبح اللغة مقبرة،
والقصيدة نحيبًا يُدفن حيًا،
طالما أن القلب، في عمقه الأبعد،
لا يزال يتلعثم حين يكتب:
ـ “أنا” !!