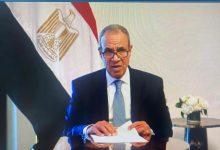أ.د ربيع عبد العزيز يكتب القصة الومضة/ الرواية القصيرة من التجنيس إلى الخصائص

دكتور ربيع عبد العزيز
أستاذ النقد الأدبي
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم
من المسلم به أن الحياة في جدة مستمرة، وأن الأدب يجب لا أن يتجدد مع الحياة فحسب، بل يجب أن يقود الحياة ويستشرف آفاق المستقبل، شرط أن يظل محتفظا بأدبيته التي تعطيه شخصيته المستقلة عن الكتابات التاريخية والفلسفية والنفسية وغير ذلك من الكتابات .
نحن الآن نعيش في عصر السماوات المفتوحة وانهمار المعارف عبر الفضاء العنكبوتي، الذي صبغ الحياة بصبغته جاعلا إيقاعها سريعا كالومضات الخاطفة. ولا بد للأدب أن يتأثر بهذا الإيقاع السريع، وأن ينزع الأدباء إلى التجريب وإلى إبداع كتابات جديدة قد تكون ناضجة مقبولة وقد تكون لاهثة حائرة بائرة.
ولكن التتبع التاريخي لنشأة ما يسمى بالقصة القصيرة جدا يثبت أن عالمنا العربي عرف هذا اللون من فنون السرد قبل ظهور الشبكة العنكبوتية؛ ولعل مجموعة ” دمشق الحرائق” التي نشرها زكريا تامر عام 1987م من أسطع الأدلة على أن نزعة التجريب والاتجاه إلى كتابة هذا الفن لم يرتبطا بثورة الاتصال وظهور الشبكة العنكبوتية.
وغير دقيق بالمرة القول بأن هذا الفن جاء تلبية لحاجة المتلقي العربي إلى الأدب التلغرافي الذي ينحو نحو التكثيف والاقتصاد اللغوي، بل الصحيح أنه جاء ثمرة لمحاولات التجريب والتجديد. أما أنه يلبي حاجة المتلقي العربي إلى التكثيف فمردود عليه بأن المطابع لا تزال تطبع روايات طويلة تجد من يقرأها في عصر الإيقاع السريع والانهمار المعرفي والفضاء العنكبوتي؛ أذكر منها تمثيلا لا حصرا: رواية شيكاجو للدكتورعلاء الأسواني، ورواية مطر على بغداد للأديبة هالة البدري، ورواية أحببتك أكثر مما ينبغي للأديبة أثير عبد الله النشمي، ورواية الأسود يليق بك للأديبة أحلام مستغانمي.
ويعاني فن القصة الومضة من تعدد ألقابه المصطلحية؛ يؤكد هذه المعاناة أن أحمد جاسم الحسين أحصى لهذا الفن في كتابه القصة القصيرة جدا، الصادر عن دار التكوين في سوريا عام 2010م سبعة عشر لقبا مصطلحيا، وهي” القصة القصيرة جدا، القصة الومضة، القصة اللقطة، القصة القصيرة للغاية، القصة المكثفة، القصة الكبسولة، القصة البرقية، اللوحة القصصية، الصورة القصصية، النكتة القصصية، الخبر القصصي، القصة الشعر، الخاطرة القصصية، القصة الجديدة، القصة الحديثة، الحالة القصصية، المغامرة القصصية” وهذا الفيض من الألقاب المصطلحية يعكس فيوضا من اضطراب المفاهيم وغياب التوافق على لقب له حدود مائزة وشواهد تؤكد ثبات مفهومه واستقرار حدوده.
بل إن صياغة بعض هذه الألقاب يختلط فيها جزء من لقب المصطلح بالحكم النقدي على هذا الجزء من المصطلح، وهذا الاختلاط هو أبعد ما يكون عن ضرورة تطابق الصياغة اللغوية للمصطلح مع مفهومه، وبعضها الآخر لا يمكن ترسيم حدوده المصطلحية؛ فالقصة الجديدة والقصة الحديثة يمتزج في صياغتهما اسم الفن بالجدة والحداثة، مع أن الجدة والحداثة حكمان نقديان لا علاقة لهما بأسس وضع المصطلح النقدي. ولقد تكون القصة القصيرة جديدة في فكرتها ولكنها تصاغ بلغة بالية مستهلكة فتفقد جدة الفكرة قيمتها.
والقصة القصيرة جدا والقصة القصيرة للغاية لقبان لا يمكن اختبار ثباتهما بالشواهد؛ لما هو معلوم ببداهة العقل من أننا لا نستطيع أن نحدد نقطة في القصة القصيرة يصدق بها وصف القصة بأنها قصيرة جدا أو قصيرة للغاية.
وبرغم هذا الاضطراب المصطلحي فمن اللافت أن يكون في المجتمع الأكاديمي من يقرر في صراحة لا يحسد عليها أن القصة القصيرة جدا جنس أدبي متفرد بذاته.
وفي تقديري أن خصائص هذا الفن لا يصدق عليها لقب اصطلاحي كما يصدق عليها لقب القصة الومضة؛ فهذا التركيب الوصفي ” القصة الومضة” يتطابق لغة مع ما يتمتع به هذا الفن من اقتصاد لغوي بدءا من عتبة عنوان القصة الذي غالبا ما يتألف من كلمة أو اثنتين، مرورا بالنزوع إلى استعمال أفعال الحركة والتقليل ما أمكن من استعمال الصفات وغريب الألفاظ ومبتذل المعاني، وانتهاء باستعمال المفارقة وكسر أفق التوقع.
لكن هذه الخصائص لا تجعل من القصة الومضة فنا مستقلا بذاته؛ فاللغة المجازية والتكثيف والمفارقة خصائص يشترك فيها الشعر والقصة القصيرة والومضة، وغاية ما تمتاز به القصة الومضة هو وجود المفارقة في نهايتها مع ما يترتب على وجودها من كسر أفق التوقع عند القارئ. وإلى أن يتوافق المجتمع الأدبي بأطيافه المختلفة على ترسيم حدود المصطلح واختبار ثباتها بالعديد من الشواهد فلن تستطيع القصة الومضة أن تكون جنسا أدبيا متفردا بذاته. وحتى إذا صارت بمرور الوقت جنسا أدبيا فإن تفردها يتنافى مع ما يحل فيها من ملفوظات مهاجرة من مراجعها، أو بالأحرى يتنافى مع العلاقات النصية.
ولا بد أن يتمتع كاتب القصة الومضة بذخيرة لغوية بالغة الثراء حتى تمده أولا بالكلمات التي يستنفد بها إحساسه ، والتي تمده ثانيا بالمترادفات التي تجو بقصته من آفة تكرار كلمة من كلماتها؛ لأن التكرار إن كان مقبولا في فن الرواية أو القصة القصيرة فإنه مرذول في القصة الومضة التي يجب أن توزن فيها الكلمات بدقة متناهية كما لو كانت جرامات من الذهب.
ولئن كان التكثيف مطلبا فنيا في القصة القصيرة بصفة عامة، فهو مطلب فني جوهري في القصة الومضة بصفة خاصة، ولكنه يرتهن لا بالثروة اللغوية للقاص فحسب، بل يرتهن أيضا برهافة حسه اللغوي وصبره الأيوبي على مشقة إسكان الحبس في العبارة الدالة، وقدرته على إبداع أبنية لغوية تتمتع بإيجازها وإيحائها وإدهاشها المتلقي وبعثه على التفكير فيما يقبع في أحشائها من دلالات غير متلفظ بها، وهذه مرتبة في الإبداع لا يبلغها إلا الغاوون الموهوبون.
وثمة من يقيد القصة الومضة بعدد من الكلمات يتراوح بين ثمان كلمات واثنتي عشرة كلمة، وهذا القيد ليس بعيدا عن التكثيف، وهو مما تمليه قيود الكتابة في تويتر، ولكنه ينطوي على كثير من التعسف في التنظير، وهو يحاصر القاص ويمثل عدوانا على حريته في الحس والعبارة، وقد يدفعه إلى التكثيف المخل بالمعنى ؛ الذي يجعل تلقي القصة الومضة فعلا بالغ العسر.
نعم لا يوجد أدب متفلت من القيود، ولكن القيود لا يمكن أن تصل إلى حصر النص في عدد محدد من الكلمات ينبغي ألا يتجاوزه الأديب، ولا مجال للتعلل هنا بأن تفعيلات البحر الشعري قيود يتقيد بها الشاعر؛ فإن القصة الومضة ليست شعرا وليس كاتبها شاعرا، بل إن قيود التفعيلات تعالج في الشعر بالرخص والضرائر.
على أن التكثيف والاقتصاد اللغوي يجعلان القاص يتجه بخطابه إلى عينة بعينها من المتلقين، عينة تكاد تنحصر في حملة المؤهلات الجامعية وذوي الثقافة الرفيعة القادرين على فهم جماليات المجاز والحذف وما يرقد من شتى الدلالات تحت السطح اللغوي الظاهر. لا خلاف على أن هذه الفئة المحدودة من المتلقين جديرة بأن تُسْتَهْدَفَ، ولا على أن استهدافها يحرم القصة الومضة من التأثير في القاعدة العريضة من القراء، ولكن لا حيلة لكاتب هذه القصة في شيء من ذلك؛ إذ لا يمكنه التضحية بجماليات التكثيف لكي يوسع من دائرة قرائه ومن قدرته على التأثير، وهو في هذا كالشاعر الذي لا يستطيع أن يهبط بلغة الشعر إلى مستوى القارئ العادي.
ويملي التكثيف على كاتب القصة الومضة أن يدقق في تناصاته؛ فهو يستطيع توظيف رموز تراثية وشخصيات عربية أو أعجمية تتمتع بشهرة واسعة في الذاكرة الجمعية؛ مثل عنترة وتأبط شرا وزرقاء اليمامة وسيزيف، كما يستطيع توظيف الكلمات التي تمتلك طاقة إيحائية تحيل إلى مرجعها في النص الغائب، ولكنه يجد صعوبة في توظيف أبيات من الشعر أو أقوال طويلة من خطب الساسة مهما علا شأنهم، وإذا وظف شيئا منها ففي أضيق الحدود، وفي هذا تختلف القصة الومضة عن القصة القصيرة.
وأما الرواية القصيرة فهي أسبق من القصة الومضة إلى الظهور في حياتنا الأدبية المعاصرة، ويكفي أن أحيل إلى قنديل أم هاشم بوصفها نموذجا للرواية القصيرة. ولم يكن ظهورها في النصف الأول من القرن العشرين تلبية لإيقاع سريع يصبغ الحياة بصبغته وقتذاك، بل كان استجابة لفكرة الصراع الحضاري التي مهد لها طه حسين في أديب وتوفيق الحكيم في عصفور من الشرق، ثم حاول يحيى حقي في قنديل أم هاشم التوفيق بين مادية الغرب وروحانية الشرق فلجأ إلى حلول غير منطقية. وبرغم وجود المفارقة واللغة المكثفة في قنديل أم هاشم فإن الفرق لكبير بين بنائها الفني وبين بناء القصة الومضة عند زكريا تامر في مجموعته: دمشق الحرائق ، وعند الدكتور عمار علي حسن في مجموعته ” حكايات الحب الأول”. وهذا الفرق مما لا يتسع المجال لتعديد مظاهره .
ومع إقراري بأن هناك قصصا تنشر على تويتر تأخذ شكل القصة الومضة وخصائصها، إلا أنني على يقين من أن فكرة العمل الأدبي تختار شكلها.