دنيا عوض عبده تكتب ” ما بين اغتراب و حنين “
رواية " ما قبل الرحيل " للروائي المصري محسن خزيم

وكأنما الرحيل هو كأس الحياة الذي كُتب لكل مصري أن يتجرعه .. نعم الرحيل ذاك المكتوب في وعي و اللاوعي المصريين عموماً وهم يطاردون لقمة العيش أو تطاردهم الحياة رغماً عنهم ..!
هكذا جاءت سردية محسن خزيم التي تصاعدت ما بين الحُلم الواعي ومواجيد الواقع اللاهي ، فكان الرحيل و لاشئ غير الرحيل هو الدواء لدائه و لكل مصري يسعى لتحقيق حلمه .
الرحيل إذن .. لما لا ورحيل بطله الأسطوري لم يمضِ عليه سوى عقدٍ من الزمان .! ، كذلك الرحيل الذي كُتب حتى على حرب أكتوبر المجيدة وإبداع المصريين المذهل وأدائهم الأسطوري ! ..
تذكر خالد حديثه مع أقرانه بأن حرب أكتوبر لن تكون الأخيرة ، أومأ برأسه ( ها هي الأيام تؤكد النبوءة مراتٍ إثر مرات ) .
هكذا تزاحمت الصور والأحداث بعقله وهو يهم للولوج داخل الطائرة ، حيث الدقة والنظام على عكس تلك العشوائية التي خلفها ورائه في أزقة و حواري بلدته ، تلك العشوائية المُلبدة بالغيوم والحاجبة للرؤية ، القاطعة لكل سعيٍ إلى الأمام .
وفي الطائرة عاد تزاحم الأفكار و توارد الخواطر البديعية التي تفصح عن روائي يملك أداة السهل الممتنع في تعبيراته .
من اللحظة الأولى في سرديته – وككل مصري يغادر وطنه – حمل” خالد ” بين ضلوعه و خافقه هذا الوطن ربما دون إرادة منه أو هكذا ..
ثم يأخذنا الكاتب في رحلةٍ مع مشاعره و انطباعاته الأولية عن دولة الكويت ، حيث للوهلة الأولى لاحظ الدقة والنظام والنظافة .. ثم ها هو – ككل مصري – يعقد المقارنة و التساؤل ويلخصه في ذاك السؤال الحاضر الغائب ” لماذا العشوائية و انعدام النظام هو السياج الجاثم على حياتنا !؟ “
وكانت أولى صدماته ذاك الحوش المصري الذي يجمع العديد من المغتربين و عمال اليومية في أحد الأزقة الذي رآه الكاتب مجرد سجنٍ يكاد يخنق حلمه الذي أتى من أجله ، فيعاوده الحنين من جديد و يتملكه الوجد وهو يستحضر بطله و حلمه الجميل الذي رحل قبل الأوان.، وكيف حمل نعشه خمسة ملايين شخص في لحظات وداعه الأخير و ما خلفه هذا الوداع من رجالٍ و آمالٍ و أحلام كلها تكسرت على نحوٍ ما .. وبقى الرحيل ..!
وهكذا يعود الكاتب لسؤله ومقارناته مراتٍ و مرات ، ولكن هذه المرة بطعم العلقم ، حيث المقارنة الأليمة بين وطنه العريق الضارب حضارته في عمق التاريخ ، كيف يستحيل إلى ذاك الوطن اللاهث خلف رغيف الخبز ، كما لو كان يعيش تحت حصارٍ لا فكاك منه ، ثم يتابع سؤله ( هناك خطأ ما لابد أن أعود لذاتي ) .. وهو استحضار مباشر لعمقه الحضاري في مواجهة لحظة الضعف التي صُدمته بواقع الحال الجديد وضنك العيش حتى في غربته الجديدة ! وهكذا ظلت هواجسه تأخذه رويداً رويداً إلى الحقيقة ، تلك التي فرضت على أهل وطنه الفقر والحاجة والمرض ، في مقاربة مع ثلاثية شعار بطله الأسطوري في القضاء على ( الجهل والفقر والمرض ) ..!
ثم يعود أدراجه لترديد تلك ( البروباجندا) التي قادت عملية التشويه و التشوين لحقبة الثورة لألا يفلت المجتمع من حالة الجهل و الفقر و المرض .. هكذا كان يغفو ثم يستفيق على وقع ذاك النوع من الهذيان لعلها تعوضه عن لحظات الضعف التي تملكته عندما واجه حقيقة أنه مجرد عامل يومي – وهو الجامعي – في بلدٍ سعى إليه ظنناً أنه سيعوضه عما عاناه في وطنه ، مع تلك الغربة القسرية التي تنال إلى حدٍ بعيد من أبناء وطنٍ كان له الريادة والقيادة ، فأصبح – بفعل فاعل – يُعامل أبناؤه على هذا النحو من التنمر والتشفي وكأنه عقاباً له على دوره التاريخي المجيد ، وهو لا يدرك أن هدف أهل الشر المتسلطين على الأمة إحلال حالة من التشرذم بين العربي و أخيه ، ليبقى واقفاً على حافة الجرف طوال حياته .
ظلت هذه الصور عالقة في ذهن خالد وهو يجوب ذهاباً و إياباً من الديَّرة لخيطان إلى ( درويزة عبد الرازق ) حيث يتجمع عمال اليومية بحثاً عن لقمة العيش ، وهو ما أصابه بالإحباط والمقارنة بين ما أتى به من حلم و ما ترنو إليه نفسه من طموحٍ و انتصارٍ على الواقع المرير ، وما يصدمه الواقع خاصة درويزة عبد الرازق ..!
و بحسٍ يقظ و رفاهة محمودة ينقلنا الكاتب إلى ما بدا له غرابة في هذا المجتمع العربي ، حيث يتلمس اختلافات مثيرة للجدل في النفس التواقة للجمال ، فقد أصابه الذهول حين ذهب يُصلي في مسجد لطائفة الشيعة أو حين ولج إلى مطعم هندي ، حيث الطعام غير الطعام .. وكثيراً من مثل هذه الانطباعات التي لطالما كانت و ما زالت محل تندر المصريين بشكلٍ عام .
و بسلاسة ينقل لنا الكاتب غرائبية مشهد رصده في الشارع الكويتي ، حيث البوذي و الكونفشيوسي والتبتي و السيخ و غيرها من الطوائف البشرية المختلفة .. وربط كل ذلك و بلماحية منتبهة مع تلال المعاناة التي تفعل فعلها في المصريين خاصة دون كل ذاك الخليط البشري …!
فالمعاملة السيئة التي خُص بها المصريون دون غيرهم من الجنسيات وتلك الطوائف أشعرته بالحزن والآلام وإن أرجع سبب ذلك لما أُتخذ من خطوات سياسية في مصر وقتذاك و توقيعها لاتفاقية كامب ديفيد ، وهي حالة دفع المصريون المتواجدون في البلدان العربية على إثرها ثمناً باهظاً ، وتلك الحالة وجدت من يغذيها و يُشعل حريقها لينكر على المصريين دورهم التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة ردحاً طويلاً من الزمان .
وهكذا ينقلنا الكاتب في سرديته من حالٍ إلى حال فتلح ذاكرته عن عبثٍ و إهمال لما كان قائماً من مؤسسات اقتصادية كانت كفيلة لو لم تُهمل أن تحفظ على الوطن وأهله كرامته ، فاستحضر صور هذا الإهمال في مصنع أسمدة بالسويس تم تخريبه بالعشوائية المقصودة كمثال على العبث والإهمال أدى بشريحة من العاملين فيه إلى البطالة ! ، وهكذا ظل يراوح بين ما خلفه في الوطن وبين معاناته و مكابداته وهو يرى أن المصري دون غيره يعامل بقسوة و بلا إنسانية ، حتى أنه ( يأكل الجبن و الكلاب في الشوارع تأكل اللحم ..! ) .
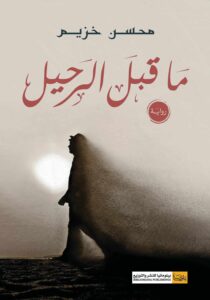
بعد ذلك ينتقل الكاتب بسرديته و بتؤدة و روية تُحسب له إلى عالم آخر غير هذا العالم المُحبِط الذي اضطرته الظروف أن يعيش فيه فترة من الوقت ، وهنا يستعرض فارق الحياة ما بين الحوش و درويزة عبد الرازق من جهة والديرة من جهة أخرى.
ومع ذلك ومع الانتقال من عامل يومية إلى موظف جامعي محترم في مؤسسة بالديرة ، ظل حائراً أمام سؤله ” لماذا أنا المصري مُهاناً بهذا الشكل ..!؟ ” وهو سؤال على ما يبدو لم يجد له إجابة حتى نهاية سرديته.
وهكذا كلما ضاق به الحال وآلمته الغربة ، عاد بحنينه إلى مكابدته وأسرته الفقر والحرمان والعوز الذي دفعه إلى هجرة الوطن مرغماً و دون سبب سوى أن الوطن يعيش محنة ، فيستحضر عدوان ٦٧ وكيف هاجرت أسرته من مدينة السويس إلى صعيد مصر ، وكيف قررت القوى الكبرى ضرب مصر و تحطيم إرادتها ، وكيف تشتَّت جموع المصريين في غربة قسرية ذهب على إثرها والده إلى ليبيا لنفس الأسباب والمسببات ( الفقر ، الجهل ، المرض ) ، وهكذا يسبح الكاتب بين ضفاف الماضي بآلامه ، والحاضر بآلامه و أحلامه ، حيث نظرته إلى العرب نظرة أشقاء .. ثم يتساءل ، أهذا وهم أم حقيقة ..!؟
ويمضي الكاتب في سرديته من وجد إلى ألم و من ألم إلى وجد وحريق يُشعل كيانه بأسئلة البراءة التي تجاوزتها أفاعيل البداوة ، الجهالة والنكران .. يُسائل نفسه :- لماذا أنا المصري دون أبناء العجم .. أنا العربي .. الأعاجم تنعم بخير بلاد العرب ، وأنا أُهان ، هائماً لا أجد حتى كسرة خبز تقيم وأدي .. إنها الفاجعة التي كابدها خالد كما كابدها المصريون من قبل ومن بعد .
ومع تكرار مواقف القسوة والمعاناة تقرب خالد المصري مع ثائب الإيراني الذي كان يطيب خاطره كلما اصطدم بغلاظ القوم و غلاظ القلب كلما ذهب لعمل أو وظيفة .. غالبه البكاء ونهره ثائب ( البكاء لم يُخلق للرجال ) .. وهكذا تمضي الأيام بخالد من شتاء لا يرحم إلى قيظ صيف هو الأشد حرارة على الكوكب .!
ويمضي بخالد المسير في لجة الحياة ، وأخيراً يجد له منفذاً شديد الصعوبة ، أخيراً أرسل خالد لأمه مبلغ من المال ليعينها على الحياة ، ويعود والحال كذلك إلى تذكر والده وعبد الناصر والسيد عبدالرحمن فوزي والد محبوبته الذي عامله بصلف و تعالي ، ولا يدري لماذا تذكر الثلاثة ..؟! ربما لأنهم من مواليد عام ١٩١٨ م ، أو لربما ثلاثتهم لم ينتشلوه من الفقر أو الضياع ، سواء من والده الذي مات وتركهم فقراء ،أوعبد الناصر الذي رحل ومصر في محنتها ، أم عبدالرحمن الذي رفض زواجه من ابنته ..؟
ظل خالد أسير هذه الذكريات لعمق أثرها في نفسه .
( ومر عام وأنا أداري سوءة الفقر الذي حرمني من متعة الحياة وأحال حياتنا إلى شقاء وغربة مستديمة ) .
ومرة جديدة يعود خالد – بطل سرديته والذي جاء اسمه تيمناً باسم ابن بطله الأسطوري – بعدما حقق من نجاح في وظيفته بالغربة إلى أحوال معشوقته مصر ، وما ألم بحالها ، واجتياح رموز ( السداح مداح ) ما تبقى من الصناعات التي كانت تحفظ للمصريين كرامتهم واستقرارهم .
ثم تمضي السردية صوب عالم خالد الجديد ، حيث تأخذه حميته على معشوقته ( مصر ) إلى عالم غير عالم الوظيفة ؛ عالم الصحافة و الإعلام وغيره ، ثم ينقلنا إلى الحالة الفلسطينية حيث (سلاف السكرتيرة الرائعة ) وحيث الصحفية المسمومة التي لم ترَ في مصر والمصريين سوى أنهم فقراء ويلهثون خلف الطعام ..!!
ثم يستعرض بالتوازي حال سُلاف الفلسطينية وأهلها ورحلتها من المجدلية وحتى الكويت ، ومن النكبة وحتى النكسة ، وكيف أتخذ الكثير من الفلسطينيين (الديرة ) مستقراً لهم بعد كل ما لاقوه من مآسي ..
وحمل الكاتب دولة الكويت في مساحتها الصغيرة ، الكبيرة في فعلها و دورها في عصرها الذهبي بين ثنايا اعتزازه وأسفه ..!
وهكذا تمضي السردية بين أهوال الاغتراب ومواجيد الحنين ، فيستعرض علاقاته المختلفة والنسائية منها بالخصوص ، وكيف انتقل من هذا العبث و نجا بنفسه من مراودة هذه وتلك ، حيث كانت نصيحة الرجل العجوز الذي استقبله في (حوش الشرق) .. ما زالت كلماته وجاءاً من كل شطط ( تمسكوا بدينكم أولاً و لا تنساقوا وراء الرذائل ولا تستسهلوا الحرام فالمغريات كُثر وأنتم أحرار ) .
وفي نقلته الجغرافية من الكويت إلى فرنسا بدا له الفارق الزماني والإنساني بين ( الديرة و نيس ) ، فالإنسان في الديرة يعاني الصلف والغلو والكِبر ولعنة المال ، وفي فرنسا الإنسان وليس المال هو محور كل شيء ، وهنا تبرز انتقائية الكاتب ولماحيته لعالمين مختلفين عن عالمه و عن بعضهما البعض .
ويمضي الكاتب في سرديته إلى المصالحة مع الذات ، فعاود حنينه من جديد إلى بطله الأسطوري ، وأن الديرة موطن المال ليست هي الجنة ، ( و أبداً وطني ليس هو النار ..! ) .
وتمضي السردية في الحديث عن مجتمع تملكته الرذيلة ، وآخر حفظ وصايا الخير والإيمان .. وبينما يكابد خالد في سجن ترحيله على يد الرذيلة ، تأتي الفاجعة ….!!
تلك الفاجعة هي النهاية التي أتركها مفتوحة أمام القارئ وكما كتبها الروائي والتي سجلها بتلقائية وكأنها قدر مقدور لتراكم العبث اللاهي والمجون الضارب في جنبات المال الذي أفسد الحياة أو بعضاً منها .
و السردية كونها العمل الأول للكاتب ، مفعمة بلغة السهل الممتنع الذي له جاذبيته الخفية والساحرة في آن .. وقد نجح الكاتب بدفق ذكرياته في سردية معجومة بالأمل والرجاء .. بقدر ما هي معجونة بإحباطه في منازل البؤس والشقاء .






