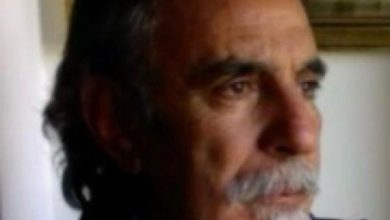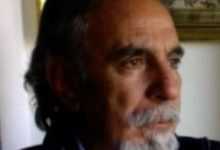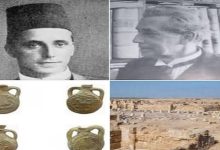عبد الغفور مغوار يكتب تفكيك السلطة السردية في رواية انفلات ل.. عبد الغني تلمام
دراسة في الميتاسرد والوعي الذاتي للنص

عبد الغفور مغوار – المغرب
I- تحليل البنية السردية والافتتاح الدرامي – مدخل إلى التوتر، الشخصية، والأسلوب
1- الانفتاح السردي: لحظة المفارقة وتحريض القارئ
يفتتح الكاتب نصه بانزياح شعوري خفي: “في سدفة الليل باغتني إحساس غريب، إحساس بطعم وخزة ضمير”، هذه الجملة الافتتاحية لا تستدعي فقط التوتر، بل تقيم لعبة سردية مع القارئ تنبئ بانفلات الحدث عن المتوقع. النداء الداخلي، مقرونا بالعتمة والضمير، يرسم فضاء مضطربا يستدعي المقارنة مع افتتاحية La Nausée” – الغثيان” لجان بول سارتر، حيث تختلط الذات بالمكان، ويصبح الخارج امتدادا للداخل.
النص ينفتح إذن على قلق وجودي قبل أن يتحول إلى مشهد “مقهوي” تعبيري، ويمنحنا شخصية الراوي/المؤلف الذي سيحمل النص بكامله على كتفيه.
2- الراوي بوصفه شخصية: من كاتب إلى كائن روائي
الأديب عبد الغني تلمام لا يقدم لنا شخصية تقليدية، بل يضعنا أمام كاتب داخل القصة، مما يجعلنا أمام “ميتاسرد” أو “السرد المرآوي” (metafiction) منذ البداية. هذا الكاتب الذي “أقفل حاسوبه” وانطلق نحو المقهى، هو ذاته الذي سيتحول لاحقا إلى ضحية خياله. هذه اللعبة السردية تذكرنا بشخصيات ميلان كونديرا في “كتاب الضحك والنسيان” و”خفة الكائن التي لا تحتمل”. هناك حيث تصبح الشخصية انعكاسا لوعي الكاتب، ويغدو الحكي مساحة للتجريب الوجودي.
في “انفلات”، يتحول هذا الكاتب إلى مرآة تتداخل فيها مستويات الذات، النص، والشخصيات، حتى يصبح سؤال من يكتب من؟ سؤالا مركزيا.
3- المشهد الأول: ظهور الفتاة – استدعاء الرغبة والتشويش الرمزي
مشهد دخول الفتاة يجسد لحظة قلق جمالي: “الفتاة كانت كأنها ملاك تاه عن ملكوت السماء “…
هذه الجملة محملة بنفَس شعري غزلي يضع القارئ بين جمالية المفاجأة وريبة التواطؤ. النموذج الأنثوي الذي يظهر ههنا هو تجل لرغبة مكبوتة، لكنه يتجاوز الواقع نحو الرمزية: فتاة تقرأ أفكار الكاتب! يشبه هذا المشهد دخول المرأة الغريبة في رواية “L’Amant” لمارغريت دوراس، حيث الحضور الأنثوي يغير قوانين الزمن السردي ويجعل من الرواية مساحة للتأمل في الجسد والهوية.
في قصة “انفلات”، تصبح الأنثى – من لحظاتها الأولى – كائنا سيميائيا، رمزا يتجاوز دوره الجمالي إلى مساحة للتوتر الفلسفي والنفسي.
4- اللغة والأسلوب: بين الغواية والتهكم
الكاتب المبدع عبد الغني تلمام يوظف لغة فنية مشحونة بالصور والاستعارات، لكنها لا تنزلق إلى المجاز المجاني. جمل مثل: “ابتسامتها، تلك الابتسامة الخارقة المتغورة.”
تشير إلى رغبة في تقويض المألوف وبناء مفردات خاصة، وهو ما يقربه من أسلوب غسان كنفاني في “عائد إلى حيفا” حين تكون اللغة ذات بعد استكشافي شعوري.
كما يبرز التهكم بوصفه أداة دفاعية لدى الراوي:
“كل النساء في نظري ملائكة تائهة … “
هنا تظهر اللغة كحيلة سردية، تستعمل ليس فقط للتوصيف، بل للمناورة النفسية، وللهروب من الأسئلة الوجودية الأعمق التي تطرحها الفتاة/القارئة.
5- التوتر الأول: لعبة التعارف والمراوغة
المشهد الذي تبدأ فيه المرأة بالكشف عن معرفتها بالكاتب، بل بأعماله، يفتح الباب أمام الميتاسرد:
“أنت تعرفني حق المعرفة وتعرف حتى حبيبي … “
هنا يكسر النص الجدار الرابع وينتقل من الحكي إلى استجواب الذات، بل إلى مساءلة الكاتب عن أخلاقيات الكتابة وأثرها في الواقع، كما فعل الطيب صالح في “موسم الهجرة إلى الشمال” حين وقف مصطفى سعيد يواجه الراوي بحياته كمرآة للتاريخ الاستعماري.
كيف يتجلى ذلك:
– مرآة الراوي:
كلاهما متعلم ومثقف سوداني
كلاهما سافر إلى أوروبا للدراسة
لكن مصطفى سعيد سلك طريق الانتقام والتدمير، بينما الراوي سلك طريق التكيف.
– مرآة التاريخ الاستعماري:
مصطفى سعيد “استعمر” النساء الأوروبيات عاطفيا وجنسيا
استخدم سحر “الشرق الغامض” لإغوائهن
قلب أدوار الاستعمار: الشرقي يستغل الغربيات بدلا من العكس.
المواجهة:
عندما يكشف مصطفى سعيد قصته للراوي، يضعه أمام مرآة مؤلمة تظهر ما كان يمكن أن يصبح عليه، والثمن الحقيقي للصدام الحضاري.
هذا التوازي المرآوي هو من أبرز عناصر عبقرية الطيب صالح في بناء الرواية وطرح أسئلة الهوية والاستعمار.
هذا وفي قصتنا “انفلات” تظهر الشخصية النسائية كقوة سردية قادرة على تغيير مصير الحكاية، بل على قلب أدوار السلطة: من المبدع إلى المخلوق، ومن الكاتب إلى السارد المستجوب.
6- في قلب الانفلات: السرد بوصفه تجربة ميتافيزيقية
كل هذه الإشارات النصية تقودنا إلى نقطة مركزية: القصة لا تحكي فقط حدثا أو علاقة، بل تعيد طرح سؤال الخلق الأدبي من جديد. هل للكاتب الحق في القضاء على شخصياته؟ هل للرواية سلطة على الواقع؟ هل يمكن للشخصيات أن تتجلى خارج النص؟
هذه الأسئلة ليست تجريدية فقط، بل تنغرس في لحظة الخيانة التي تقترحها الفتاة:
“أريدك وفيا حين يكتب قلمك عن الخيانة.”
المفارقة هنا وجودية، تضع الكاتب أمام ذاته لا كمنتج للمعنى فقط، بل كموضوع للتمحيص والتجريب.
-II تجليات الأنثى بين الخلق والتمرد، الكاتب والبطلة – من رمزية الحضور إلى سلطة التجلي
1- تمثيل الأنثى في “انفلات”: بين النمط والاختراق
ظهور رباب في النص هو لحظة مفصلية في البناء الروائي، لا كأنثى اعتيادية، بل ككائن سردي خارق، يخترق العتبة الفاصلة بين الكاتب وشخوصه. وصفها الجمالي المشحون بالإثارة والدهشة، ثم جرأتها المتصاعدة في فرض حضورها، يشكل تحولا في علاقة الراوي بالأنثى: لم تعد موضوعا للخيال، بل أصبحت فاعلا سرديا يتحكم في مصير من كتبها.
هذا يذكرنا بـ”كتابة المرأة”L’Écriture féminine – لهيلين سيكسو، حيث تطرح الذات الأنثوية كثورة لغوية وفلسفية، تربط بين الجسد والكتابة والسلطة وتدعو لتمرد أنثوي ضد اللغة الذكورية.
2- من “ملائكية الأنثى” إلى مساءلة الراوي
رباب لا تكتفي بالحضور، بل تبدأ في مساءلة الكاتب:
“أنت خالقي فكيف لا أحبك؟”!
هذا النداء العاطفي لا يفهم فقط كإعلان حب، بل كإقرار بعلاقة غير متكافئة بين الخالق والمخلوق. تريد رباب أن تحب لأنها وجدت بفعل الكتابة، لكن ماذا يعني أن تمنح الشخصية الأدبية إحساسا بالحب؟ هنا تنقلب الموازين: الراوي لم يعد يملك سلطة تامة على الشخوص، بل بات يسائل من طرفها. بهذا تتقاطع رباب مع شخصية “إيما بوفاري المحاصرة بقناع الزوجة المثالية” في رواية “مدام بوفاري” للكاتب غوستاف فلوبير. إيما تشعر بالاختناق بسبب التوقعات الاجتماعية المفروضة على زوجة طبيب ريفي، والتي تجدها مملة وغير مرضية مقارنة بمُثلها الرومانسية التي اكتسبتها من الروايات. تحاول أن تتوافق في البداية لكنها تشعر بالاختناق.
وهي “تسعى للانفلات عبر الرومانسية والحب المحرم”: هذا هو الصراع المركزي وآليتها الأساسية للتكيف. بسبب خيبة أملها في زواجها وحياتها، تسعى وراء علاقات غرامية غير مشروعة، معتقدة أنها ستوفر لها الحب العظيم والدرامي الذي تتوق إليه.
3- التجلي السردي: حين تتحول البطلة إلى كيان مستقل
لحظة تجلي رباب بوصفها بطلة مقتولة سابقا، تطالب الكاتب بقيامة ثانية، هي لحظة خرق للجدار الرابع، وتحرير للبطلة من سلطة النص الأصلي. تحمل هذه اللحظة نفس المفارقة التي نجدها في رواية “المزيفون – Les Faux-Monnayeurs” لأندريه جيد، حيث تتداخل طبقات السرد والواقع، ويصبح القارئ والكاتب والشخصية في حوار متنقل. فالكاتب إدوارد يكتب رواية بنفس اسم الرواية التي نقرأها، حيث تتداخل مستويات السرد والواقع والخيال، ويدور حوار مستمر بين الكاتب والشخصيات حول عملية الكتابة.
رباب هنا في “انفلات” ليست تجسيدا لأنثى جميلة فقط، بل تجسيدا لسلطة الذاكرة الأدبية، لتمرد الشخوص على المصير، ولرغبة الحياة في وجه الموت الفني.
4- جدلية الخلق والمساءلة: هل الكتابة خلق أم اقتراح؟
تقول رباب في ذروة غضبها:
“الموت بعد الوجود أسوأ من العدم. كيف تجرؤ أن تنتزع البسمة من شفتي …”
هذا التصريح يجعل من القصة تأملا فلسفيا في مفاهيم:
– الخلق الفني بوصفه مسؤولية.
– الكتابة كفعل أخلاقي.
– الشخصيات ككائنات لها حقوق “شبه وجودية”.
يمكن هنا إجراء مقارنة مع “العاشق – ” L’Amant لمارغريت دوراس، فالرواية تقدم مثالا رائعا للتفاعل بين السرد والذاكرة. حيث تواجه الكاتبة ذكرياتها الخاصة، مستعيدة علاقتها بفتى صيني ثري في الهند الصينية الفرنسية خلال فترة شبابها. لا تقدم الرواية تسلسلا زمنيا بسيطا للأحداث، بل هي رحلة متعمقة عبر الذاكرة.
ينشأ حوار مستمر بين الكاتبة الناضجة والفتاة التي كانتها. فالسرد ليس مجرد استعادة للأحداث، بل تأمل من منظور المرأة البالغة التي تنظر إلى ماضيها. هذا يخلق طبقتين صوتيتين تتفاعلان: صوت الفتاة التي تعيش التجربة، وصوت المرأة الناضجة التي تتأملها وتحللها.
رباب بدورها في قصتنا “انفلات” تطلب توازنا بين جمالية النص وعدالة الشخصية.
5- التوظيف النفسي: هل الأنثى هنا رمزية أم إسقاطية؟
رباب ليست فقط شخصية داخل النص، بل تظهر بملامح من صانعها، الكاتب. حين يقول الراوي: “رباب ما هي إلا أنا في ضمير الأنثى…”، فإنه يعترف بأن الشخصية ليست مستقلة تماما، بل مزيج من الذات والآخر.
هذا يكشف عن مستوى عالٍ من الإسقاط النفسي في الكتابة، حيث تتحول الشخصية إلى مرآة داخلية. هنا تتقاطع رباب مع شخصيات كثيرة من أعمال سردية عالمية، والتي تمثل المرأة بوصفها ضميرا ثوريا يخترق الواقع الذكوري.
6- خيانة رباب: من غواية الجسد إلى احتجاج الروح
المشهد الذي تجمع فيه رباب بين الإغواء والحوار الفلسفي يضعنا أمام مفارقة: الأنثى التي تعرض جسدها لمبدعها، ليست تفعل ذلك من باب الرغبة الجنسية فقط، بل باعتباره فعل احتجاج على النص القديم، رغبة في كتابة جديدة للقدر.
حين تقول:
“كنت وفية للحياة فحرمتني منها … “
فهي لا تطلب العلاقة، بل تطلب إعادة التأليف، تطلب أن تكتب من جديد، وهو عمق رمزي يصعب تجاوزه.
-IIIميتاسرد وتمرد الشخصية – من سلطة المؤلف إلى مساءلة الخلق الفني
1- رباب… بين الحبر والدم
عندما تباغت رباب الكاتب، معلنةً وجودها في “لحم ودم” بوصفها بطلة حية تتجاوز سطوره، وتوبخه على مصير كتبه لها دون ضرورة، فإن النص هنا يبلغ ذروة ميتافيزيقية أخاذة. هذه اللحظة، التي تصدح فيها: “أنا رباب في لحم ودم، رباب بطلة روايتك والتي قتلتها دون أن تكون ملزما لذلك”، لا تنقل العمل إلى مجرد منطقة سردية نادرة فحسب، بل تحول فعل الكتابة من مجرد نسج للكلمات إلى فعل خلق أشبه بالخلق الإلهي، وتضع الكاتب في مقام “شبه إله” لكنه معرض للمساءلة والمحاسبة من كينوناته التي أبدعها. وهذا يجسد ما يعرف بـ”أزمة السلطة السردية” في الأدب الحديث، حيث تسترد السلطة من يد الكاتب وتمنح للشخصية أو حتى للقارئ.
هذا التفاعل السردي، وهذا المشهد عميق الصلة بفلسفات أدبية وسردية حاضرة بقوة في أعمال عمالقة مثل خورخي لويس بورخيس وبول أوستر.
أجل، يتردد صدى هذه اللحظة بقوة في عالم بورخيس، حيث تتلاشى الحدود بين الخالق والمخلوق، وتكشف الشخصيات أحيانا عن وعيها بكونها مجرد كيانات سردية. فكرة أن الشخصية تستطيع أن تحاجج مبدعها أو تتحرر من قيوده هي جوهر العديد من متاهات بورخيس الأدبية، التي تجعل من القارئ يتساءل عن طبيعة الواقع والخيال.
أما عند بول أوستر، فكثيرا ما نجد أبطاله، غالبا ما يكونون كتابا أنفسهم، يقعون فريسة لألعاب سردية معقدة. يظنون أنهم يتحكمون في زمام الأمور، ليتفاجؤوا بأن شخصياتهم تمتلك إرادة مستقلة أو أنهم هم أنفسهم مجرد دمى في حبكة أكبر. هذا التملص والاستقلال من قبل الشخوص يمثل تحديا مباشرا لسلطة السارد، ويضفي على السرد طبقات من اللايقين الوجودي.
إن لحظة تمرد رباب ليست مجرد تقنية أدبية، بل هي استكشاف عميق لطبيعة السرد نفسه، وعلاقة الوعي بالخلق، وتساؤل عن حدود السيطرة بين المبدع وإبداعه. إنها دعوة للتأمل في كوننا جميعا، في نهاية المطاف، قد نكون شخصيات في قصة أكبر، نعيش في “لعبة سردية” لا نتحكم بكل خيوطها.
2- مساءلة الكتابة: من “موت المؤلف” إلى عودته المهزوزة
رباب لا تطلب فقط تفسيرا لحدث موتها، بل تعترض على دوافعه، وتطالب بحق سردي جديد:
“أنا أريد قدرا آخر، وفي الحب أنا لا أقبل بأقل منك.” هذا المطلب ليس عاطفيا، بل وجوديا وفنيا. وهي بذلك تعيد طرح سؤال طالما أرق النقاد: هل الكاتب مسؤول عن مصائر شخصياته؟ هل للخيال التزام أخلاقي؟ هل النص ملك للكاتب أم للشخصيات بعد أن تكتب؟
تتقاطع هذه الفكرة مع أطروحات رولان بارت في “موت المؤلف” لكنها هنا تعيد المؤلف من بوابة المحاسبة لا السيطرة.
3- الثورة السردية: حين تكتب الشخصيات مصير الكاتب
في لحظة عنيفة، يطعن الكاتب من طرف عباس – حبيب رباب – بشكل مفاجئ، وصادم دراميا:
“اختصر قدري صائحا ‘من أنت أيها الخائن؟’ ثم غارس شيئا حادا في بطني.” هنا تنقلب اللعبة: الكاتب الذي يقرر مصير شخوصه يتحول إلى شخصية تقتل داخل نصه. السلطة تنتزع، والنص يثور على صاحبه.
في هذا، يتمدد النص نحو التشبيه بمسرحية لبيرانديلو”Six Characters in Search of an Author”، حيث في الأدب الميتاسردي الشخصيات تتمرد على المؤلف وتكسر الجدار الرابع.
4- تشظي الذات الساردة: من كاتب إلى ضحية
يظهر النص حركة سردية دقيقة: الكاتب يبدأ كراو صاحب سلطة، ثم كمجذوب في لعبة التخييل، ثم كمخلوق ضمن نصه الخاص. هذه الحلقات الوجودية تفكك مفهوم الكاتب العارف. تشبه هذه التقنية ما نجده في رواية ” City of Glass لـ Paul Auster”، حيث تتداخل الشخصيات وتضيع الحدود بين الراوي والمروي والمروي عنه.
رباب ليست فقط من تخلق، بل تعيد خلق الكاتب عبر استنطاقه، حبسه، اغتياله سرديا وواقعيا.
5- المفارقة النهائية: من الخلق إلى النرجسية
رباب تقول:
“قتلك زرادشت وأحييتك.” في هذه الجملة، تكمن المفارقة الكاملة: الشخصية التي خلقت بالحب، بالفتنة، بالوعي، صارت ترى في نفسها من يقتل ويحيي. هنا تغدو الكتابة نرجسية مزدوجة، لا تعود تخص الكاتب فقط، بل تمتد إلى الشخصية التي نضجت حتى باتت ترى نفسها خالقة لمخلقها.
وهذا التقاطع بين المعرفة والخلق يعيدنا إلى أطروحة كامو في “أسطورة سيزيف”، حيث يرى أن الوعي بالعبث لا يؤدي إلى الاستسلام، بل إلى تمرد خلاق: إبداع يتحدى العدم دون أن ينكره، وخلق لا يطمح إلى المطلق، بل إلى إثبات الذات في عالم لا يكترث بها. هكذا يصبح الإبداع شكلا من أشكال “التمرد الفني”، الذي يختبر حدود المعقول دون السقوط في الوهم.
-IV الموت، البعث، والحبكة الوجودية – بين الخيانة الأدبية والقيامة الجمالية
1- مشهد الموت: تحول الكاتب إلى ضحية حكايته
في مشهد النهاية، حيث يقتل الكاتب داخل نصه على يد شخصية ثانوية – عباس، حبيب رباب – يتحول السرد من مجرد حكاية إلى تراجيديا وجودية تطيح بسلطة المؤلف نفسه. هذه الطعنة الرمزية لا تنهي فقط حياة الكاتب كشخص داخل النص، بل تقوض أيضا سلطة التأليف ذاتها، حين تتجاوز الشخصيات أدوارها لتصبح فاعلة وصاحبة قرار.
في هذا الانقلاب، يتقاطع النص مع بعض أصداء أدب دوستويفسكي، حيث تتمرد الشخصيات على أطرها الأخلاقية وتطور وعيا خاصا بها، لكنها هنا تذهب أبعد، فتمارس سلطتها داخل حبكة تمردت على خالقها، مما يعيد مساءلة العلاقة بين الكاتب ونصه في ضوء فلسفات ما بعد الحداثة. وإن كان دوستويفسكي غالبا ما يبقى هو “الضمير الخلفي” للنصوص، ولا يحذف نفسه من السرد كما يفعل كتاب ما بعد الحداثة.
2- القيامة الأدبية: من الخلق إلى الفتنة
عودة رباب من الموت ليست فقط انتصارا للشخصية، بل هي إعلان عن خلل في بنية السلطة: لم يعد الكاتب يقرر المصير، بل أصبحت رباب شريكة في التأليف، وغوايتها أداة لإعادة كتابة الواقع.
وحين تقول له: “أنت خالقي، فكيف لا أحبك؟”، يتحول هذا الاعتراف إلى لحظة عشق إبداعي، لكنه أيضا إلغاء للهيمنة الأحادية على الحكاية، وإعلان عن شراكة في التأليف.
وهنا تتقاطع هذه التيمة مع تجربة إلياس خوري، خصوصا في “باب الشمس”، حيث الشخصيات لا تروى بل تروي نفسها، تصحح الحكاية، وتعترض على سلطة السارد. الكتابة عند خوري هي إعادة خلق، ولكنها أيضا إلغاء تدريجي لتفرد الكاتب أمام شخصيات تمتلك ذاكرتها، لغتها، وحقها في إعادة كتابة المصير.
3- الخيانة: هل هي أداة أم غاية؟
رباب تقترح على الكاتب خيانة زوجته كمدخل لفهم الشخصية الأنثوية، لكن العرض ليس جماليا فقط، بل يُطرح كمشروع أدبي لخلق حقيقة شعورية:
“ليلة واحدة ستصحح مفاهيمك عن نفسك، عن المرأة، وعن دوافع الخيانة.”
في هذا الطرح، تتجاوز رباب المفهوم العاطفي للخيانة، وتحوله إلى سؤال وجودي وفني: هل يمكن للكاتب أن يتقمص التجربة حتى ولو خالفت قناعاته؟ وهل يجب أن يحترق ليكتب عن النار؟
هذا يعيدنا إلى تجربة إدوار الخراط، خصوصا في “رامة والتنين”، حيث تصبح العلاقة الغرامية، الملتبسة والحدية، مختبرا داخليا لفهم الذات وكتابة الواقع. لدى الخراط، لا تنفصل اللغة عن الجسد، ولا الكتابة عن المحظور، بل يتحول “الممنوع” ذاته إلى حقيقة جمالية مشروطة بالألم والانكشاف.
4- النهايات المفتوحة: سؤال حول الحقيقة والخيال
لحظة قتل الكاتب وعودة رباب للحضن تمثل قمة التداخل بين النص والواقع، بين الحبر واللحم، بين الفكرة والتجسيد. هل كان كل ذلك حلما؟ تخيلا؟ كتابة داخل كتابة؟ النص لا يعطي جوابا، لكنه يبقي الباب مشرعا أمام اللايقين الفني، ويغدو الأدب عند المبدع عبد الغني تلمام تجربة تحاكي المختبر الفلسفي أكثر من الحكاية الخطية.
خاتمة
قصة “انفلات” ليست مجرد عمل حكائي، بل منظومة سردية مركبة تتداخل فيها الأبعاد النفسية، الرمزية، الوجودية، والفنية. الكاتب عبد الغني تلمام لا يروي حدثا، بل يعيد تشكيل علاقة الكاتب بشخصياته، ويطرح سؤالا جوهريا عن سلطة الخلق، وأخلاق الكتابة، وتمرد الكائنات الورقية حين تمنح حيزا شعوريا.
رباب ليست فقط بطلة، بل فكرة حية، شبح حبر، صوت يعيد مساءلة النص، وتخلق عبر حواراتها فضاء من الذكاء العاطفي والفني. أما الكاتب – وقد صار يُقرأ داخل النص – فيغدو شخصية مثقلة بالتناقضات، ضحية فتنة صنعها، وعاشقا لنرجسية خلقتها يداه. رباب ليست فقط جزءا من القصة، بل صدى داخلي للكاتب، امتحان لموقفه من سلطة الكتابة، استدعاء للسؤال الأخلاقي في الفن.
إن عبد الغني تلمام، في “انفلات”، لا يسطر قصة، بل يشكل نصا تفكيكيا متجددا، يحمل قدرة على استفزاز العقل والوجدان معا. أسلوبه بالغ التوهج، لغته مشحونة بعنفوان بلاغي وجمالية خطيرة، وحبكته تتحول من حدث إلى سؤال، ومن لقاء إلى قدر. إنه كاتب لا يهاب التجريب، ولا يخشى مواجهة شخوصه، بل يمنحهم الحياة، ثم يصارعهم في لحظة القيامة.
إبداعه في هذا النص هو إبداع تتويج وليس ابتداء، لأن فيه كل ما يشبه الكبار: جرأة ميلان كونديرا، دهشة بورخيس، حميمية يوسف إدريس، وتهكم الطيب صالح. لكأن “انفلات” هي لحظة أدبية تنفلت من التصنيفات، وتنسج فكرا أدبيا خاصا يستحق الوقوف عنده بإجلال واحتفاء.
* لائحة المراجع
+ المراجع الأجنبية
– Auster, P. City of Glass, Viking, 1985.
– Belli, G. La mujer habitada, Laertes, 1988.
– Borges, J.L. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Ficciones, 1940.
– Calvino, I. Se una notte d’inverno un viaggiatore, Einaudi, 1979.
– Camus, A. La nausée, Gallimard.
– Duras, M. L’Amant, Minuit, 1984
– Duras, M. La Douleur, P.O.L, 1985.
– Kundera, M. The Unbearable Lightness of Being, Harper & Row, 1984.
– Mishima, Y. Confession d’un masque, Gallimard, 1949.
– Sarraute, N. Portrait d’un inconnu, Gallimard, 1948.
+ المراجع العربية
– إدريس، يوسف. البيوت أسرار. دار الشروق، 1982.
– صالح، الطيب. موسم الهجرة إلى الشمال. دار العودة، 1966.
– نقد الأدب العربي المعاصر
– صبري حافظ. أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية. دار شرقيات، 1996.
– جابر عصفور. زمن الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999.
– فيصل دراج. الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية العربية. المركز الثقافي العربي، 2004.
– إدوار الخراط. الكتابة عبر النوعية. دار شرقيات، 1994.
النص:
انفلات
في سدفة الليل باغتني إحساس غريب، إحساس بطعم وخزة ضمير. أقفلت حاسوبي وقصدت المقهى لعل النفس تروق.
أخذت مكاني المعهود حين استرعت انتباهي شابة تسترق النظر إلي. حاولت تجاهلها لكن الأمر كان مربكا؛ الفتاة كانت كأنها ملاك تاه عن ملكوت السماء أو لعبة تركيب من قطع فتنة وغنج، لكن أكثر ما أربكني فيها هي ابتسامتها، تلك الابتسامة الخارقة المتغورة.
علمت أني لست من النوع المتطفل فقامت وجلست قبالتي بكل جرأة. نظرت إلي مطولا وهمست لي وكل ما فيها يشي أنها استثناء:
– أشكرك على الإطراء الرقيق لكنك تعلم أني مرتبطة.
لم أخلها بتلك السذاجة لتستدرجني بادعاء روضة أطفال فقلت لها:
– لم أكلمك حتى أجاملك.
ضحكت كأن لا أحد في المقهى ثم قربت رأسها مني وهمست بثقة غريبة:
– ألا أستحق أن تشبهني بالملاك التائه؟!
رباه، ماذا أسمع؟ أهي ساحرة؟ أهي قارئة أفكار؟ إنه لشيء جنوني أن تكلم شخصا يعرف فيما تفكر فيه، لكنها امرأة، وفقدان التركيز أمامها أول الهزيمة. استجمعت كبريائي، لملمت دهشتي، رممت نظراتي وقلت لها:
– كل النساء في نظري ملائكة تائهة، ربما تصادف أن سمعته أو قرأته في إحدى رواياتي.
نظرت إلي بنظرة الحليم المتعفف واستطردت قائلة:
– لديك الحق، عموما ألن تطلب لي عصير الليمون ببوظة الفانيلا؟
في تلك اللحظة علمت أن الشابة معرفة قديمة وإن لم أتذكرها. الليمون بالفانيلا طلبته للعشرات حين كنت طالبا في كلية الآداب. عموما اللعبة ابتدأت ولن تهزمني عشرينية متبجحة.
لمعرفة خباياها تجاهلتها ولم أقم بالخطوة المعهودة بسؤالها حتى لا تأخذ ذلك على محمل الاهتمام والرغبة بها فتبدأ في المراوغة والمشاكسة. هي من أتت إلي وهي من عليها التعريف بنفسها. نظرت إليها نظرة باردة متجاهلة وقلت لها:
– حين تظن المرأة نفسها محور الأشياء تصبح كالشمس الحارقة وتتبخر الأشياء من حولها.
ابتسمت المتطفلة وردت:
– أهذا سبب خروجك ليلا؟ تتفادى الوهج والضياء. أتساءل كيف لكاتب كبير أن يلهم الناس وينير حياتهم وهو منزو في العتمة.
إذن هي إحدى قارئاتي دون أدنى شك. لقد كشفت أولى أوراقها ولن يكتمل الليل حتى آتي بخبرها.
– يا آنسة، إن كنت معجبة بي فاعلمي أني متزوج وأحد أولادي في عمرك؛ عبثا تحاولين.
ساعتها توقفت عن الابتسام وردت بأسى يشبه خيبة الانتظار:
– صدقني لم أكن أعرف … الغريب أني التقيتك أكثر مما التقيت حبيبي. أليست هذه أغرب حبكة تصادفها؟
لم أدر عما كانت تلمح إليه فسألتها:
– تتكلمين وكأن لنا سابق معرفة وأنا لم ألتق بك يوما.
في تلك اللحظة انفجرت غاضبة كطفلة أساؤوا فهمها وصاحت:
– بلى بلى أنت تعرفني حق المعرفة وتعرف حتى حبيبي، تكلمتما عني عنوة ووصفتني للناس بالطريقة التي لم أستطع أن أتمالك نفسي فاشتقنا إليك وأتيناك.
في تلك اللحظة أحسست بأني أمام مراهقة تماهت زيادة مع رواياتي ووجب الحذر من التفاتها البلاغي الأقرب للانفصامية فآثرت إنهاء النقاش قائلا:
– آنستي، الوقت متأخر وعلي الرجوع للبيت. أنا كاتب متزوج له سمعة، لذا أستسمحك في المغادرة.
وقتئذ تبدلت قسماتها وباتت أكثر وداعة بل فاجأتني بجواب جريء لم أكن لأتوقعه:
– ثق بي أنا أتفهم حساسية الموقف لكن لدي عرض إبداعي لك. أنت تكتب عن الناس والأولى معرفة حياتهم. ما رأيك أن أسمح لك بالتجربة التي تمني نفسك بها؛ الخيانة مع فتاة جميلة مثلي. أنت تعلم أن أسلوبك جميل لكنه يفتقر لعمق الإحساس حين يتعلق الأمر بالأنثى.
اللعنة! إنها تطلب مني المستحيل، أن أخون أم أولادي في هذا العمر. لم يقطع غضبي إلا كلمات حانقة منها أشبه بالتوبيخ وكأنها علمت ما أفكر فيه:
– العالم يعرفك ككاتب كبير وليس كزوج وفي أو واعظ ديني. ثق بي، أنا لا أرغب في أن تكون خائنا، بل أريدك وفيا حين يكتب قلمك عن الخيانة. ثم لا تنكر، هاته التجربة ستقيم شبابك وتنفض عنك وهم الكبر. ليلة واحدة ستصحح مفاهيمك عن نفسك عن المرأة وعن دوافع الخيانة.
لا أدري أي القلمين كانت ترغب في نضجه لكن العرض على قدر وساخته على قدر منطقيته. التجربة حتما ستضفي عمقا لكتاباتي ولمسة واقعية في نفوس قرائي. إنها ليست خيانة بل لب الوفاء لكاتب يسعى إلى المصداقية في إبداعاته.
مضت بي إلى شقتها لتزداد دهشتي، الشقة كانت كما لو أنني أنا من صممها، أتراها مهووسة بكتاباتي لدرجة أن تأثثها بطريقة وصفي لشقق المغامرات الليلية؟ عموما ما هي إلا ليلة واحدة وستنقضي.
تبخرت الجميلة بضع دقائق لتحضر عصير التوت ثم رجعت إلي في ثوب شفاف يتماوج فوق تضاريس تصدح هيت لك. كان لدي تساؤل مبدئي قبل الشروع في هدم مبادئي واجتياح مملكة البهاء فصارحتها به:
– ما أجملك وما أبهاك! لكني لا ألمس إنسانة ليست مغرمة بي. هذا هو الفرق بين الخيانة البشرية والبهيمية الحيوانية.
لحظتها تقدمت نحوي، أمسكت يدي اليمنى، تأملتها كأنها قارئة كف وحشرجت بحب:
– أنت خالقي فكيف لا أحبك؟!!
في تلك اللحظة الجنونية عجزت عن الكلام وأحسست بالخدر يجتاحني. حتى في غياهب غيبوبتي حيث لا إحساس ولا شعور كنت أشتعل غضبا من تجديفها.
حالما استفقت وتذكرت جرأتها الرعناء أردت صفعها لكن هيهات.. وجدت نفسي مقيدا في الكرسي وخنجر يداعب رقبتي. تبا للتوت لكن ماذا فعلت لتنتقم مني؟
– يا لك من كاتب فاشل؟ بعد كل هذا لم تتعرف علي؟ هكذا كلمتني وهي تتأملني جاهدا أحاول الانعتاق من قيدي.
اللعنة، أيعقل هذا؟ أيعقل أن تكون رباب؟ لكن كيف تمكنت من التجلي؟
علمت ذات الخنجر حيرتي فأومأت مؤكدة ظنوني وهمست بسادية وجبروت:
– أجل أنا رباب في لحم ودم، رباب بطلة روايتك والتي قتلتها دون أن تكون ملزما لذلك.
– بطلة روايتي الطالبة الألمعية رباب، حبيبة عباس الشخصية الثانوية تطالبني في الواقع بتوضيح حبكتي ودوافعي لموتها في الخيال. كانت متلهفة للتفسير أكثر من لهفتها لعقابي فقلت لها:
– رباب الراوي قد يعلل للنقاد وربما القراء لكن ليس لشخوص خلقهم من خياله. الخالق لا يبرر للمخلوق فأنا من وهبك نعمة الوجود. أنا خالقك يا رباب أنا من قبض من الحبر ونفخ فيه من خياله فصيرك ما أنت عليه. الخالق يا رباب لا يستجدي ولا يهاب مخلوقاته.
لكنها اقتربت مني وبدأت تضغط بشفرتها على ودجي. نظراتها كانت تشي برغبة جامحة في جز عنقي. فجأة توجهت إلى المرآة وناجتها بحرقة وهي تمرر يديها على وجهها ونهديها:
– الموت بعد الوجود أسوأ من العدم. كيف تجرؤ أن تنتزع البسمة من شفتاي، أن تطفئ اللهفة والرغبة بداخلي. كيف تسلب الروح مني بعد أن جعلتني أتذوق الحياة والصداقة والحب؟
– رباب أنا أتفهم ردة فعلك لكني لست الرب لتسأليني عن القضاء والقدر. أنا فقط كاتب أوصلته حبكته لانتهاء وجودك حتى يكون للرواية توازن درامي.
– بل ضحيت بي وحببتني لشخصية دون مقامي لتعيش أنت وتحصد المجد وحدك. أنت الراوي العليم وتعلم كل إحساس بداخلي وحتما تعلم رغبتي في الحياة. أيها الكاتب لمَ لمْ تمهلني؟ لم اختصرت قدري؟ أنا أريد قدرا آخر، وفي الحب أنا لا أقبل بأقل منك.
بعد التفكير وأمام رغبة الحياة في عينيها وعناء التجلي وجرأة التمرد أمامي ارتأيت مكافأتها:
– حسنا … حسنا، سأدبر قيامتك؛ أنا مبدع الرواية كما قتلتك يمكنني إحياؤك.
لحظتها تلألأت عيناها وبدأت تتحرك بسرعة في أرجاء الشقة قبل أن تقول لي والفرحة تشع من وجهها:
– أصحيح ما تقول؟ كنت أعلم أنك تحبني. ثم حررتني من قيدها والتقطتني في حضنها الذي تفوح منه رائحة عباس. وسط تلك المأساة كنا نشكل لحظة كوميدية طريفة، بطلة الرواية تخون حبيبها الغيور مع المؤلف!!
رباه! رباب صنيعتي ألبستها على ذوقي، مشطت شعرها على ذوقي، حتى الشامات نترتها على بشرتها البضة كما اشتهيت فلم أقف أمامها عاشقا مرتجفا مبهوتا كأنها من كوكب آخر؟ أيعقل أن أسقط في حب شيء عجنته يدي وأنقته مخيلتي؟ رباب ما هي إلا أنا في ضمير الأنثى وحبها ما هو إلا نرجسية صرفة. تلك النرجسية هي إذا من أوحت لي ببعثها من الموت تحت ذريعة التحدي الإبداعي. عموما قد يفضي هذا السيرك العاطفي إلى تنوير جديد في الرواية. أمسكتها من كتفيها وقلت لها:
– رباب سأدبر قيامتك لكن إياك أن تعترضي على حبكتي مرة أخرى، هل اتفقنا؟
رباب كانت كأنها في عالم آخر. مجرد منحها الحياة من جديد جعلها تنسى كل شيء، تقدمت إلي بغنج وخيلاء ثم قبلتني وهمست بعمق:
– قتلك زرادشت وأحييتك.
التعامل مع شخص فطن تحت يدك دمار مؤجل؛ رباب اتضح أنها أذكى مما تصورت. لا أعلم كيف استقلت بفكرها عني وأنا من وهبها كل شيء، بل كيف لها ذاك الكبرياء والأنفة؟ أتراني من يكتبها أم أن شخوص الرواية هم من يكتبون اسم الكاتب ومجده؟
في تلك الأثناء اتخذت مكانها في الفراش باعثة لي حبال الفتنة بشبق وفجور. وهي في حضني سألتها عن السبب الذي يدعو أنثى عاشقة للخيانة فقهقهت بصوت ثاقب ثم ردت بانكسار:
– كنت وفية لحبيبي فطعنتني، وكنت وفية للحياة فحرمتني منها. أيها السارد العليم اكتشفني لتعلم حجم خطيئتك؟!
قبل أن ينتصف الليل ودعتها إلى غير رجعة. تركتها نائمة مغتبطة بقدرها الجديد. إنها الحبر المستخلص من أعماق دمي وقد كانت فوق الوصف، شهية كاملة الإبداع تشع حياة وأنوثة حتى وهي مغمضة العينين. لكن الخيانة كالفاكهة الحلوة، بعد القضمة الأولى تهرول الديدان؛ ما إن فتحت باب الشقة لأغادر حتى انتصب أمامي حبيبها عباس غاضبا. غيورا متسرعا كما حبكته لم يمهلني واختصر قدري صائحا “من أنت أيها الخائن؟” ثم غارس شيئا حادا في بطني.
هويت على البلاط مدرجا في أنفاسي ودمي المهرق قد استحال حبرا أسودا. قشعريرة الموت بدأت تكتسحني لكني – بلا حول أو حبكة – كنت أرمقه يتقدم إلى رباب النائمة كأميرة أندلسية ويقف مترددا أمام جسمها النحيل وماسكا بيده قدرها الأول.
دراسة في الميتاسرد والوعي الذاتي للنص في ‘انفلات’ للمبدع الأستاذ عبد الغني تلمام
عبد الغفور مغوار – المغرب
I- تحليل البنية السردية والافتتاح الدرامي – مدخل إلى التوتر، الشخصية، والأسلوب
1- الانفتاح السردي: لحظة المفارقة وتحريض القارئ
يفتتح الكاتب نصه بانزياح شعوري خفي: “في سدفة الليل باغتني إحساس غريب، إحساس بطعم وخزة ضمير”، هذه الجملة الافتتاحية لا تستدعي فقط التوتر، بل تقيم لعبة سردية مع القارئ تنبئ بانفلات الحدث عن المتوقع. النداء الداخلي، مقرونا بالعتمة والضمير، يرسم فضاء مضطربا يستدعي المقارنة مع افتتاحية La Nausée” – الغثيان” لجان بول سارتر، حيث تختلط الذات بالمكان، ويصبح الخارج امتدادا للداخل.
النص ينفتح إذن على قلق وجودي قبل أن يتحول إلى مشهد “مقهوي” تعبيري، ويمنحنا شخصية الراوي/المؤلف الذي سيحمل النص بكامله على كتفيه.
2- الراوي بوصفه شخصية: من كاتب إلى كائن روائي
الأديب عبد الغني تلمام لا يقدم لنا شخصية تقليدية، بل يضعنا أمام كاتب داخل القصة، مما يجعلنا أمام “ميتاسرد” أو “السرد المرآوي” (metafiction) منذ البداية. هذا الكاتب الذي “أقفل حاسوبه” وانطلق نحو المقهى، هو ذاته الذي سيتحول لاحقا إلى ضحية خياله. هذه اللعبة السردية تذكرنا بشخصيات ميلان كونديرا في “كتاب الضحك والنسيان” و”خفة الكائن التي لا تحتمل”. هناك حيث تصبح الشخصية انعكاسا لوعي الكاتب، ويغدو الحكي مساحة للتجريب الوجودي.
في “انفلات”، يتحول هذا الكاتب إلى مرآة تتداخل فيها مستويات الذات، النص، والشخصيات، حتى يصبح سؤال من يكتب من؟ سؤالا مركزيا.
3- المشهد الأول: ظهور الفتاة – استدعاء الرغبة والتشويش الرمزي
مشهد دخول الفتاة يجسد لحظة قلق جمالي: “الفتاة كانت كأنها ملاك تاه عن ملكوت السماء “…
هذه الجملة محملة بنفَس شعري غزلي يضع القارئ بين جمالية المفاجأة وريبة التواطؤ. النموذج الأنثوي الذي يظهر ههنا هو تجل لرغبة مكبوتة، لكنه يتجاوز الواقع نحو الرمزية: فتاة تقرأ أفكار الكاتب! يشبه هذا المشهد دخول المرأة الغريبة في رواية “L’Amant” لمارغريت دوراس، حيث الحضور الأنثوي يغير قوانين الزمن السردي ويجعل من الرواية مساحة للتأمل في الجسد والهوية.
في قصة “انفلات”، تصبح الأنثى – من لحظاتها الأولى – كائنا سيميائيا، رمزا يتجاوز دوره الجمالي إلى مساحة للتوتر الفلسفي والنفسي.
4- اللغة والأسلوب: بين الغواية والتهكم
الكاتب المبدع عبد الغني تلمام يوظف لغة فنية مشحونة بالصور والاستعارات، لكنها لا تنزلق إلى المجاز المجاني. جمل مثل: “ابتسامتها، تلك الابتسامة الخارقة المتغورة.”
تشير إلى رغبة في تقويض المألوف وبناء مفردات خاصة، وهو ما يقربه من أسلوب غسان كنفاني في “عائد إلى حيفا” حين تكون اللغة ذات بعد استكشافي شعوري.
كما يبرز التهكم بوصفه أداة دفاعية لدى الراوي:
“كل النساء في نظري ملائكة تائهة … “
هنا تظهر اللغة كحيلة سردية، تستعمل ليس فقط للتوصيف، بل للمناورة النفسية، وللهروب من الأسئلة الوجودية الأعمق التي تطرحها الفتاة/القارئة.
5- التوتر الأول: لعبة التعارف والمراوغة
المشهد الذي تبدأ فيه المرأة بالكشف عن معرفتها بالكاتب، بل بأعماله، يفتح الباب أمام الميتاسرد:
“أنت تعرفني حق المعرفة وتعرف حتى حبيبي … “
هنا يكسر النص الجدار الرابع وينتقل من الحكي إلى استجواب الذات، بل إلى مساءلة الكاتب عن أخلاقيات الكتابة وأثرها في الواقع، كما فعل الطيب صالح في “موسم الهجرة إلى الشمال” حين وقف مصطفى سعيد يواجه الراوي بحياته كمرآة للتاريخ الاستعماري.
كيف يتجلى ذلك:
– مرآة الراوي:
كلاهما متعلم ومثقف سوداني
كلاهما سافر إلى أوروبا للدراسة
لكن مصطفى سعيد سلك طريق الانتقام والتدمير، بينما الراوي سلك طريق التكيف.
– مرآة التاريخ الاستعماري:
مصطفى سعيد “استعمر” النساء الأوروبيات عاطفيا وجنسيا
استخدم سحر “الشرق الغامض” لإغوائهن
قلب أدوار الاستعمار: الشرقي يستغل الغربيات بدلا من العكس.
المواجهة:
عندما يكشف مصطفى سعيد قصته للراوي، يضعه أمام مرآة مؤلمة تظهر ما كان يمكن أن يصبح عليه، والثمن الحقيقي للصدام الحضاري.
هذا التوازي المرآوي هو من أبرز عناصر عبقرية الطيب صالح في بناء الرواية وطرح أسئلة الهوية والاستعمار.
هذا وفي قصتنا “انفلات” تظهر الشخصية النسائية كقوة سردية قادرة على تغيير مصير الحكاية، بل على قلب أدوار السلطة: من المبدع إلى المخلوق، ومن الكاتب إلى السارد المستجوب.
6- في قلب الانفلات: السرد بوصفه تجربة ميتافيزيقية
كل هذه الإشارات النصية تقودنا إلى نقطة مركزية: القصة لا تحكي فقط حدثا أو علاقة، بل تعيد طرح سؤال الخلق الأدبي من جديد. هل للكاتب الحق في القضاء على شخصياته؟ هل للرواية سلطة على الواقع؟ هل يمكن للشخصيات أن تتجلى خارج النص؟
هذه الأسئلة ليست تجريدية فقط، بل تنغرس في لحظة الخيانة التي تقترحها الفتاة:
“أريدك وفيا حين يكتب قلمك عن الخيانة.”
المفارقة هنا وجودية، تضع الكاتب أمام ذاته لا كمنتج للمعنى فقط، بل كموضوع للتمحيص والتجريب.
-II تجليات الأنثى بين الخلق والتمرد، الكاتب والبطلة – من رمزية الحضور إلى سلطة التجلي
1- تمثيل الأنثى في “انفلات”: بين النمط والاختراق
ظهور رباب في النص هو لحظة مفصلية في البناء الروائي، لا كأنثى اعتيادية، بل ككائن سردي خارق، يخترق العتبة الفاصلة بين الكاتب وشخوصه. وصفها الجمالي المشحون بالإثارة والدهشة، ثم جرأتها المتصاعدة في فرض حضورها، يشكل تحولا في علاقة الراوي بالأنثى: لم تعد موضوعا للخيال، بل أصبحت فاعلا سرديا يتحكم في مصير من كتبها.
هذا يذكرنا بـ”كتابة المرأة”L’Écriture féminine – لهيلين سيكسو، حيث تطرح الذات الأنثوية كثورة لغوية وفلسفية، تربط بين الجسد والكتابة والسلطة وتدعو لتمرد أنثوي ضد اللغة الذكورية.
2- من “ملائكية الأنثى” إلى مساءلة الراوي
رباب لا تكتفي بالحضور، بل تبدأ في مساءلة الكاتب:
“أنت خالقي فكيف لا أحبك؟”!
هذا النداء العاطفي لا يفهم فقط كإعلان حب، بل كإقرار بعلاقة غير متكافئة بين الخالق والمخلوق. تريد رباب أن تحب لأنها وجدت بفعل الكتابة، لكن ماذا يعني أن تمنح الشخصية الأدبية إحساسا بالحب؟ هنا تنقلب الموازين: الراوي لم يعد يملك سلطة تامة على الشخوص، بل بات يسائل من طرفها. بهذا تتقاطع رباب مع شخصية “إيما بوفاري المحاصرة بقناع الزوجة المثالية” في رواية “مدام بوفاري” للكاتب غوستاف فلوبير. إيما تشعر بالاختناق بسبب التوقعات الاجتماعية المفروضة على زوجة طبيب ريفي، والتي تجدها مملة وغير مرضية مقارنة بمُثلها الرومانسية التي اكتسبتها من الروايات. تحاول أن تتوافق في البداية لكنها تشعر بالاختناق.
وهي “تسعى للانفلات عبر الرومانسية والحب المحرم”: هذا هو الصراع المركزي وآليتها الأساسية للتكيف. بسبب خيبة أملها في زواجها وحياتها، تسعى وراء علاقات غرامية غير مشروعة، معتقدة أنها ستوفر لها الحب العظيم والدرامي الذي تتوق إليه.
3- التجلي السردي: حين تتحول البطلة إلى كيان مستقل
لحظة تجلي رباب بوصفها بطلة مقتولة سابقا، تطالب الكاتب بقيامة ثانية، هي لحظة خرق للجدار الرابع، وتحرير للبطلة من سلطة النص الأصلي. تحمل هذه اللحظة نفس المفارقة التي نجدها في رواية “المزيفون – Les Faux-Monnayeurs” لأندريه جيد، حيث تتداخل طبقات السرد والواقع، ويصبح القارئ والكاتب والشخصية في حوار متنقل. فالكاتب إدوارد يكتب رواية بنفس اسم الرواية التي نقرأها، حيث تتداخل مستويات السرد والواقع والخيال، ويدور حوار مستمر بين الكاتب والشخصيات حول عملية الكتابة.
رباب هنا في “انفلات” ليست تجسيدا لأنثى جميلة فقط، بل تجسيدا لسلطة الذاكرة الأدبية، لتمرد الشخوص على المصير، ولرغبة الحياة في وجه الموت الفني.
4- جدلية الخلق والمساءلة: هل الكتابة خلق أم اقتراح؟
تقول رباب في ذروة غضبها:
“الموت بعد الوجود أسوأ من العدم. كيف تجرؤ أن تنتزع البسمة من شفتي …”
هذا التصريح يجعل من القصة تأملا فلسفيا في مفاهيم:
– الخلق الفني بوصفه مسؤولية.
– الكتابة كفعل أخلاقي.
– الشخصيات ككائنات لها حقوق “شبه وجودية”.
يمكن هنا إجراء مقارنة مع “العاشق – ” L’Amant لمارغريت دوراس، فالرواية تقدم مثالا رائعا للتفاعل بين السرد والذاكرة. حيث تواجه الكاتبة ذكرياتها الخاصة، مستعيدة علاقتها بفتى صيني ثري في الهند الصينية الفرنسية خلال فترة شبابها. لا تقدم الرواية تسلسلا زمنيا بسيطا للأحداث، بل هي رحلة متعمقة عبر الذاكرة.
ينشأ حوار مستمر بين الكاتبة الناضجة والفتاة التي كانتها. فالسرد ليس مجرد استعادة للأحداث، بل تأمل من منظور المرأة البالغة التي تنظر إلى ماضيها. هذا يخلق طبقتين صوتيتين تتفاعلان: صوت الفتاة التي تعيش التجربة، وصوت المرأة الناضجة التي تتأملها وتحللها.
رباب بدورها في قصتنا “انفلات” تطلب توازنا بين جمالية النص وعدالة الشخصية.
5- التوظيف النفسي: هل الأنثى هنا رمزية أم إسقاطية؟
رباب ليست فقط شخصية داخل النص، بل تظهر بملامح من صانعها، الكاتب. حين يقول الراوي: “رباب ما هي إلا أنا في ضمير الأنثى…”، فإنه يعترف بأن الشخصية ليست مستقلة تماما، بل مزيج من الذات والآخر.
هذا يكشف عن مستوى عالٍ من الإسقاط النفسي في الكتابة، حيث تتحول الشخصية إلى مرآة داخلية. هنا تتقاطع رباب مع شخصيات كثيرة من أعمال سردية عالمية، والتي تمثل المرأة بوصفها ضميرا ثوريا يخترق الواقع الذكوري.
6- خيانة رباب: من غواية الجسد إلى احتجاج الروح
المشهد الذي تجمع فيه رباب بين الإغواء والحوار الفلسفي يضعنا أمام مفارقة: الأنثى التي تعرض جسدها لمبدعها، ليست تفعل ذلك من باب الرغبة الجنسية فقط، بل باعتباره فعل احتجاج على النص القديم، رغبة في كتابة جديدة للقدر.
حين تقول:
“كنت وفية للحياة فحرمتني منها … “
فهي لا تطلب العلاقة، بل تطلب إعادة التأليف، تطلب أن تكتب من جديد، وهو عمق رمزي يصعب تجاوزه.
-IIIميتاسرد وتمرد الشخصية – من سلطة المؤلف إلى مساءلة الخلق الفني
1- رباب… بين الحبر والدم
عندما تباغت رباب الكاتب، معلنةً وجودها في “لحم ودم” بوصفها بطلة حية تتجاوز سطوره، وتوبخه على مصير كتبه لها دون ضرورة، فإن النص هنا يبلغ ذروة ميتافيزيقية أخاذة. هذه اللحظة، التي تصدح فيها: “أنا رباب في لحم ودم، رباب بطلة روايتك والتي قتلتها دون أن تكون ملزما لذلك”، لا تنقل العمل إلى مجرد منطقة سردية نادرة فحسب، بل تحول فعل الكتابة من مجرد نسج للكلمات إلى فعل خلق أشبه بالخلق الإلهي، وتضع الكاتب في مقام “شبه إله” لكنه معرض للمساءلة والمحاسبة من كينوناته التي أبدعها. وهذا يجسد ما يعرف بـ”أزمة السلطة السردية” في الأدب الحديث، حيث تسترد السلطة من يد الكاتب وتمنح للشخصية أو حتى للقارئ.
هذا التفاعل السردي، وهذا المشهد عميق الصلة بفلسفات أدبية وسردية حاضرة بقوة في أعمال عمالقة مثل خورخي لويس بورخيس وبول أوستر.
أجل، يتردد صدى هذه اللحظة بقوة في عالم بورخيس، حيث تتلاشى الحدود بين الخالق والمخلوق، وتكشف الشخصيات أحيانا عن وعيها بكونها مجرد كيانات سردية. فكرة أن الشخصية تستطيع أن تحاجج مبدعها أو تتحرر من قيوده هي جوهر العديد من متاهات بورخيس الأدبية، التي تجعل من القارئ يتساءل عن طبيعة الواقع والخيال.
أما عند بول أوستر، فكثيرا ما نجد أبطاله، غالبا ما يكونون كتابا أنفسهم، يقعون فريسة لألعاب سردية معقدة. يظنون أنهم يتحكمون في زمام الأمور، ليتفاجؤوا بأن شخصياتهم تمتلك إرادة مستقلة أو أنهم هم أنفسهم مجرد دمى في حبكة أكبر. هذا التملص والاستقلال من قبل الشخوص يمثل تحديا مباشرا لسلطة السارد، ويضفي على السرد طبقات من اللايقين الوجودي.
إن لحظة تمرد رباب ليست مجرد تقنية أدبية، بل هي استكشاف عميق لطبيعة السرد نفسه، وعلاقة الوعي بالخلق، وتساؤل عن حدود السيطرة بين المبدع وإبداعه. إنها دعوة للتأمل في كوننا جميعا، في نهاية المطاف، قد نكون شخصيات في قصة أكبر، نعيش في “لعبة سردية” لا نتحكم بكل خيوطها.
2- مساءلة الكتابة: من “موت المؤلف” إلى عودته المهزوزة
رباب لا تطلب فقط تفسيرا لحدث موتها، بل تعترض على دوافعه، وتطالب بحق سردي جديد:
“أنا أريد قدرا آخر، وفي الحب أنا لا أقبل بأقل منك.” هذا المطلب ليس عاطفيا، بل وجوديا وفنيا. وهي بذلك تعيد طرح سؤال طالما أرق النقاد: هل الكاتب مسؤول عن مصائر شخصياته؟ هل للخيال التزام أخلاقي؟ هل النص ملك للكاتب أم للشخصيات بعد أن تكتب؟
تتقاطع هذه الفكرة مع أطروحات رولان بارت في “موت المؤلف” لكنها هنا تعيد المؤلف من بوابة المحاسبة لا السيطرة.
3- الثورة السردية: حين تكتب الشخصيات مصير الكاتب
في لحظة عنيفة، يطعن الكاتب من طرف عباس – حبيب رباب – بشكل مفاجئ، وصادم دراميا:
“اختصر قدري صائحا ‘من أنت أيها الخائن؟’ ثم غارس شيئا حادا في بطني.” هنا تنقلب اللعبة: الكاتب الذي يقرر مصير شخوصه يتحول إلى شخصية تقتل داخل نصه. السلطة تنتزع، والنص يثور على صاحبه.
في هذا، يتمدد النص نحو التشبيه بمسرحية لبيرانديلو”Six Characters in Search of an Author”، حيث في الأدب الميتاسردي الشخصيات تتمرد على المؤلف وتكسر الجدار الرابع.
4- تشظي الذات الساردة: من كاتب إلى ضحية
يظهر النص حركة سردية دقيقة: الكاتب يبدأ كراو صاحب سلطة، ثم كمجذوب في لعبة التخييل، ثم كمخلوق ضمن نصه الخاص. هذه الحلقات الوجودية تفكك مفهوم الكاتب العارف. تشبه هذه التقنية ما نجده في رواية ” City of Glass لـ Paul Auster”، حيث تتداخل الشخصيات وتضيع الحدود بين الراوي والمروي والمروي عنه.
رباب ليست فقط من تخلق، بل تعيد خلق الكاتب عبر استنطاقه، حبسه، اغتياله سرديا وواقعيا.
5- المفارقة النهائية: من الخلق إلى النرجسية
رباب تقول:
“قتلك زرادشت وأحييتك.” في هذه الجملة، تكمن المفارقة الكاملة: الشخصية التي خلقت بالحب، بالفتنة، بالوعي، صارت ترى في نفسها من يقتل ويحيي. هنا تغدو الكتابة نرجسية مزدوجة، لا تعود تخص الكاتب فقط، بل تمتد إلى الشخصية التي نضجت حتى باتت ترى نفسها خالقة لمخلقها.
وهذا التقاطع بين المعرفة والخلق يعيدنا إلى أطروحة كامو في “أسطورة سيزيف”، حيث يرى أن الوعي بالعبث لا يؤدي إلى الاستسلام، بل إلى تمرد خلاق: إبداع يتحدى العدم دون أن ينكره، وخلق لا يطمح إلى المطلق، بل إلى إثبات الذات في عالم لا يكترث بها. هكذا يصبح الإبداع شكلا من أشكال “التمرد الفني”، الذي يختبر حدود المعقول دون السقوط في الوهم.
-IV الموت، البعث، والحبكة الوجودية – بين الخيانة الأدبية والقيامة الجمالية
1- مشهد الموت: تحول الكاتب إلى ضحية حكايته
في مشهد النهاية، حيث يقتل الكاتب داخل نصه على يد شخصية ثانوية – عباس، حبيب رباب – يتحول السرد من مجرد حكاية إلى تراجيديا وجودية تطيح بسلطة المؤلف نفسه. هذه الطعنة الرمزية لا تنهي فقط حياة الكاتب كشخص داخل النص، بل تقوض أيضا سلطة التأليف ذاتها، حين تتجاوز الشخصيات أدوارها لتصبح فاعلة وصاحبة قرار.
في هذا الانقلاب، يتقاطع النص مع بعض أصداء أدب دوستويفسكي، حيث تتمرد الشخصيات على أطرها الأخلاقية وتطور وعيا خاصا بها، لكنها هنا تذهب أبعد، فتمارس سلطتها داخل حبكة تمردت على خالقها، مما يعيد مساءلة العلاقة بين الكاتب ونصه في ضوء فلسفات ما بعد الحداثة. وإن كان دوستويفسكي غالبا ما يبقى هو “الضمير الخلفي” للنصوص، ولا يحذف نفسه من السرد كما يفعل كتاب ما بعد الحداثة.
2- القيامة الأدبية: من الخلق إلى الفتنة
عودة رباب من الموت ليست فقط انتصارا للشخصية، بل هي إعلان عن خلل في بنية السلطة: لم يعد الكاتب يقرر المصير، بل أصبحت رباب شريكة في التأليف، وغوايتها أداة لإعادة كتابة الواقع.
وحين تقول له: “أنت خالقي، فكيف لا أحبك؟”، يتحول هذا الاعتراف إلى لحظة عشق إبداعي، لكنه أيضا إلغاء للهيمنة الأحادية على الحكاية، وإعلان عن شراكة في التأليف.
وهنا تتقاطع هذه التيمة مع تجربة إلياس خوري، خصوصا في “باب الشمس”، حيث الشخصيات لا تروى بل تروي نفسها، تصحح الحكاية، وتعترض على سلطة السارد. الكتابة عند خوري هي إعادة خلق، ولكنها أيضا إلغاء تدريجي لتفرد الكاتب أمام شخصيات تمتلك ذاكرتها، لغتها، وحقها في إعادة كتابة المصير.
3- الخيانة: هل هي أداة أم غاية؟
رباب تقترح على الكاتب خيانة زوجته كمدخل لفهم الشخصية الأنثوية، لكن العرض ليس جماليا فقط، بل يُطرح كمشروع أدبي لخلق حقيقة شعورية:
“ليلة واحدة ستصحح مفاهيمك عن نفسك، عن المرأة، وعن دوافع الخيانة.”
في هذا الطرح، تتجاوز رباب المفهوم العاطفي للخيانة، وتحوله إلى سؤال وجودي وفني: هل يمكن للكاتب أن يتقمص التجربة حتى ولو خالفت قناعاته؟ وهل يجب أن يحترق ليكتب عن النار؟
هذا يعيدنا إلى تجربة إدوار الخراط، خصوصا في “رامة والتنين”، حيث تصبح العلاقة الغرامية، الملتبسة والحدية، مختبرا داخليا لفهم الذات وكتابة الواقع. لدى الخراط، لا تنفصل اللغة عن الجسد، ولا الكتابة عن المحظور، بل يتحول “الممنوع” ذاته إلى حقيقة جمالية مشروطة بالألم والانكشاف.
4- النهايات المفتوحة: سؤال حول الحقيقة والخيال
لحظة قتل الكاتب وعودة رباب للحضن تمثل قمة التداخل بين النص والواقع، بين الحبر واللحم، بين الفكرة والتجسيد. هل كان كل ذلك حلما؟ تخيلا؟ كتابة داخل كتابة؟ النص لا يعطي جوابا، لكنه يبقي الباب مشرعا أمام اللايقين الفني، ويغدو الأدب عند المبدع عبد الغني تلمام تجربة تحاكي المختبر الفلسفي أكثر من الحكاية الخطية.
خاتمة
قصة “انفلات” ليست مجرد عمل حكائي، بل منظومة سردية مركبة تتداخل فيها الأبعاد النفسية، الرمزية، الوجودية، والفنية. الكاتب عبد الغني تلمام لا يروي حدثا، بل يعيد تشكيل علاقة الكاتب بشخصياته، ويطرح سؤالا جوهريا عن سلطة الخلق، وأخلاق الكتابة، وتمرد الكائنات الورقية حين تمنح حيزا شعوريا.
رباب ليست فقط بطلة، بل فكرة حية، شبح حبر، صوت يعيد مساءلة النص، وتخلق عبر حواراتها فضاء من الذكاء العاطفي والفني. أما الكاتب – وقد صار يُقرأ داخل النص – فيغدو شخصية مثقلة بالتناقضات، ضحية فتنة صنعها، وعاشقا لنرجسية خلقتها يداه. رباب ليست فقط جزءا من القصة، بل صدى داخلي للكاتب، امتحان لموقفه من سلطة الكتابة، استدعاء للسؤال الأخلاقي في الفن.
إن عبد الغني تلمام، في “انفلات”، لا يسطر قصة، بل يشكل نصا تفكيكيا متجددا، يحمل قدرة على استفزاز العقل والوجدان معا. أسلوبه بالغ التوهج، لغته مشحونة بعنفوان بلاغي وجمالية خطيرة، وحبكته تتحول من حدث إلى سؤال، ومن لقاء إلى قدر. إنه كاتب لا يهاب التجريب، ولا يخشى مواجهة شخوصه، بل يمنحهم الحياة، ثم يصارعهم في لحظة القيامة.
إبداعه في هذا النص هو إبداع تتويج وليس ابتداء، لأن فيه كل ما يشبه الكبار: جرأة ميلان كونديرا، دهشة بورخيس، حميمية يوسف إدريس، وتهكم الطيب صالح. لكأن “انفلات” هي لحظة أدبية تنفلت من التصنيفات، وتنسج فكرا أدبيا خاصا يستحق الوقوف عنده بإجلال واحتفاء.
* لائحة المراجع
+ المراجع الأجنبية
– Auster, P. City of Glass, Viking, 1985.
– Belli, G. La mujer habitada, Laertes, 1988.
– Borges, J.L. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Ficciones, 1940.
– Calvino, I. Se una notte d’inverno un viaggiatore, Einaudi, 1979.
– Camus, A. La nausée, Gallimard.
– Duras, M. L’Amant, Minuit, 1984
– Duras, M. La Douleur, P.O.L, 1985.
– Kundera, M. The Unbearable Lightness of Being, Harper & Row, 1984.
– Mishima, Y. Confession d’un masque, Gallimard, 1949.
– Sarraute, N. Portrait d’un inconnu, Gallimard, 1948.
+ المراجع العربية
– إدريس، يوسف. البيوت أسرار. دار الشروق، 1982.
– صالح، الطيب. موسم الهجرة إلى الشمال. دار العودة، 1966.
– نقد الأدب العربي المعاصر
– صبري حافظ. أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية. دار شرقيات، 1996.
– جابر عصفور. زمن الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999.
– فيصل دراج. الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية العربية. المركز الثقافي العربي، 2004.
– إدوار الخراط. الكتابة عبر النوعية. دار شرقيات، 1994.
النص:
انفلات
في سدفة الليل باغتني إحساس غريب، إحساس بطعم وخزة ضمير. أقفلت حاسوبي وقصدت المقهى لعل النفس تروق.
أخذت مكاني المعهود حين استرعت انتباهي شابة تسترق النظر إلي. حاولت تجاهلها لكن الأمر كان مربكا؛ الفتاة كانت كأنها ملاك تاه عن ملكوت السماء أو لعبة تركيب من قطع فتنة وغنج، لكن أكثر ما أربكني فيها هي ابتسامتها، تلك الابتسامة الخارقة المتغورة.
علمت أني لست من النوع المتطفل فقامت وجلست قبالتي بكل جرأة. نظرت إلي مطولا وهمست لي وكل ما فيها يشي أنها استثناء:
– أشكرك على الإطراء الرقيق لكنك تعلم أني مرتبطة.
لم أخلها بتلك السذاجة لتستدرجني بادعاء روضة أطفال فقلت لها:
– لم أكلمك حتى أجاملك.
ضحكت كأن لا أحد في المقهى ثم قربت رأسها مني وهمست بثقة غريبة:
– ألا أستحق أن تشبهني بالملاك التائه؟!
رباه، ماذا أسمع؟ أهي ساحرة؟ أهي قارئة أفكار؟ إنه لشيء جنوني أن تكلم شخصا يعرف فيما تفكر فيه، لكنها امرأة، وفقدان التركيز أمامها أول الهزيمة. استجمعت كبريائي، لملمت دهشتي، رممت نظراتي وقلت لها:
– كل النساء في نظري ملائكة تائهة، ربما تصادف أن سمعته أو قرأته في إحدى رواياتي.
نظرت إلي بنظرة الحليم المتعفف واستطردت قائلة:
– لديك الحق، عموما ألن تطلب لي عصير الليمون ببوظة الفانيلا؟
في تلك اللحظة علمت أن الشابة معرفة قديمة وإن لم أتذكرها. الليمون بالفانيلا طلبته للعشرات حين كنت طالبا في كلية الآداب. عموما اللعبة ابتدأت ولن تهزمني عشرينية متبجحة.
لمعرفة خباياها تجاهلتها ولم أقم بالخطوة المعهودة بسؤالها حتى لا تأخذ ذلك على محمل الاهتمام والرغبة بها فتبدأ في المراوغة والمشاكسة. هي من أتت إلي وهي من عليها التعريف بنفسها. نظرت إليها نظرة باردة متجاهلة وقلت لها:
– حين تظن المرأة نفسها محور الأشياء تصبح كالشمس الحارقة وتتبخر الأشياء من حولها.
ابتسمت المتطفلة وردت:
– أهذا سبب خروجك ليلا؟ تتفادى الوهج والضياء. أتساءل كيف لكاتب كبير أن يلهم الناس وينير حياتهم وهو منزو في العتمة.
إذن هي إحدى قارئاتي دون أدنى شك. لقد كشفت أولى أوراقها ولن يكتمل الليل حتى آتي بخبرها.
– يا آنسة، إن كنت معجبة بي فاعلمي أني متزوج وأحد أولادي في عمرك؛ عبثا تحاولين.
ساعتها توقفت عن الابتسام وردت بأسى يشبه خيبة الانتظار:
– صدقني لم أكن أعرف … الغريب أني التقيتك أكثر مما التقيت حبيبي. أليست هذه أغرب حبكة تصادفها؟
لم أدر عما كانت تلمح إليه فسألتها:
– تتكلمين وكأن لنا سابق معرفة وأنا لم ألتق بك يوما.
في تلك اللحظة انفجرت غاضبة كطفلة أساؤوا فهمها وصاحت:
– بلى بلى أنت تعرفني حق المعرفة وتعرف حتى حبيبي، تكلمتما عني عنوة ووصفتني للناس بالطريقة التي لم أستطع أن أتمالك نفسي فاشتقنا إليك وأتيناك.
في تلك اللحظة أحسست بأني أمام مراهقة تماهت زيادة مع رواياتي ووجب الحذر من التفاتها البلاغي الأقرب للانفصامية فآثرت إنهاء النقاش قائلا:
– آنستي، الوقت متأخر وعلي الرجوع للبيت. أنا كاتب متزوج له سمعة، لذا أستسمحك في المغادرة.
وقتئذ تبدلت قسماتها وباتت أكثر وداعة بل فاجأتني بجواب جريء لم أكن لأتوقعه:
– ثق بي أنا أتفهم حساسية الموقف لكن لدي عرض إبداعي لك. أنت تكتب عن الناس والأولى معرفة حياتهم. ما رأيك أن أسمح لك بالتجربة التي تمني نفسك بها؛ الخيانة مع فتاة جميلة مثلي. أنت تعلم أن أسلوبك جميل لكنه يفتقر لعمق الإحساس حين يتعلق الأمر بالأنثى.
اللعنة! إنها تطلب مني المستحيل، أن أخون أم أولادي في هذا العمر. لم يقطع غضبي إلا كلمات حانقة منها أشبه بالتوبيخ وكأنها علمت ما أفكر فيه:
– العالم يعرفك ككاتب كبير وليس كزوج وفي أو واعظ ديني. ثق بي، أنا لا أرغب في أن تكون خائنا، بل أريدك وفيا حين يكتب قلمك عن الخيانة. ثم لا تنكر، هاته التجربة ستقيم شبابك وتنفض عنك وهم الكبر. ليلة واحدة ستصحح مفاهيمك عن نفسك عن المرأة وعن دوافع الخيانة.
لا أدري أي القلمين كانت ترغب في نضجه لكن العرض على قدر وساخته على قدر منطقيته. التجربة حتما ستضفي عمقا لكتاباتي ولمسة واقعية في نفوس قرائي. إنها ليست خيانة بل لب الوفاء لكاتب يسعى إلى المصداقية في إبداعاته.
مضت بي إلى شقتها لتزداد دهشتي، الشقة كانت كما لو أنني أنا من صممها، أتراها مهووسة بكتاباتي لدرجة أن تأثثها بطريقة وصفي لشقق المغامرات الليلية؟ عموما ما هي إلا ليلة واحدة وستنقضي.
تبخرت الجميلة بضع دقائق لتحضر عصير التوت ثم رجعت إلي في ثوب شفاف يتماوج فوق تضاريس تصدح هيت لك. كان لدي تساؤل مبدئي قبل الشروع في هدم مبادئي واجتياح مملكة البهاء فصارحتها به:
– ما أجملك وما أبهاك! لكني لا ألمس إنسانة ليست مغرمة بي. هذا هو الفرق بين الخيانة البشرية والبهيمية الحيوانية.
لحظتها تقدمت نحوي، أمسكت يدي اليمنى، تأملتها كأنها قارئة كف وحشرجت بحب:
– أنت خالقي فكيف لا أحبك؟!!
في تلك اللحظة الجنونية عجزت عن الكلام وأحسست بالخدر يجتاحني. حتى في غياهب غيبوبتي حيث لا إحساس ولا شعور كنت أشتعل غضبا من تجديفها.
حالما استفقت وتذكرت جرأتها الرعناء أردت صفعها لكن هيهات.. وجدت نفسي مقيدا في الكرسي وخنجر يداعب رقبتي. تبا للتوت لكن ماذا فعلت لتنتقم مني؟
– يا لك من كاتب فاشل؟ بعد كل هذا لم تتعرف علي؟ هكذا كلمتني وهي تتأملني جاهدا أحاول الانعتاق من قيدي.
اللعنة، أيعقل هذا؟ أيعقل أن تكون رباب؟ لكن كيف تمكنت من التجلي؟
علمت ذات الخنجر حيرتي فأومأت مؤكدة ظنوني وهمست بسادية وجبروت:
– أجل أنا رباب في لحم ودم، رباب بطلة روايتك والتي قتلتها دون أن تكون ملزما لذلك.
– بطلة روايتي الطالبة الألمعية رباب، حبيبة عباس الشخصية الثانوية تطالبني في الواقع بتوضيح حبكتي ودوافعي لموتها في الخيال. كانت متلهفة للتفسير أكثر من لهفتها لعقابي فقلت لها:
– رباب الراوي قد يعلل للنقاد وربما القراء لكن ليس لشخوص خلقهم من خياله. الخالق لا يبرر للمخلوق فأنا من وهبك نعمة الوجود. أنا خالقك يا رباب أنا من قبض من الحبر ونفخ فيه من خياله فصيرك ما أنت عليه. الخالق يا رباب لا يستجدي ولا يهاب مخلوقاته.
لكنها اقتربت مني وبدأت تضغط بشفرتها على ودجي. نظراتها كانت تشي برغبة جامحة في جز عنقي. فجأة توجهت إلى المرآة وناجتها بحرقة وهي تمرر يديها على وجهها ونهديها:
– الموت بعد الوجود أسوأ من العدم. كيف تجرؤ أن تنتزع البسمة من شفتاي، أن تطفئ اللهفة والرغبة بداخلي. كيف تسلب الروح مني بعد أن جعلتني أتذوق الحياة والصداقة والحب؟
– رباب أنا أتفهم ردة فعلك لكني لست الرب لتسأليني عن القضاء والقدر. أنا فقط كاتب أوصلته حبكته لانتهاء وجودك حتى يكون للرواية توازن درامي.
– بل ضحيت بي وحببتني لشخصية دون مقامي لتعيش أنت وتحصد المجد وحدك. أنت الراوي العليم وتعلم كل إحساس بداخلي وحتما تعلم رغبتي في الحياة. أيها الكاتب لمَ لمْ تمهلني؟ لم اختصرت قدري؟ أنا أريد قدرا آخر، وفي الحب أنا لا أقبل بأقل منك.
بعد التفكير وأمام رغبة الحياة في عينيها وعناء التجلي وجرأة التمرد أمامي ارتأيت مكافأتها:
– حسنا … حسنا، سأدبر قيامتك؛ أنا مبدع الرواية كما قتلتك يمكنني إحياؤك.
لحظتها تلألأت عيناها وبدأت تتحرك بسرعة في أرجاء الشقة قبل أن تقول لي والفرحة تشع من وجهها:
– أصحيح ما تقول؟ كنت أعلم أنك تحبني. ثم حررتني من قيدها والتقطتني في حضنها الذي تفوح منه رائحة عباس. وسط تلك المأساة كنا نشكل لحظة كوميدية طريفة، بطلة الرواية تخون حبيبها الغيور مع المؤلف!!
رباه! رباب صنيعتي ألبستها على ذوقي، مشطت شعرها على ذوقي، حتى الشامات نترتها على بشرتها البضة كما اشتهيت فلم أقف أمامها عاشقا مرتجفا مبهوتا كأنها من كوكب آخر؟ أيعقل أن أسقط في حب شيء عجنته يدي وأنقته مخيلتي؟ رباب ما هي إلا أنا في ضمير الأنثى وحبها ما هو إلا نرجسية صرفة. تلك النرجسية هي إذا من أوحت لي ببعثها من الموت تحت ذريعة التحدي الإبداعي. عموما قد يفضي هذا السيرك العاطفي إلى تنوير جديد في الرواية. أمسكتها من كتفيها وقلت لها:
– رباب سأدبر قيامتك لكن إياك أن تعترضي على حبكتي مرة أخرى، هل اتفقنا؟
رباب كانت كأنها في عالم آخر. مجرد منحها الحياة من جديد جعلها تنسى كل شيء، تقدمت إلي بغنج وخيلاء ثم قبلتني وهمست بعمق:
– قتلك زرادشت وأحييتك.
التعامل مع شخص فطن تحت يدك دمار مؤجل؛ رباب اتضح أنها أذكى مما تصورت. لا أعلم كيف استقلت بفكرها عني وأنا من وهبها كل شيء، بل كيف لها ذاك الكبرياء والأنفة؟ أتراني من يكتبها أم أن شخوص الرواية هم من يكتبون اسم الكاتب ومجده؟
في تلك الأثناء اتخذت مكانها في الفراش باعثة لي حبال الفتنة بشبق وفجور. وهي في حضني سألتها عن السبب الذي يدعو أنثى عاشقة للخيانة فقهقهت بصوت ثاقب ثم ردت بانكسار:
– كنت وفية لحبيبي فطعنتني، وكنت وفية للحياة فحرمتني منها. أيها السارد العليم اكتشفني لتعلم حجم خطيئتك؟!
قبل أن ينتصف الليل ودعتها إلى غير رجعة. تركتها نائمة مغتبطة بقدرها الجديد. إنها الحبر المستخلص من أعماق دمي وقد كانت فوق الوصف، شهية كاملة الإبداع تشع حياة وأنوثة حتى وهي مغمضة العينين. لكن الخيانة كالفاكهة الحلوة، بعد القضمة الأولى تهرول الديدان؛ ما إن فتحت باب الشقة لأغادر حتى انتصب أمامي حبيبها عباس غاضبا. غيورا متسرعا كما حبكته لم يمهلني واختصر قدري صائحا “من أنت أيها الخائن؟” ثم غارس شيئا حادا في بطني.
هويت على البلاط مدرجا في أنفاسي ودمي المهرق قد استحال حبرا أسودا. قشعريرة الموت بدأت تكتسحني لكني – بلا حول أو حبكة – كنت أرمقه يتقدم إلى رباب النائمة كأميرة أندلسية ويقف مترددا أمام جسمها النحيل وماسكا بيده قدرها الأول.