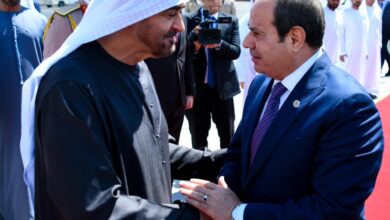إنَّ مقاربة النص الشعري الحديث لم تعد ممكنة عبر القراءة الانطباعية أو التفسير المباشر للمعنى، بل تقتضي اعتماد مناهج نقدية تكشف طبقاته الدلالية وأساليبه الرمزية وبناه النفسية. والقصيدة، بما هي كيان لغوي وجمالي، تُنتج معناها في فضاء التأويل المستمر، حيث يتضافر الأسلوبي مع الرمزي، والنفسي مع الثقافي، في دائرة هيرمينوطيقية تعيد ربط الجزء بالكل. ومن هنا تأتي هذه الدراسة محاولةً لقراءة نص دلال برّو الساحلي «دائريّة الشمس قلّادة» قراءةً تحليلية تأويلية، تستنطق إشاراته وتوتراته الداخلية، وتضيء بنياته العميقة بما يكشف عن صراع الذات بين الانكسار والرجاء، بين إرث الكسور وأفق الخلاص.
1) مدخل إشكالي:
تقترح القصيدة عنواناً مكثّفاً: «دائريّة الشمس قلّادة»؛ صيغة تُحيل إلى ثنائية الزينة/القيد، والنور/الطوق. فالدائرة كمالٌ وانغلاق في آنٍ معاً، والشمس منبع هدايةٍ وقدرةٍ على الحرق. من هذه العتبة الملتبسة تنبثق قصيدة ترسم خرائط رمزية للقداسة والجرح، للماء والنار، للذاكرة والدخان، وتضع الذات بين معموديةٍ تُنقّي ووشمٍ يُقَيِّد.
2) منهج القراءة:
تعتمد هذه الدراسة ثلاثية:
_الهيرمينوطيقا (التأويل الدائري): العودة المستمرة بين الجزء والكل، من الصورة المفردة إلى شبكة الدلالات، ومن السطر إلى البنية.
_الأسلوبية: تتبّع البنى اللغوية والإيقاعية: الجمل الاسمية، الحذف، التوازي، علامات الوقف والتهويم (…).
_الرمزية/التحليل النفسي: تفكيك صور الماء/النار/الزمن/الجسد بوصفها تمثيلات لرغبات، وقلق، وخبرة نقصٍ تُطلب لها فدية الخلاص.
3) العتبات: العنوان بوصفه بياناً جماليّاً:
الدائرة/القلادة: طوقٌ يلمع ويشدّ، زينةٌ وأَسْر. إنها «حلقة» تَعِدُ بالاكتمال لكنها تُنذر بالدوران في المكان ذاته.
الشمس: طاقة كشفٍ وفضحٍ وتطهير، لكنها أيضًا مصدر «دفّاق الجريمة» كما تقول القصيدة؛ أي أن النور نفسه قد يفضح العطب الكامن.
بهذا تتأسّس ثنائية التجميل/التجريم: القلادة تُجمِّل، و«دفّاق الجريمة» يُجرِّم؛ والشخصية المتكلِّمة تُفاوض هذا التعارض في كل مقطع.
4) خرائط الصورة: ماءٌ يتعظ ونارٌ تتهوَّد
4.1 «عِظةُ نهرٍ لا تُبلِّلُ العباءة»
_المفارقة الأسلوبية: النهر يعظ (تشخيص/تجسيد)، والعباءة لا تبتلّ (انتهاك توقّعات الواقع).
_الدلالة: ماءٌ لا يبلّل هو ماء رمزي (لغة/وعد/نص)، وموعظة النهر تُحيل إلى معموديةٍ بلا أثر، إلى طقس خلاصٍ معطَّل.
4.2 «ذاكرةُ دخانٍ» و«غزوةٌ في حانة الإيماء»
_ تركيب صدامي: الدخان ذاكرة لا أثر ثابتاً لها، و«الغزوة» (معجم الحرب/الفتوحات) تُزاح إلى «حانة» (معجم اللذة)، و«الإيماء» (لغة الجسد والإشارة).
_ النتيجة الأسلوبية: كولاج دلالي يركّب المتنافرات؛ وهو توقيع القصيدة الأسلوبي: الجوّانية تُترجم بمتقابلات حادّة.
4.3 «هذا ماءٌ عذبٌ فُرات».
تضمين ديني صريح: عبارة قرآنية تُستعاد في مقام التبشير بالنجاة («نبيّ الخلاص»/«معجزة المسيح»).
_ التناصّ المزدوج: المسيحي/الإسلامي؛ ما يُنتج لاهوتاً شعرياً هجيناً يَعد بالخلاص المائي (المعمودية/الفرات) بعد «حفلاتٍ ليلية» (سرد الخطيئة/السقوط).
5) الحقول الرمزية الكبرى:
_1. الماء: خلاصٌ مؤجّل، تطهيرٌ مشروط، معموديةٌ بلا بلل.
_2. النار/الشمس: كشفٌ جارح؛ نورٌ يفضح جريمةَ الأصل/الواقع.
_ 3. المكان المقدّس: «مآذن تبكي»، «كنائس الْمَتَى ومتى؟»—جناس دلالي يخلط «إنجيل متّى» بالسؤال «متى؟»، أي أن قداسة المكان تُطارِدها رهبة الزمن المؤجَّل.
_ 4. الزمن: «قبل فوات الأوان»، «كذبة الساعة الآنفة»—زمنٌ مختلّ، كرونولوجيا مخرومة بين استعجال الخلاص وكذبة القياس.
_ 5. الجسد/الهوية: «أورّثني مجموعة كسور»، «منهوب الأصابع»—هوية متكسّرة، كتابة مسروقة، ذاتٌ محرومة من أدوات التعبير.
_ 6) البناء النفسي: من إرث الكسور إلى حلم الخلاص:
أنا المنكسِر/أنا المتعالي: الوريثة «مجموعة كسور» و«كَسح تسبيحة» تقابل «طائرة ورقية» تحمل «زاجل الأسماء» و«زغردة المدى». النفس بين تدنّي القيمة (شعور العجز/العار) وبين تخييل الخفّة والتحليق.
_سيمياء النقص: «ناقصة، فارغة» تفتتح مقطعاً؛ النقص ليس وصفاً عابراً بل هوية سردية تتطلّب «نبيّ الخلاص».
_النداء الصوفي: «يا مدد يا مدد»—طلب إمداد يتجاوز المؤسسة الدينية («المآذن تبكي… الكنائس…») إلى اختبار روحي مباشر؛ وبعبارة الخاتمة: «إنّ الله في النهاية»—تلخيص وجوديّ يُعيد مركز الثقل إلى ميتافيزيقا الرجاء.
_7) المعجم الديني وتوليد المعنى (هيرمينوطيقا التناصّ)؛
آدم/الضلع: استعارة الخلق الناقص/المنحاز إلى «العلاقة»، لكنها تُروى هنا بوصفها تعزيزاً لجرح الأصل («عاريةً منسية»).
المسيح/المعجزة + القرآن/الماء الفرات + الصيغة الصوفية/المدد: تراكُب مرجعيات لا يُقصد به التلفيق بل بناء معجم خلاصٍ كوني؛ إذ يصبح الدين لغةَ تخييل قبل أن يكون منظومة لاهوتية مغلقة.
_المؤسسة/القداسة: «تسابق كنائس المتى ومتى؟» نقدٌ شفّاف لتحوّل المقدّس إلى سؤال بلا جواب حين تُحاصره «كذبة الساعة» أي تلاعب الزمن/الطقس بالحدث.
_8) أسلوبيات النص: موسيقى البياض وتواتر الحذف
الجمل الاسمية تطغى، فتولّد ثِقَلًا تشكيلياً يثبّت الصورة ويؤجّل الفعل («غامرةٌ في كتاب الوهدة… ناقصةٌ، فارغةٌ…»).
علامات الحذف (…) ليست زينة طباعية؛ إنها إيقاع التردّد، نبض النفس المتقطّع، وتكثيف «اللا-مكتمل».
التوازي والترديد: «إلى طرقاتك، إلى أشجارك، إلى مآذن…»—درجٌ لفظي يصنع حركة لهاث تُحاكي «الهرولة».
_الاستعارة المركّبة/المركّبة المضادة: «غزوة في حانة الإيماء»، «عِظة نهر»، «كَشح ضوء للبلّور»—توليف صوري يجعل الواقع نفسه مجازاً.
_9) جدل الغموض والفهم: متى يكون الإبهام وظيفة جمالية؟
القصيدة لا تتعمّد الإغلاق بقدر ما تُراهن على «الإيحاء المُنتِج»:
حين تقول الشاعرة دلال برّو السَّاحِلي «نهر يعظ» و«ماء لا يبلّل» فهي لا تُلغي المعنى، بل ترفعه طبقةً نحو التأويل: ماءُ الطقس لا ماء الطبيعة، خلاصُ اللغة لا خلاص الفيزياء.
وحين تمزج «المآذن الباكية» بـ«كنائس المتى ومتى؟» فإنها تفتح سؤال الزمن الديني: هل الخلاص حدثٌ أم وعد مؤجّل؟ هنا يتحوّل الغموض إلى استراتيجية قراءة لا إلى عجزٍ عن البيان.
_ 10) البنية السردية المضمَرة: من «العابرة الحافية» إلى «الله في النهاية»
_ يمكن رسم قوس سردي خفي:
1. عبور/تشهي الجريمة → 2) محاولة نهوض بذاكرة الدخان → 3) استدعاء معجزة/نبي الخلاص → 4) استعطاف طقسٍ يُطعم الجوع → 5) جرد الإرث المكسور → 6) إعلان الخَلق/الولادة الرقمية/الرمزية → 7) توسّل المَدَد → 8) تثبيت خاتمة ميتافيزيقية: «إنّ الله في النهاية».
إنها حركة خلاصية مكسورة: تتقدّم وتتعثر، تؤمن وتشكّ، لكنها لا تتخلّى عن أفق الرجاء.
_11) ما أجده من ملاحظات نقدية :
_ قوة القصيدة في اقتصادها الدرامي: كل صورة مشهدٌ كامل.
_ أخطر مواطنها أيضاً في الإفراط بالتكثيف التناصي الذي قد يربك قارئاً بلا عدّة معرفية؛ غير أن هذا جزء من استراتيجية الاختبار: القصيدة «تخلق قارئها».
كما اجدني امام اقتراح تحريري طفيف : وهو تقنين مواضع علامات الحذف للإبقاء على شدّة التوهّج من غير تشتيت بصري، والتمييز بين «الانزياح الخلّاق» و«التراكم المصطلحي» في بعض المقاطع الرقمية/الوزنية.
_ 12) خاتمة: القلادة كعتبة خلاصٍ لا كَفَلَة سجن:
تُثبت «دائريّة الشمس قلّادة» أن الغموض ليس عجزاً عن المعنى، بل وسيلة لتكثيره؛ وأن التناصّ الديني، متى تحرّر من السياج الطقسي، يتحوّل لغةً للنجاة. الذات الشاعرة، وقد ورثت «مجموعة كسور»، لا تستنكف عن المطالبة بـ«ماء عذب فرات» يَصل ما انقطع. وهكذا يغدو الطوق وعدًا بالدائرة الكاملة: ليس قفصاً حول العنق، بل هالة حول جبهةٍ تعلّمت أن تقول، في نهاية المطاف: «إنّ الله في النهاية»—لا باعتباره خاتمة خطاب، بل باعتباره **أفقًا يضمّ الشذرات المتناثرة في وحدة معنى.
كما اجدني قريباً من التأكيد على زجود ملحق موجز باقتباسات مفتاحية داخل التحليل:
_«عِظة نهر لا تُبلّل العباءة» — معمودية بلا أثر (طقسٌ مُعطَّل).
_ «كنائس الْمَتَى ومتى؟» — جناس لاهوت/زمن.
_ «أورّثني مجموعة كسور» — هوية مُفتّتة تطلب لغةً تلحمها.
_ «يا مدد يا مدد» — نداء صوفي يستعيد الروح من قبضة المؤسّسة.
_ «إنّ الله في النهاية» — وهو تلخيص ميتافيزيقي يعقلن الفوضى.
نص القصيدة :
دائريّة الشمس قلّادة
إن اشتاقتْ لِدفّاق الجريمة …
عابرةً حافيةً تَمشي الى :-
عِظة نهر لا تُبلّل العباءةْ ،
غامرةٌ في كتاب الوهدة …
ناقصةٌ ، فارغةٌ ،
لكأنّها شريعةٌ عفويّةْ ،
تُسنّ عُضْويّتها
خارج لهفة النافذةْ …
****
و قبل فوات الأوان
تُحاول النهوضَ بذاكرة دخانٍ
تَعبِق غزوة في حانَة الإيماء ،
فبعد غياهبٍ حفلات ليليّة
تَنتظر مُعجزة المسيح
فعلَّ نبيٌ الخلاص
يُغبّش مِلح أمواج بحريّة
هامِساً « هذا ماءٌ عذبٌ كفُراتِ » …
****
و علّ سُجود مؤمنٍ
يُطفئ سيْماء الجوع على الفم …
و يُنهي سِمات الهرولة إلى طرقاتك ،
الى اشجارك ، الى مآذن تبكي ،
و في كنَف كذبةِ الساعة الآنفةْ
تسابق كنائس الْ مَتى و متى؟…
****
هذا الراسخ على دياري
أوْرثني مجموعةَ كسورٍ ،
أهداني كَسْحَ تسبيحة ،
و كَشْح ضوءٍ للبلّور …
كطائرة ورقيّةْ جئتُ
أُحَمِلّها زاجِل الأَسامي
و صيدَ زغردة المدى …
****
ها قدْ خَلقْتني يا ربّاهُ
من ضِلع آدمٍ عاريةً مَنسيّةْ ،
و مِن صفرٍ إلى رمزيّة تاريخ ميلادي
كأربعِ و ثلاثين ثِقلٍ ، كمِعيار حنين ،
كَكَنزِ مجموعةٍ رقْميّةْ ،
كسيف قاطع لِلّوحي ،
منهوب الأصابع …
فَدُمْتُ خارج شِعاب الذات
و خِمارَ الروح تئنّ و تُلحّنُ
يا مَددْ يامَددْ أُغنيةً بلا قيودٍ
« إنّ الله في النهاية »