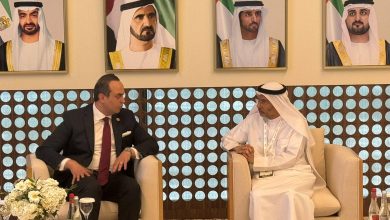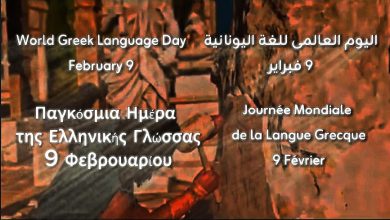حينما نعشق شموخ الرجال، قراءة هيرمينوطيقية– أسلوبية–رمزية لقصيدة لميعة عباس عمارة
بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين.
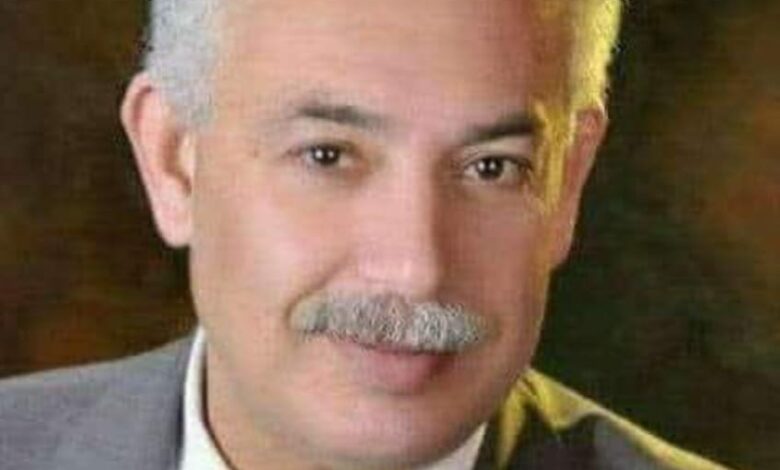
بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين.
تتأسّس هذه القراءة على ثلاث مقاربات تتعاضد ولا تتنافى:
_ 1. الهيرمينوطيقا بوصفها فنّ فهم المعنى المتحرّك عبر جدل السؤال والجواب و«اندماج الآفاق» (غادامر): نصٌّ عاش في سياقٍ ثقافيٍّ وتاريخيٍّ معيّن، وقارئٌ يأتي بأفق انتظاره وأسئلته.
_ 2. الأسلوبية التي تُعنى ببنية القول، إيقاعه، تكراراته، وصوره البلاغية وأثرها الدلالي.
_ 3. الرمزية–التحليل النفسي: تفكيك الحقول الرمزية ومرافقتها بالبُنى الوجدانية (التماهي، الإسقاط، المثالية، التذبذب الإيروسي–التاناتوسي…).
ينطلق السؤال المؤسِّس: ما الذي يجعل «شموخ الرجال» موضوع عشقٍ وافتتان؟ وهل العشق هنا انفعالٌ بريء، أم آليةُ نفسٍ تبحث عن خلاصٍ رمزيٍّ في صورةٍ عُلويةٍ متجاوزة؟
— أولاً: أفق الدلالة — من «الشموخ» إلى بنية التوق:
يفتتح القول بتعريف علاقةٍ غير متكافئة ، تقول:
«أغازل فيك شموخ الرجال / ويمنعني عنك هذا الخفر».
الخطاب موجَّه إلى «أنت» ذي مقامٍ متعالٍ؛ فالمرأة لا تعشق «رجلًا» فحسب، بل صورة الشموخ بوصفها قيمةً مُطلقة. هنا تظهر آلية التجريد المثالي: المحبوب يتحوّل إلى حاملٍ لصفةٍ كلية («الشموخ»)، فتتضاءل فرديّته لحساب رمزيته. هذا التعالي يصطدم بحدٍّ داخليٍّ: «الخفر». إنّه حدٌّ أخلاقي–ثقافي، يحفظ المسافة ويُنتج توتّر القصيدة بين الانجذاب والتحفّظ.
يُعزّز النص هذا التعالي بمفرداتٍ كبرى: «حُلمٌ محال»، «أسطورة»، «ضياء القدر». نحن إذن أمام كتالوج تعالٍ يرفع موضوع العشق من التجربة اليومية إلى علويّات الحُلم والمصير. الهيرمينوطيقا هنا تُعلّمنا أنّ النص يفاوض تراثًا ثقافيًا عربيًا يمنح «الرجل الشامخ» مكانة الأب–الحامي/البطولي، لكنّ الشاعرة لا تذوب تمامًا في هذا المتخيَّل؛ فهي تفاوضه بوعيٍ نقدي تُفصح عنه الآيات اللاحقة.
–ثانياً: الاقتصاد الأسلوبي — بناء توتّرٍ صوتيٍّ ودلالي:
_ على المستوى الصوتي، تتكاثف الراء قافيةً وحرفًا قَلْقَليًّا: «الخفر/غبر/القدر/استقر/الغجر/لا يُغتفر/المنتظر…». للرّاء خشونةٌ موسيقية تُناسب جدل العاطفة القاسية في القصيدة؛ إنّها حبٌّ يَخدش، ويقينٌ يتعثّر.
_ التوازي التركيبي: «أَفِق أيّها القلب… أفق أيّها القلب»، يكرّس وظيفة النداء/الاستنفار.
_ الطباق والمفارقة: «أوجِعْ، فظُلمك ما نشتهي»؛ جمعٌ بين اللذّة والأذى، يشي بتعالق الإيروس والتاناتوس.
_ الأمر والخطاب الجدلي: «أعد لي الهوى… وأطلق سراحي… أوجع… ضلّل…». بنية الأمر موجّهة مرّةً إلى «الزمن»، ومرّةً إلى «المحبوب»، ومرّةً إلى «القلب». تتوزّع السلطة إذن بين ثلاثة أقطاب: القدر/الآخر/الذات، ما يخلق مسرحًا داخليًّا تتنازع فيه القوى.
نلحظ كذلك تنامي المشهدية من عاطفةٍ متردّدة إلى قَدَريةٍ ملتهبة، تقول:
«سلامٌ لحرّك يشوي الوجوه / أذبتَ به الصبر حتى انفجر».
البيت يرسم فيزيولوجيا الوجدان: حرارةٌ تشوي، صبرٌ يذوب، ثم انفجار. إنّه تصعيدٌ إيقاعي– تصويري يوازي تصعيدًا نفسيًّا من الكبت إلى الانفلات.
–ثالثاً: الحقول الرمزية — من «الزاهدين» إلى «الغجر».
تشتغل القصيدة على حقلين متقابلين:
1. الزهد/القفار/الوبر، تقول :
«تبلّدتْ من عيشة الزاهدين / ونوم القفار، ولبس الوبر»
الزهد هنا ليس قيمةً روحيةً خالصة بل قشرة بلادة؛ إنه انطفاء الحسّ وتحجّر الانفعال. «الوبر» — باعتباره لباس الخشونة والبداوة — رمزٌ لـتقشّفٍ قاسٍ يُميت النبض ويجفّف العاطفة.
_ 2. الهوى/الغجر/الحرّ:
«أعد لي الهوى… وأطلق سراحي انطلاق الغجر»
الغجر يحضرون كاستعارةٍ لـحرّية الجسد والرحيل والرقص؛ إنّه نقيض الزهد والتبلّد. بهذا التقابل، تنسج الشاعرة معمارًا رمزيًا يُظهر خبرةً أنثوية تُريد استعادة جسارتها من منظومة الكبت الاجتماعي.
_ وتلوح قمة المفارقة في:
«أوجِعْ، فظُلمك ما نشتهي / وضَلِّلْ، فذنبك ما يُغتفر»
الذنب «غير المغتفر» هو ذاته موضوع الاشتهاء؛ وهنا تتبدّى بنيويّة السادية–المازوشية (بالاصطلاح التحليل–نفسي): تستمدّ الذات لذّتها من قسوة الآخر، وتحتفظ في الوقت نفسه بمحكمةٍ أخلاقية لا تمنحه البراءة. هذا الحدّ المزدوج يصنع توازناً مَرَضيًّا مستقراً/غير مستقر: «وكم يستقر إذا ما استقر».
–رابعاً: الدراما النفسية — القلب كذاتٍ مقسومة:
يتحوّل «القلب» إلى مخاطَبٍ مستقلّ. ، تقول :
«أَفِق أيّها القلب… هذا النشور / وذاك صاحبك المنتظر»
القلب «موضوع نداء» و«مَحلُّ إنذار». الانقسام النفسي يبدو جليًّا: ذاتٌ آمرة وذاتٌ مأمورة؛ فالأنا الأعلى (الأخلاقي/الثقافي) يوبّخ، فيما الأنا الراغبة تهفو.
_ المثالية والإسقاط: المحبوب يُرفَع إلى مقام القدر: «مشيئته أنتَ، لو لم يشأ / محاك، وأخلى قلوب البشر». إنّه توحيدٌ رمزي بين الآخر/الإلهي؛ آلية إسقاط تمنح العلاقة شرعية ما وراء بشرية، فتُعفي الذات من مساءلة رغبتها أمام معيار العُقلنة.
_ التذبذب الإيروسي–التاناتوسي:
«ترى الحبَّ والموتَ في راحتيه»
الحبّ والموت في كفّ واحدة: تواطؤ الرغبة مع الفناء، وذروة «اللذّة المقرونة بالخطر». لذلك يُختَتَم التخيير: «وما لك بدّ، ففيم الحذر؟» — استسلامٌ بطوليّ لقدرٍ ملتهب.
تؤسِّس هذه البنية لِما يسمّيه علم النفس الأخلاقي التبرير العاشق: حين تُرفَع العلاقة إلى عليّات الأسطورة، تتضاءل المحاسبة، ويتحوّل الألم إلى قربان هوية، تقول :
«أنا من قرابينك اللايزال / بها من مسيس المنايا أثر».
هنا تُعلن الذات هويتها بوصفها «قربانًا»، أي أنّ المعنى لا يكتمل إلا عبر طقس الألم. هذا التشييد الهووي يُفسِّر قبول «الظلم المشتهى» دون أن يُسقط معيار الإدانة (لا يُغتفر).
–خامساً: الهيرمينوطيقا الاجتماعية للجندر — عشق السلطة المتعالية:
يتبدّى «شموخ الرجال» قيمةً جندريّة–ثقافية: إنّه أُبُوّة رمزية تجتذب الأنثى لا لقسوتها بل لـهيبتها الضامنة. غير أنّ القصيدة تكشف ثمن هذه الهيبة: القرب منها يستلزم قبولًا بدرجةٍ من القسوة والهيمنة.
_ «الخفر» علامة أخلاق/حياء يفرض المسافة، لكنه في الوقت نفسه يُؤبِّد هيمنة الآخر بوصفها بهاءً لا يُطال.
_النداءات والأوامر تعيد توزيع السلطة: المرأة تأمر «القلب» و«الزمن» و«المحبوب»، لكنها في العمق تفاوض سلطة الشموخ: تريدها وتخشاها، تُدينها وتستلذّ بها.
بهذا المعنى، لا يقع النصُّ في رومانسيةٍ مُسالِمة؛ إنّه يفكّك سحر السلطة الذكورية من داخل افتتانها. فالشاعرة تعترف بالسحر وتفحص ثمنه، تمجّد الشموخ وتكشف قسوته، فتقدّم وعيًا نقديًّا مزدوجًا: وعي الرغبة ووعي الحدّ الأخلاقي.
—سادساً: المكوّن الأسلوبي الدقيق — علامات دالّة:
١ _ حركية الأفعال: «أغازل/يمنعني/أعلم/أفق/أطلق/أوجع/ضلّل»… أفعالٌ مضارعة وأوامر تصنع ديناميّة مسرحية تُحسّس القارئ بوجود زمنٍ يتدفّق لا سردٍ ساكن.
٢ _ التقفية المرنة: ليست القصيدة محكومةً بـبحرٍ تقليدي صارم (تجنّبُها للوزن الكامل ظاهر)، لكنها تستعير تواقيع صوتية (الرَّوي بالراء) تمنح وحدةً إيقاعية تُثبّت المعنى في ختام الأسطر، كأنّ كلّ سطر يُطرَق بمِطرقة الراء.
٣_ الاستعارة الكلّية: «إضمامة من ضياء القدر» — الحبّ باقة نور قدريّ؛ «سلام لحرّك يشوي الوجوه» — «سلام» (تحيّة) لحرٍّ يُشوي (أذى): سلام/شواء مفارقة تُنتج أثرًا صاعقًا؛ إنّه «سلام إلى الألم» لا «سلام من الألم».
–سابعاً: البنية الأخلاقية للنص — الذنب الذي لا يُغتفر:
«وذنبك ما يُغتفر»: لا يغدو الذنب مغفورًا على الرغم من أنّ الألم مشتهى. هذا ميزانٌ أخلاقيٌّ رصين: الرغبة لا تُعطِّل الحكم القيمي. الهيرمينوطيقا هنا تكشف عن ضميرٍ يقظ يرفض شرعنة الأذى حتى وهو ينجذب إليه. لذا فالعلاقة ليست سقوطًا حرًّا في السادية–المازوشية، بل مختبرٌ لأخلاق الرغبة: كيف نعترف بجاذبيّة القوّة دون أن نبرّر قسوتها؟
—ثامناً: التوتّر بين الأسطورة والتاريخ — تفكيك «زمانٍ غبر»
«أسطورة من زمانٍ غبر»
الأسطورة ليست حكاية قديمة فحسب، بل آلةُ معنى لا تزال تعمل: نحن نعشق اليوم بما ورثناه من «زمانٍ غبر» — أي زمنٍ غبرته المخيّلة البطولية. تنبّهنا القصيدة إلى أنّ التراث العاطفي يُعيد إنتاج ذاته في أهوائنا الراهنة: نتماهى مع «المُرتَفع» ونطلب «الخلاص» في ظلّه، حتى لو كلّفنا ذلك ألمًا.
—تاسعاً: جدل الحرية والقدر — «مشيئته أنتَ»:
«مشيئته أنتَ، لو لم يشأ / محاك، وأخلى قلوب البشر»
كأنّ الآخر مُفْرَد القدر؛ إن شاء امتلأت القلوب، وإن لم يشأ خلت. هذه صياغة لاهوت العشق: الحرية مُعلّقة بإيماءة المحبوب. غير أنّ الأبيات اللاحقة تعود لتطالب بالحرية: «أطلق سراحي انطلاق الغجر». إذن فالنص يتأرجح بين تسليمٍ وقدَرٍ، وبين توقٍ إلى انعتاقٍ جسور؛ وهذا التأرجح هو جوهر الدراما.
—عاشراً: خاتمة تركيبية — جمال التناقض ومأساة الوعي:
قصيدة «حينما نعشق شموخ الرجال» تُنجز ما يُشبه أوتوبوغرافيا للهوى الممتحَن: هوى يفتتن بالعلوّ ويخشى سطوته، يستعذب الألم ولا يسقط في ابتذاله، يُدين الذنب ولا يُنكر سحره. أسلوبيًّا، تُشيّد لميعة فضاءً إيقاعيًا مُحكمًا تُديره قافية الراء وحركية الأوامر والنداءات، فتخلق مسرحًا داخليًا تتنازع فيه رموز الزهد والحرية، القدر والاختيار، اللذّة والخطر.
نَفسيًّا، تكشف عن ذاتٍ واعية بانقسامها: تُنازِل صورةً ذكورية متعالية، تعترف بأثرها القاهر، لكنها تُصِرّ على حفظ معيار أخلاقي يُجرِّم القسوة ولو غُلِّفَت بالهيبة.
بهذا كلّه، لا تكتفي القصيدة بتصوير حكاية عشق، بل تقدّم تفكّرًا في أخلاق الرغبة: كيف نصوغ علاقةً مع القوة/الشموخ لا تستمدّ معناها من الأذى، بل من كرامة المشاركة؟ إنّ سؤال القصيدة الأخير ليس: «هل نعشق الشموخ؟» بل: كيف نُنقِذ العشق من شهوة الهيمنة؟ — وهو سؤالٌ جماليٌّ وأخلاقيٌّ معًا.
–ملحق تطبيقي: مفاتيح قرائية موجزة:
_ جدل المفارقة: «أوجِع… ظلمك ما نشتهي» ← قراءة عبر مفهوم «اللذة المجبولة بالخطر» .
_صورة «الغجر»: استعارة لإرادة التحرّر الجسدي والنفسي مقابل «الزهد/القفار».
_الأمر والنداء: تمكينٌ شكليٌّ للذات في قلب علاقة غير متكافئة؛ لغةٌ تأمر كي لا تنهار.
_ الذنب غير المغتفر: حفظُ معيار الإدانة الأخلاقية يمنع الرومانسية من تبرير العنف الرمزي.
_ الأسطورة الحيّة: «زمان غبر» ليس ماضياً منقطعًا؛ إنّه ذاكرة فاعلة تُعيد تشكيل رغباتنا.
— قضايا بحثية :
_ مقارنة هذا المتخيَّل بـ«الهيبة الذكورية» عند بعض شعر نزار قباني أو بدر شاكر السياب لرصد اختلاف تمثيل السلطة العاطفية.
_ تطبيق قراءة يونغية للرموز (القربان/الحر/الزاهد) بوصفها أرْكِيتايبات (نماذج أولى) تتكرّر في الذّاكرة الجمعية.
تحليل أوسع لبنية الصيغة الأمرية في شعر لميعة وأثرها في تمكين الصوت الأنثوي داخل شرطٍ ثقافي محافظ.
بهذه القراءة، يتبدّى أن لميعة عباس عمارة لا تُسبِّح بحمد «الشموخ» على نحوٍ امتثالي، بل تُفكِّك فتنتَهُ وتدفع القارئ إلى محكمةٍ أخلاقيةٍ دقيقة: العشق لا ينسى كرامته، حتى حين يَميلُ إلى النار.
نص القصيدة :

لميعة عباس عمارة » حينما نعشق شموخ الرجال
” حينما نعشق شموخ الرجال
أغازل فيك شموخ الرجال
ويمنعني عنك هذا الخفر
وأعلم حبك حلم محال
وأسطورة من زمان غبر
وحبك وهم تخطى النجوم
وإضمامة من ضياء القدر
بأي الضلوع أضـم هواك
وكم يستقر إذا ما استقر
أعد لي الهوى يازمان الهوى
وأطلق سـراحي انطلاق الغجر
وأوجع ، فظلمك مانشتهي
وضلل ، فذنبك مايغتفر
مشيئته أنت ، لو لم يشأ
محاك ، وأخلى قلوب البشر
أفق أيها القلب ، هذا النشور
وذاك صاحبك المنتظر
تبلدّت من عيشة الزاهدين
ونوم القفار ، ولبس الوبر
وصيغت جزافا لك الشائعات
من كل وهم ببال خطر
أفق أيها القلب ، او لا فمت
فأوجع حاليك : خوف الخطر
ترى الحب والموت في راحتيه
ومالك بد ، ففيـــم الحذر
سلام لحرِّك يشوي الوجوه
أذبت به الصبر حتى انفجر
ترى جلدا ً لي ؟ ففيم الجفاء
أمثلك يقسو إذا ما اقتدر ؟
أنا مـن قرابينك اللايزال
بها من مسيس المنايا أثر”