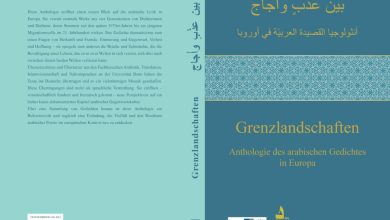على حافة برهة للشاعرة منال رضوان قراءة هيرمينوطيقية– أسلوبية–رمزية–جمالية–وطنية–سيميائية:.
بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين.
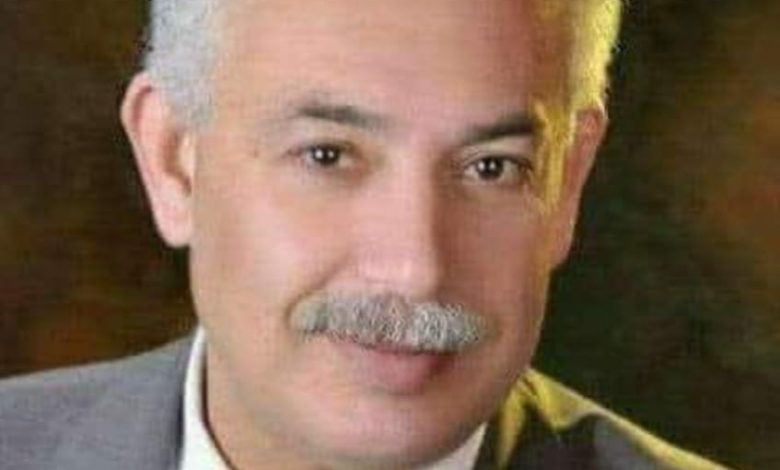
١. مقدمة في العتبة النصية والتموضع الأسطوري:
يبدأ النص من عتبةٍ مثقلة بالرمز الأسطوري: «في تقليد مهيب لتسابيح أورفيوس».
العنوان لا يُقدّم مفتاحاً بل يفتح باباً للتأويل، إذ يحيل إلى الأسطورة الإغريقية التي تتمحور حول “أورفيوس”، الشاعر والمغنّي الذي استطاع بصوته أن يلين صخور الجحيم، وأن يُعيد زوجته “يوريديس” من الموت، لكنه يفشل حين يلتفت إليها قبل عبور العتبة الأخيرة.
توظيف الشاعرة لهذا البعد الأسطوري لا يأتي بوصفه استعارةً جاهزة، بل بوصفه رمزاً ميتافيزيقياً للبحث عن الخلاص، وللصراع بين المعرفة والخطيئة، بين النشيد والحقيقة، بين الرغبة والفقد. فالعنوان، بما يحمله من جلال التعبير “في تقليد مهيب”، يضمر طقساً شعائرياً شعرياً، يجعل من القصيدة نفسها تسبيحةً مغايرة تنشد خلاصها في زمن فقدَ موسيقاه.
٢_ المنهج الهيرمينوطيقي: تأويل الدلالة وانفتاح النص.
القصيدة تتحرك في حقلٍ دلاليّ يتجاوز ظاهر الكلمات إلى باطنها الرمزي، فهي ليست عن “أورفيوس” بقدر ما هي عن الإنسان/الشاعرة/الأنثى التي تحاول أن تُعيد عبر النشيد نظام المعنى في عالمٍ مفكك.
قولها:
عزفت الأفعى أنغامها الزرقاء،
بوتر مشدود على حافة برهة.
هنا نقرأ الأفعى تأويلياً لا كرمزٍ للشر، بل كعلامة مزدوجة تجمع بين المعرفة والإغواء، الحياة والموت. اللون الأزرق يضاعف هذا التوتر، إذ يشير إلى البُعد الروحي والصفاء، لكنه في الوقت نفسه يوحي بالبرودة والانفصال. الأفعى الزرقاء إذًا كائنٌ يتأرجح بين الوحي والسمّ، وهي استعارة للقول الشعري ذاته، القادر على الشفاء والإهلاك معاً.
بين الوتر المشدود وحافة البرهة يتأسس الزمن الشعري كزمنٍ متوتّر، لا يقيس المسافة بين حدثين، بل بين الوعي والهاوية.
٣_ . التحليل الأسلوبي: البنية اللغوية والإيقاعية.
اللغة في القصيدة تتجه نحو التكثيف الرمزي والإيجاز المتوتر. فكل جملة مشحونة بانزياحٍ دلالي يخلق توتّراً أسلوبياً واضحاً.
_ البنية النحوية تتسم بالاقتصاد والدوران حول الفعل: عزفت، صوبت، تسير، تنشد… مما يمنح النص ديناميكية داخلية وحركة دائمة.
_ التكرارات غير المباشرة (الأفعال، الصور، الألوان) تخلق إيقاعًا داخليًا يستبدل الوزن الخارجي بنظامٍ موسيقيّ مستتر.
_ الجمع بين المفردات الزمنية (برهة، مدى، خريفي) والمكانية (حافة، فضاء، الأرض) يشي ببنية شعرية قائمة على الحدّ والعبور والانتظار.
٤_ . البعد الرمزي والدلالات المضمرة:
كل مفردة هنا تعمل كـ”رمز مفتوح” وفق قراءة سيميائية–رمزية:
١_ المفردة الحقل الرمزي الدلالة التأويلية:
الأفعى المكر/المعرفة/الإغواء العقل الأنثوي المحرَّم الذي يهدد النظام الأبوي
السهم العزم/القدر/الجرح اندفاع الوعي نحو الحقيقة رغم الألم
ألواح مذهبة لسقوط آدم الحكمة المحرمة عودة إلى الخطيئة الأولى بوصفها فعل معرفة
خرائط ذاكرة مبعثرة فقد الهوية تشظي الوعي الجمعي والأنثوي
تراتيل بخار خريفي زوال المقدس طقس التحلل من الأسطورة إلى وعي الهشاشة
يوريديس التي لا تعرف طريقاً للعودة فقد الأمل/اغتراب الخلاص تمرد الأنثى على مصير العودة إلى القيد
بهذا تتضح بنية الصراع بين السقوط والتمرد، بين الخطيئة والمعرفة، بين الذكرى والولادة.
٥_ . البنية النفسية والدينية للنص:
تتبدى في القصيدة ثنائية الشعور بالذنب والتمرّد، وهي ثنائية عميقة الجذور في الوعي الديني والأنثوي على السواء.
المرأة التي “تعرف أكثر مما ينبغي” هي أنثى المعرفة الأولى — معادِل رمزي لحوّاء التي دفعت ثمن وعيها.
لكنها في هذا النص ترفض الخضوع للخلاص الذكوري (أورفيوس)، وتستبدل دور “المخلَّصة” بدور “المخلِّصة”.
فالنص ينقلب على البنية الدينية–الذكورية التقليدية، إذ تجعل الشاعرة من يوريديس كيانًا وعيًا لا يطلب العودة من الجحيم، بل يعي جحيمه ويواجهه.
_ من الناحية النفسية، يمكن قراءة النص بوصفه تجسيدًا لرحلة اللاوعي الأنثوي نحو الاعتراف بالذات، رحلة تتأرجح بين الرغبة في الانعتاق والخوف من الفقد. فكل صورة هنا هي انعكاس لتوترٍ داخلي بين الانتماء والتمرّد، بين الحنين والقطيعة.
٦_ . القراءة الجمالية والوطنية:
على المستوى الجمالي، القصيدة تُنحت من الضوء والظلّ، من الحضور والغياب. فـ”العزف” و”التسابيح” و”التراتيل” ليست سوى رموز جمالية لصوت الذات الباحثة عن خلاصها الجمالي في عالمٍ تتنازع فيه القيم.
أما البعد الوطني فيمكن تلمّسه في الإحالة إلى الذاكرة الممزقة وخرائط الضياع، حيث تتحول يوريديس إلى استعارة عن الوطن نفسه — أنثى تعرف الطريق، لكنها لا تجد من ينصت لتسابيحها. إن “الانعكاس الرمادي لجحيم السادة” هو تلميحٌ شجاع إلى واقعٍ سياسيٍّ قاهر، يجعل من الخلاص الفردي والوطني معًا فعلاً من أفعال الجنون المقدّس.
٧_ . القراءة السيميائية: النص بوصفه نظام علامات.
النص يعمل كنظام من العلامات المتفاعلة:
١_ اللون الأزرق ← دالّ على البعد الماورائي، يقابله الرمادي في نهاية النص، كدالّ على انطفاء الحلم.
٢_ الحركة الدائرية (تسير على حافة مدى) ← تعكس الدوران الأبدي للإنسان في متاهة المعنى.
٣_ الأنثى–الصوت والذكر–الأسطورة يتقاطعان سيميائيًا في جدلية الخلق والتدمير، النشيد والصمت.
٤_ العلامة الكبرى في النص هي أورفيوس نفسه، الذي يتحول من كيانٍ أسطوريٍّ خارجي إلى رمز داخلي يسكن الذاكرة الجمعية، كصوتٍ مفقود يذكّر الإنسان المعاصر بقدرته المنسية على الغناء رغم الفقد.
٨_ خاتمة تأويلية.
تُعيد منال رضوان في هذه القصيدة كتابة الأسطورة لا لتكرارها، بل لتفكيكها من الداخل، إذ تجعل من “يوريديس” رمزاً للوعي الأنثوي المقاوم، ومن “أورفيوس” ظلّاً لجمالٍ لم يكتمل. النص إذًا ليس تسبيحاً لأورفيوس، بل مرثية للإنسان في زمنٍ أخرس، ودعوةٌ لبعث النشيد من رماد المعرفة والخطيئة.
إنها قصيدة الضوء الذي يطلّ من الشقوق، لا من الشمس — قصيدةٌ تكتبُ جنون المعرفة بلغةٍ مطهّرة بالرمز، وتعلن أن الخلاص الحقيقي ليس في العودة، بل في الوعي بأن لا عودة ممكنة.
نص القصيدة:
في تقليد مهيب لتسابيح أورفيوس
عزفت الأفعى أنغامها الزرقاء،
بوتر مشدود على حافة برهة
صوبت السهم تجاه
امرأة من زمن مفقود،
تعرف أكثر مما ينبغي
تتأبط ألواحا مذهبة لسقوط آدم
يرسم إصبعها،
جغرافيا المختلف عليه
تسير على حافة مدى لا يحده شيء!!
في عيونها يتأرجح الاشتهاء
تنبض بأنات ممزقة بين الأضداد
كل كلمة مبهمة،
كل خطوة ضائعة
كظل لا رفيف له،
هي..
خرائط ذاكرة مبعثرة
تزرع شكوكها في فضاء معلق،
تنشد تراتيل بخار خريفي
تتساقط أسئلتها…
كأوراق ذابلة تستر عري الأرض
تمردها خطيئة على الكامن،
الطريق الموحش نحو المأمول
الانعكاس الرمادي لجحيم السادة
الطنين الأبدي لمثيولوجيا الضياع
كانت…
يوريديس” التي لا تعرف طريقا” للعودة!