البولاقي يكتب عن اللغة العربية والقرآن الحلقة الرابعة
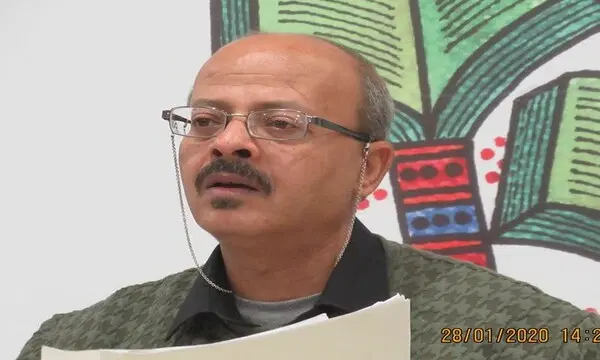
رَووا أن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه وغفر له، كان جالسًا عند الكعبة يفتي الناسَ في شؤونهم، فحدَثَ أن شاهَده نافع بن الأزرق، فقال لرفيقٍ له، “قُم بنا الى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا عِلم له به- يقصد ابنَّ عباس- فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياءَ مِن كتاب اللّه؛ فتفسّرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب؛ فانّ اللّه تعالى إنما أنزل القرآنَ بلسانٍ عربي مبين“. فقال ابن عباس: سَلَاني ما بدا لكما، فكانت السؤالات التي عرفتها الثقافة العربية. وقد وردت القصة بسؤالاتها في “الإتقان” عند السيوطي، لكن يقال إن الأصل المخطوط لها يتضمن سؤالاتٍ لم ترِد عند السيوطي، وقد جَمعها كتابٌ صدر في بغداد في ستينيات القرن الماضي، للدكتور إبراهيم السامرائي، دون أن يعلّق عليها، مكتفيًا بإيرادها مع هوامشَ كثيرةٍ ذات فوائدَ جمّة. ومبدئيًا، الذين يشككون في هذه السؤالات كثيرون، ومنهم محقّقون وثقات وعلماء، والسؤالاتُ التي تتجاوز مائتَين وخمسين سؤالاً كلها تدور حول جملةٍ واحدة تتكرر، تكشف بوضوحٍ وجلاء عن غرض واضحي القصة، ومنتحليها، وهي جملة “وهل عرفت العربُ ذلك؟ أو وهل تعرف العربُ ذلك؟”، يلقيها نافع لابن عباس سائلاً عن الكلمة التي طرحها، فيجيبه ابن عباس بالإيجاب مستشهِدًا ببيت شِعر أو أبيات! والسؤالاتُ كلها عن كلماتٍ وردت في القرآن. ويمكن لنا بسهولةٍ أن نقرأ مستوياتِ الخطاب في القصة؛ لنؤكد على انتحالها ووضعِها، لولا أننا لسْنا مَعنيين بهذا الآن، ويكفي أن نشير إلى أنه فضلاً عن أن القصة كلها ترفع قدْر ابنِ عبّاس الذي كان في أول الرواية يجترئ على كتاب الله، فتُظهِره عالمًا، كما أن نافعًا هذا مِن الخوارج المغضوب عليهم في الفكر العربي الإسلامي التقليدي، إلا أن القصة لا تخلو مما نحن بصدده من ارتباط اللغة بالمقدس، والسؤالُ هنا ماذا لو لم تعرف العرب ذلك الذي كان يسأل عنه نافع بن الأزرق؟! ومن المهم أن نلاحظ أن الزمن المبكر جدًا لظهور القصة، حالَ بالطبع دون أن تتناول السؤالاتُ الانحرافاتِ اللغويةَ والإعرابية التي يحتشِد بها القرآن، فالتقعيد والإعراب ظهرَ متأخرًا جدًا عن زمن ابن عباس الذي توفي 68 هـ تقريبًا. إنَّ واضعي القصة ومنتحليها مسكونون تمامًا بهذا الذي ما تزال العربية تعيشه حتى لحظتنا هذه، وهو التصور الذي لا يحيل فقط إلى أن كل كلمةٍ وردت في القرآن عربية الأصل، لكنه يحيل أيضًا إلى شرف الكلمة بانتمائها إلى المعجم القرآني. وإذا كان هناك شِبه إجماعٍ على أن القصة موضوعةٌ ومنتحَلة، فإنّ السؤال عن الغرض منها تحمل الإجابةُ عنه تلك التصوراتِ التي نشير إليها حول دوران اللغة العربية حول فلَك القرآن، لأن الغرض التعليمي فقط مِن وضْع القصة وانتحالها، كان يمكن أن يتم مِن واضعيها ومنتحليها بأكثر من طريقةٍ أخرى، لكن إشراقة القرآن بلغتِه التي مهما قيل مِن أنها مِن جنس لغة العرب، إلا أنها لغةٌ مختلفة في الذائقة والإحالة والدلالة، بل في (الغرابة) أيضًا، وهو ما دَفع مصطلح “غريب القرآن” للظهور في المصنفات والمؤلفات العربية، قال أبو هلال العسكري في كتابة “الأوائل”، ” قال العسكري وهو يتحدث عن أولية التأليف في غريب القرآن: “أولُ مَن صنّف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى“. ومِن هذه الكتب (المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، غريب القرآن نزهة القلوب، لأبي بكر السجستاني)، ولولا الإطالة لذكَرنا عشرات الكتب والمؤلفات التي تناولت ما سُمّي بغريب القرآن.. الأمر الذي يدل دلالةً واضحة على أن هناك مشكِلاً ما واجه اللغةَ العربية أمام نصٍ جديد، وبدلاً مِن أن تستفيد العربية وتستثمر هذه الغرابة التي وجدتها في القرآن، راحت تبحث عن مرجعيةٍ لغريبِه هذا، فكان لا بدّ من مرجعيةٍ له، وليس مِن مرجعيةٍ هنا إلا كلام العرب نفسه، سواءٌ أكان موجودًا حقيقيًا أم موضوعًا ومنتحلاً! (يتبع)







